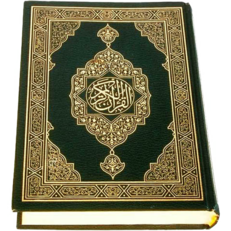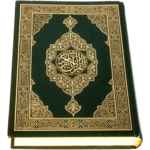عقدة الأجنبي.. لماذا العربي يقدس الغرب وأسلوبهم في الحياة؟
السياسية || محمد محسن الجوهري*
هل ركزت يوماً أن كلمة "مثقف" عندنا تشير إلى الشخص الذي اختلط أكثر بالثقافة الغربية، والذي تزداد ثقافته بقدر ما ينسلخ من ثوابته الدينية ويعتنق ما يناقضها من معتقدات الخصوم وأسلوبهم في الحياة؟
ستلاحظ أن هذه الظاهرة منتشرة بشكل واسع في عالمنا العربي، وهي جزء مما يسميه علماء النفس بــ"الاستلاب الثقافي"، وهو حالة مرضية يشكو صاحبها من الانفصال التدريجي عن هويته الحضارية، ويفقد ثقته بثقافته ولغته وتاريخه، ويبدأ في تبني منظومة قيمية وافدة بوصفها النموذج الأعلى للتقدم والنجاح.
لا يحدث هذا الاستلاب بصورة فجائية أو قسرية في الغالب، بل يتم عبر مسار طويل من التأثير النفسي والفكري والإعلامي، حتى يصبح الفرد أو المجتمع مستلبًا دون أن يشعر، ويغدو الدفاع عن الثقافة الأجنبية جزءًا من وعيه اليومي، في مقابل ازدراء ثقافته الأصلية والنظر إليها بوصفها عبئًا أو عائقًا أمام "التحضر".
وتفشيها في عالمنا العربي ليس صدفة، فهي نتاج قرون من الدراسات والاستشراق والعمل الدؤوب للغرب حتى وصل العربي إلى هذه الحالة من العبودية الثقافية للغرب، وحتى بات الرأي العام في عالمنا يميل في أغلبه لكل ما هو غربي بدعوى التحضر والتقدم وغيرها من العناوين البراقة التي لا تمت للواقع بصلة.
وقد مارس الغرب هذا النوع من الهيمنة الثقافية على العالم العربي منذ بدايات الاحتكاك الاستعماري الحديث، مستفيدًا من تفوقه العسكري والتقني لفرض صورة ذهنية تربط القوة والتقدم بالنموذج الغربي حصرًا. ومع الوقت، لم يعد الاحتلال بحاجة إلى الجيوش وحدها، بل صار يعتمد على أدوات أكثر نعومة وأشد فاعلية، مثل التعليم والإعلام والبعثات الدراسية والمناهج المستوردة.
جرى تقديم الثقافة الغربية بوصفها ثقافة عالمية محايدة، في حين صُوّرت الثقافة العربية والإسلامية على أنها محلية، تقليدية، جامدة، وغير قادرة على مواكبة العصر. وهذا التصوير كان جزءًا من مشروع متكامل لإعادة تشكيل وعي النخب العربية، لأن السيطرة على النخب تعني السيطرة على المجتمع بأكمله.
وفي المدارس والجامعات التي أُنشئت أو أُعيد تشكيلها وفق النموذج الغربي، تعلّم أجيال من العرب تاريخ أوروبا وفلسفاتها بوصفها مركز التاريخ الإنساني، بينما جرى تهميش التاريخ العربي أو تقديمه في صورة صراعات وانقسامات وتخلف علمي. وفي الأدب والفن، رُوّجت الذائقة الغربية باعتبارها المعيار الأعلى للجمال، فصار التقليد هو الطريق الأسرع للنجاح. حتى اللغة العربية نفسها تعرضت لعملية إقصاء ناعمة، حيث رُبطت العامية أو اللغات الأجنبية بالحداثة وسوق العمل، في مقابل تصوير الفصحى كلغة الماضي والخطاب الوعظي.
ساهم الإعلام الغربي، ومعه الإعلام العربي التابع أو المتأثر به، في ترسيخ هذا الاستلاب من خلال تصدير أنماط الحياة الغربية كحلم إنساني شامل. الأفلام والمسلسلات والإعلانات حملت منظومة قيم كاملة عن الفردانية، والعلاقات الاجتماعية، والاستهلاك، والنظرة إلى الأسرة والدين. ومع التكرار، تشكل وعي جمعي يرى في التشبه بالغرب نوعًا من الرقي، وفي الاختلاف عنه علامة على التأخر. وهكذا أصبح الاستعمار الثقافي أكثر رسوخًا من الاستعمار العسكري، لأنه استقر في العقول لا في الأرض فقط.
أثر هذا الاستلاب بعمق على واقع العرب، إذ أدى إلى إضعاف الثقة بالذات الحضارية، وتفكيك الرابط بين الإنسان العربي وتاريخه، ما سهّل تمرير المشاريع الاستعمارية الجديدة بأشكال سياسية واقتصادية. فحين يفقد المجتمع ثقته بنفسه، يصبح أكثر قابلية للوصاية الخارجية، وأكثر استعدادًا لتبرير التدخل الأجنبي بحجة الإصلاح أو التحديث. كما أدى الاستلاب إلى خلق نخبة منقطعة عن بيئتها، تتحدث بلغة مختلفة عن لغة المجتمع، وتفكر بعقلية ترى في شعوبها مادة للتجريب أو التهذيب القسري.
في المحصلة، لم يكن عشق الثقافة الغربية نتاج اختيار حر ومتوازن، بل نتيجة عملية طويلة من الإقناع والضغط الرمزي، استهدفت تفريغ الثقافة العربية من مضمونها وتحويلها إلى فولكلور بلا تأثير. ومواجهة هذا الواقع لا تعني الانغلاق أو رفض التفاعل مع الآخر، وإنما تعني استعادة الوعي النقدي، والتمييز بين التبادل الثقافي المتكافئ وبين الهيمنة التي تُفرض تحت شعارات براقة. فالأمم التي لا تمتلك ثقة بثقافتها لا تستطيع أن تكون شريكًا في العالم، بل تظل هامشًا تابعًا في مشروع غيرها.
وصدق الله عز وجل حين قال (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين) فهذه الآية تختصر واقع الأمة الإسلامية وكيف أن المعركة الثقافية كفيلة بأن تردي المسلمين وتصدهم عن عقيدتهم، ولا أدل عن الارتداد الجماعي مثل غزة التي تخلى عنها الجميه وهم يعلمون أن في خذلان المسلم للمسلم ردة عن دينه.
* المقال يعبر عن رأي الكاتب