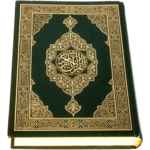لبنان بين قوتين: مقاومة تعطي... وساسة ينزعون الشرعية
السياسية:
محمد مهدي حسن بغدادي*
لم تكن الحرب الأخيرة اختباراً لقدرة لبنان العسكرية فحسب، بل اختباراً لقدرة اللبنانيين على أن يكونوا شعباً واحداً في لحظة وجودية. ما ظهر، بلا تجميل، هو أنّ لبنان يمتلك قوّة حقيقية اكتسبها بدماء مقاومته وتجاربها، لكنه يفتقد إلى إرادة وطنية تستثمر هذه القوة وتمنع تبديدها في انقساماتٍ تُدار بالوكالة. وفيما يخرج العدو من الحرب مدججاً بأزماته الداخلية، يخرج لبنان مثخناً بجراح الانقسام، كأنّ الحرب كانت على وحدته أكثر مما كانت على حدوده.
رغم الاعتراف الدولي والإقليمي بأنّ المقاومة أعادت رسم حدود الردع وفرضت قواعد اشتباك غير مسبوقة على العدو، لا يزال جزء من الطبقة السياسية اللبنانية يتعامل مع هذه القوة كأنّها عبء. يهاجمونها في الخطاب، ويستثمرون رصيدها حين تتعاظم التهديدات، ثم يعودون إلى خطاب "نزع السلاح" كأنّ البلاد تعيش على كوكب آخر.
الحقيقة أبسط من كلّ هذا السجال: لا دولة لبنانية قادرة على حماية نفسها من دون عنصر ردع فعلي. والدليل أنّ الحكومات المتعاقبة ـــــ منذ اتفاق الطائف ـــــ أدرجت المقاومة في بياناتها الوزارية، لا من باب المجاملة، بل من باب الواقعية السياسية.
صحيح أنّ لبنان بلدٌ صُمّم على التعدّد، وعلى تضارب المصالح والأهواء الإقليمية، ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف حول القضايا الكبرى ومنها قضية المقاومة. لكنّ تحويل الاختلاف إلى عجزٍ دائم هو خيار سياسي داخلي، وليس قدَراً محتوماً.
المفارقة أنّ الأطراف نفسها التي تعلن عجزها عن التفاهم حول ملف المقاومة، استطاعت ـــــ عند محطات وطنية مفصلية مثل استقبال البابا ـــــ أن تُنتج مشهداً وطنياً وحدوياً نظيفاً يظهر فيه الجميع في صفّ واحد، مشهداً أثبت أنّ الممكن أكبر بكثير من المعلَن.
فلماذا يصبح التفاهم ممكناً في الإطار البروتوكولي، ومستحيلاً في الإطار الوجودي؟
الجواب واضح: الإرادة السياسية مسلّمة للضغوط الخارجية، وليس للعقل الوطني.
اليوم، لم يعد الخطر الأكبر هو الخلاف حول المقاومة، بل غياب الاجتماع الوطني في لحظة هي الأخطر منذ 2006. لبنان يواجه حكومة يمينية في "إسرائيل" تعيش هوس القوة الاستئصالية، وتُدار من غريزة التدمير، وإدارة أميركية منحازة بالكامل إلى الرواية الإسرائيلية، وتوازنات إقليمية متحرّكة.
ومع ذلك، يحوّل بعض اللبنانيين أولوياتهم إلى مناكفات داخلية و"رسائل حسن سلوك" للخارج، بدل بناء جبهة داخلية قادرة على حماية ما تبقّى من الدولة.
في ظلّ هذه الموازين المختلّة، يصبح الحديث عن "المكاسب الكبرى" نوعاً من الوهم. المطلوب، في الحد الأدنى، وقف الخسائر الوطنية والإنسانية، وتثبيت قدرة لبنان على الصمود السياسي والأمني.
التجارب القريبة والبعيدة تثبت أنّ القوى والشعوب التي تخلّت عن أدوات قوتها تحت الضغط الخارجي دفعت أثماناً فادحة. من المقاومة الفلسطينية التي شُلّت بعد التزامات أوسلو، إلى تجارب المعارضات التي نزعت سلاحها قبل أن تُبنى الدولة، إلى نماذج عالمية سقطت حين ظنّت أنّ "الضمانات الدولية" بديل عن أدوات القوة الذاتية.
وهنا، السؤال البديهي:
ما الذي يضمن للبنان أمنه واستقلاله إذا نُزع سلاحه بينما الاحتلال لا يزال على حدوده والعدوان في سمائه؟
الجواب يعرفه الجميع، حتى الذين ينكرونه في العلن.
ثم إنه لا يمكن فصل مطلب "نزع السلاح" عن المشروع الأكبر: ضرب بيئة المقاومة وتجفيف قدراتها.
فبرأيكم: من يمنع الإعمار؟ ومن يضغط لوقف التبرّعات والمساعدات؟ ومن يضع لبنان تحت عقوبات مباشرة وغير مباشرة؟ الولايات المتحدة وحلفاؤها. لماذا؟
لأنّ الإعمار يُعيد الناس إلى بيوتهم، ويُرمّم اقتصاد الصمود، ويقوّي البنية الاجتماعية التي تحضن المقاومة. بيئة مستقرّة تعني مقاومة أقوى؛ وبيئة منهكة تعني مجتمعاً قابلاً للانفجار من الداخل.
هذه ليست أسراراً. إنها سياسة أميركية معلنة: اضرب البيئة… تضعف المقاومة.
في لحظة كهذه، الأولويات الوطنية ليست غامضة، حيث يمكن إجمالها بالآتي:
1. تثبيت وقف النار
2. الضغط لتحرير الأسرى
3. وقف الخروقات الجوية والبحرية والبرية
4. انسحاب العدو من كلّ الأراضي اللبنانية المحتلة
هذه هي المهام الوطنية. أما الحديث عن "السلاح"، فيشبه الحديث عن سقف البيت أثناء احتراق أساساته.
خلاصة الكلام
لبنان اليوم يقف بين قوتين: قوة يمتلكها فعلاً، وقوة يريد البعض التخلّي عنها مجاناً. بينهما، هناك دولة عاجزة عن اتخاذ قرار، وطبقة سياسية تتصرّف كأنّها "أكثر ملكيّة من الملك" أمام الأجندات الخارجية.
في هذا المفصل، يصبح السؤال الحقيقي:
هل يريد اللبنانيون أن يعيشوا في وطن يُدار بإرادة داخلية، أم وطن يُدار بالوكالة؟
القوة موجودة. ما ينقص هو الإرادة الوطنية لصوغها في معادلة تحمي لبنان بدل تفكيكه، المطلوب مقاربة تُحسن التفاوض على أساس ما نملك، لا على أساس ما يريده الآخرون لنا.
فلبنان لا يُحمى بخطابات الحياد ولا بمزايدات التخويف من المقاومة ولا بإنكار قوّته، بل بإدارتها. ولا يُبنى بالاصطفافات المفتعلة، بل بالحدّ الأدنى من التفاهمات الضرورية في لحظة إقليمية هائجة، وفي زمن تتغيّر فيه الخرائط بسرعة.
والمقبل ـــــ إقليمياً ودولياً ـــــ أخطر من أن يُترك الوطن معلّقاً بين قوّة يملكها… وانقسام ينهشه.
المادة نقلت حرفيا من الميادين نت