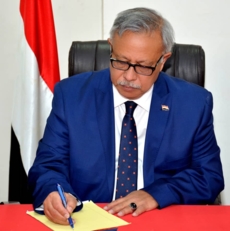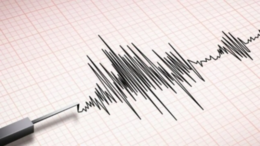في أصول العبرية وسياق نشأتها الحديثة
السياسية || محمد محسن الجوهري*
نجح اليهود، عبر جهدٍ منهجي طويل، في تسويق جملة من الأفكار والمعتقدات التي لا تستند إلى منطق علمي رصين، حتى باتت مقبولة لدى قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي، ولا سيما في الفضاء العربي. ولم يكن هذا المسعى وليد المصادفة أو ضربًا من العبث؛ بل جاء في سياق مشروع متكامل هدفه إرساء الأسس الفكرية والثقافية التي قام عليها الكيان الصهيوني القائم اليوم على أرض فلسطين.
وقد اعتمد هذا المشروع، في جانبٍ كبير منه، على جهود المستشرقين الذين وفدوا إلى العالم العربي وأقام عدد منهم بين مجتمعاته سنواتٍ طويلة، عملوا خلالها على الترويج لروايات ومفاهيم مشوشة، استندت في جوهرها إلى موروث توراتي محرّف، قُدِّم في ثوبٍ أكاديمي يوحي بالعلمية والحياد.
ومن أبرز تلك الروايات، أسطورة ما يُسمّى بـ«اللسان العبري»، إذ إن التسمية ذاتها ليست سوى تحوير لكلمة «عربي»، التي تمثل الأصل اللغوي لما يُعرف اليوم بالعبرية. ويستطيع أي مختص في علم اللغات، متى تحلّى بالحد الأدنى من الموضوعية، أن يلحظ هشاشة هذا الادعاء؛ فالعبرية المتداولة حاليًا في فلسطين المحتلة لا ترقى، من حيث البنية والخصائص، إلى مستوى اللغة المستقلة، وذلك لاعتباراتٍ علمية عدة.
فمن جهة، لا يتجاوز عدد جذور العبرية نحو 2500 جذر لغوي، أي ما يقارب عُشر عدد الجذور في اللغة العربية، وهو ما يكشف فقرها المعجمي رغم الادعاءات المتكررة بقدمها التاريخي. ومن جهة أخرى، فإن غالبية مفرداتها ليست سوى ألفاظ عربية جرى تحوير نطقها، مع فارق جوهري يتمثل في أن العربية لغة اشتقاقية حيّة، غنية بالتصريف والدلالات، بينما تبدو العبرية جامدة، محدودة الحركة، وكأنها نُقلت في مرحلة متأخرة عن أصلها العربي.
ويُضاف إلى ذلك أن أقدم نص عبري مكتوب لا يعود إلى ما قبل القرن التاسع الميلادي، وهي فترة متأخرة نسبيًا في مقياس تطور اللغات وتدوينها. أما مصطلح «سامي»، الذي يُستعمل اليوم لوصف مجموعة من اللغات والشعوب، فلم يظهر إلا في أواخر القرن الثامن عشر، وتحديدًا عام 1780م، على يد باحثي مدرسة غوتنغن للتاريخ، التي أسسها مجموعة من اليهود الألمان، وأسهمت في صياغة عدد كبير من المفاهيم التاريخية والاجتماعية المتداولة في العصر الحديث.
وقد سعى مؤرخو هذه المدرسة إلى بناء سردية تاريخية بديلة للعالم، من خلال إعادة قراءة التاريخ اعتمادًا على النصوص التوراتية المحرّفة، وتقديمه من منظور أحادي يخدم الرؤية اليهودية. وقبل شيوع مصطلح «السامية» بهذا المعنى، كانت الكلمة تُستخدم في بعض النصوص القديمة للإشارة إلى بلاد الشام، قبل أن يُعاد توظيفها وتحميلها دلالات جديدة تخدم أغراضًا أيديولوجية.
ولم تتطلب عملية اختلاق «اللغة العبرية» جهدًا استثنائيًا؛ إذ اقتصر الأمر، في جوهره، على تحوير نطق بعض الكلمات العربية، واستعمالها في البداية كلغة مشفّرة بين اليهود داخل المجتمعات العربية، قبل أن يجري تعميمها لاحقًا كلغة معلنة.
وعلى هذا النحو، شُيّدت الكثير من المرتكزات الثقافية والفكرية التي يستند إليها الكيان الصهيوني، وهي مرتكزات سرعان ما تتهاوى متى ما عُرضت على المختصين في حقول اللغة والتاريخ والثقافة. ولعل ما نشهده اليوم من نسب الأكلات الشامية المعروفة، كالحمص والتبولة، إلى «المطبخ الإسرائيلي»، ليس سوى مثال صارخ على هذا المسار من السطو الثقافي، فإذا كان هذا حال الموروث الغذائي، فكيف بما هو أعمق وأخطر؟
* المقال يعبر عن رأي الكاتب