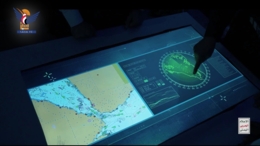الخيارات المحتملة لبكين.. في مواجهة التصعيد الأميركي
يأتي إعلان زيارة بيلوسي إلى تايوان في وقت حاسم، فالولايات المتحدة، وجدت نفسها في حرج كبير. لأن التراجع عنها، سوف يعطي انطباعاً بهزيمتها أمام الموقف الصيني الحاسم والرافض لهذه الزيارة.
شاهر الشاهر
السياسية- متابعات:
على الرَّغم من المآسي الكبيرة التي خلّفتها الحرب في أوكرانيا على البشرية كلها، فإن الولايات المتحدة مستمرة في صبّ النار على الزيت في قضية تايوان، التي أدّت إلى مزيد من التصعيد في العلاقات الصينية الأميركية بعد إعلان الزيارة المرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، التي تعدّها بكين جزءاً من الأرض الصينية. وبالتالي، لا يمكن لأيّ زائر دولي القدوم إليها إلّا من البوابة الصينية الرسمية.
في العودة إلى زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، التي تُعَدّ الشخص الثالث في الإدارة الأميركية، فإنها كانت أعلنت أنها ستزور تايوان في 10 نيسان/أبريل الماضي لإحياء الذكرى الثالثة والأربعين لإقرار ما يسمى “قانون العلاقات بتايوان”، وتم تأجيل الزيارة حين أُعلنت إصابة بيلوسي بكوفيد 19، بينما أرجع البعض سبب التأجيل إلى تجنّب الاصطدام ببكين التي عارضت هذه الزيارة، بقوة.
وهي ليست أول زيارة يقوم بها رئيس لمجلس النواب الأميركي لتايوان. ففي عام 1997، زار رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري نيوت غينغريتش، تايوان، لكن الأخطر والأهم في هذه الزيارة، هو أن بيلوسي تنتمي إلى حزب الرئيس نفسه (الحزب الديمقراطي).
ويأتي إعلان هذه الزيارة في وقت حاسم وشديد الخطورة بالنسبة إلى البلدين، فالولايات المتحدة، بعد إعلان هذه الزيارة، وجدت نفسها في حرج كبير. فالتراجع عنها، للمرة الثانية، سوف يعطي انطباعاً بهزيمتها أمام الموقف الصيني الحاسم والرافض لهذه الزيارة، والمُصِرّ على مواجهتها بكل الوسائل، بما فيها العسكرية، لو اقتضى الأمر ذلك.
وأيضاً، سوف يبعث برسائل سلبية إلى كل من حكومة تايوان وحلفاء الولايات المتحدة، الذين بدأوا يشعرون بأنها حليف لا يمكن الوثوق به حتى النهاية.
كما أن التوقيت حاسم بالنسبة إلى بكين، التي تستعدّ لعقد مؤتمر عام للحزب الشيوعي الصيني، سيكرّس زعامة الرئيس شي جين بينغ، كإمبراطور يسعى لجعل الصين إمبراطورية العالم العظيمة.
وبالتالي، فإن الرئيس شي يجب أن يُظهر القوة والحزم في التعاطي مع ملف تايوان قبيل انعقاد مؤتمر الحزب، نظراً إلى أهمية هذه القضية بالنسبة إلى الشعب الصيني بصورة عامة، وإلى قيادة الحزب الشيوعي الصيني وأعضائه، على وجه الخصوص. فبكين تعدّ تايوان مقاطعةً صينية، وكل حديث عن استقلال الجزيرة سيؤدي إلى طريق مسدود.
من هنا، فإن اتصال الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالرئيس الصيني قبل موعد الزيارة، وكذلك قوله إن الجيش الأميركي يعتقد أن هذه الزيارة خاطئة، جاء ربما في منزلة البحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه للطرفين. فالصين، هذه المرة، رفعت سقف التحدي كثيراً، وهي ترى أن الولايات المتحدة غير قادرة على التعامل مع أزمتين أشعلتهما عمداً مع روسيا والصين، في وقت واحد.
كما ترى أن الولايات المتحدة ركَزت في أوروبا على استخدام القوة ضد روسيا، من أجل إظهار أن “القوة الأميركية الصلبة” ما زالت حاضرة وفعّالة. أمّا في آسيا، فلن يكون في مقدورها مواجهة الصين إلّا عبر “أدوات دبلوماسية”، من أجل إظهار “قوتها الناعمة”.
وتحاول واشنطن، عبر ذلك، تحقيق النصر في كِلا الاتجاهين، لكن من غير الممكن تحقّق ذلك. فالنخبة السياسية في الولايات المتحدة متعجرفة، ومفكَّكة، ولا يوجد بينها أي تنسيق. وبالتالي، لا تعوّل كثيراً على الالتزامات التي يتعهّدها الرئيس بايدن، ولا تنفَّذ من جانب إدارته.
النفاق الأميركي في قضية تايوان
على الرَّغم مما تُبديه إدارة بايدن من دعم لحكومة تايوان، على حدّ قولها، فإن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة سياسةَ “صين واحدة”. لكن، على الرغم من التزامها سياسة “صين واحدة”، كلامياً على الأقل، فإن الإجراءات المتخَذة من جانبها تتعارض مع ما هو معلَن، وهو ما يُظهر حجم الكذب والنفاق في هذه السياسة. فعلى سبيل المثال، في شهر آذار/مارس الماضي، وبعد اللقاء الافتراضي الذي عُقد بين الرئيسين بايدن وشي، تعهّدت إدارة بايدن التزامها سياسةَ “صين واحدة”، لكنها، في الوقت نفسه، قامت بمجموعة من الإجراءات، منها:
نظّمت ثلاث زيارات لتايوان في الشهر نفسه، الذي عُقد فيه الاجتماع، قامت بها وفود ترأّسها كل من الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، مايكل مولين، ووزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، ورئيس الصندوق الوطني للديمقراطية، ديمون ويلسون. كما تمّ تنظيم زيارات لأعضاء من الكونغرس الأميركي لتايوان، بصورة متكررة، والاستمرار في عقد صفقات السلاح مع الجزيرة.
وكان البنتاغون وافق على بيع تكنولوجيا عسكرية وأسلحة بقيمة 95 مليون دولار لتايوان، في الخامس من نيسان/أبريل الماضي، وهي ثالث صفقة أسلحة قامت بها إدارة جو بايدن مع تايبه.
إن هذه الإجراءات تضرّ بسيادة الصين ووحدة أراضيها. فبكين ترى أن أي دولة تريد إرسال مسؤولين لزيارة تايوان، يجب أن تحصل على موافقة من الحكومة الصينية أولاً.
ومن هنا، فالزيارة المرتقبة تنتهك، بصورة خطيرة، مبدأ “الصين الواحدة” وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة. كما أنها ستُلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة، وستؤدي إلى تفاقم الوضع في مضيق تايوان.
الصين تستعدّ لكلّ الاحتمالات
تدرك بكين حجم أوراق القوة التي في يدها، لكنها، في الوقت ذاته، تسعى للمحافظة على عامل الزمن، كمكسب صلب تسعى لتحقيقه. فالوقت سيعزّز ثمن مكاسبها، ويقلّل حجم خسائرها. ومن هذه الزاوية، تسعى للتروّي قدر المستطاع في قضية تايوان، وخصوصاً أنها مطمئنة إلى عدم إمكان انفصال تلك الجزيرة عن الوطن الأم، انطلاقاً من إدراكها العميق لفهم السياسة على أنها فن الممكن. والممكن، من وجهة نظرها، هو الشيء القابل للتطبيق في أرض الواقع. واستقلال تايوان نوع من الممكن الدولي غير القابل للتطبيق. وتلك معادلة مهمة يجب استيعابها والعمل وفقاً لها. ومن الأمثلة البسيطة على هذا الممكن، قيامُ الكيان الصهيوني، الذي تحقَّق نتيجة ظروف دولية قائمة وداعمة، بينما كان نوعاً من الوهم توقعُ قيام دولة “داعش”، أو دولة كردية في شمالي سوريا، في ظل بيئة إقليمية رافضة، بشدة، وبيئة دولية غير داعمة وغير متحمسة، ربما.
ويبقى السؤال الأهم، والذي يراود كثيراً من المهتمين، هو: كيف ستردّ بكين في حال أقدمت نانسي بيلوسي على الزيارة؟
هناك عدد كبير من نقاط القوة وأوراق الضغط لدى بكين، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر:
– تخفيض سعر اليوان أمام الدولار، الأمر الذي يضرّ بصورة كبيرة بالصادرات الأميركية، وهو ما كانت تشكوه الولايات المتحدة في الأعوام السابقة.
– السعي لتعزيز التبادل التجاري الدولي باليوان الصيني، بصورة أكبر، وإعطاء ميزة تفضيلية لمن يتعامل به، وبالتالي تقليل الطلب على الدولار الأميركي.
– مزيد من التعاون مع موسكو وطهران، والقيام بمناورات عسكرية مشتركة.
– تقديم مزيد من الدعم إلى الموالين لها في تايوان، ودعم وصولهم إلى السلطة.
– إغلاق منطقة مضيق تايوان. وهذا أمر ممكن عبر الوسائل السلمية، ومن دون اللجوء إلى القوة، من خلال السماح لعدة ملايين من الصيادين بالنزول في مراكبهم للصيد في تلك المنطقة. فهل تستطيع الولايات المتحدة الأميركية، كدولة تدّعي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، مواجهة هؤلاء الصيادين بالقوة العسكرية؟
– القيام بمناورات عسكرية واسعة في المنطقة، وإقامة منطقة حظر للطيران. لذا، قامت الولايات المتحدة بإرسال حاملة طائراتها إلى المنطقة.
– زيادة عمليات الاعتراض للسفن غير الآمنة والطائرات المتوقَّع أنها تحمل أسلحة إلى تايوان وتفتيشها.
– ضمّ بعض الجزر الصغيرة والبعيدة عن الجزيرة الرئيسة لتايوان، ومحاصرة الجزيرة.
– استخدام تقنية الحروب السيبرانية والذكاء الاصطناعي لتعطيل البنية التحتية ووسائل الاتصال في المنطقة التي يوجد فيها العدو.
– استخدام القوة وتوجيه ضربات مركَّزة، ولو عن طريق الخطأ، لبعض الأهداف.
– ويبقى الخيار العسكري وارداً، كما صرح بذلك كبار القادة العسكريين هذه المرة.
لماذا التصعيد الأميركي مع الصين الآن؟
المتابع لمجريات الأحداث سيعرف أن سبب التصعيد الأميركي الأخير تجاه بكين نابع من الصراع والمنافسة المعلنَين بين البلدين بشأن السعي لامتلاك الرقائق الإلكترونية؛ هذه الرقائق التي تشكل عصب الحياة اليوم، كونها تدخل في صناعة كل شيء نستخدمه. وبالتالي، من يسيطر على صناعة الرقائق فسيسيطر على مستقبل الصناعة، إلى حد كبير.
ومن المعلوم أن شركة TSMC تسيطر على نحو 54% من حجم إنتاج الرقائق الإلكترونية في العالم، وهي شركة مقرها الرئيس في تايوان. من هنا، ورغبة منها في سرقة هذه الصناعة ونقلها إلى الولايات المتحدة، جرى الحديث في الآونة الأخيرة عن استعدادات صينية لغزو الجزيرة، لتخويف حكومة تايوان من القيام بنقل تلك الصناعة إلى ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية، بحجة أن بقاء هذه الشركة في تايوان سيُغري الصين أكثر في السيطرة على الجزيرة للاستيلاء على هذه التقنية التي تحتاج إليها بكين، بقوة. وهذا ما بدأ فعلاً.
وكانت مجلة الكلية الحربية الأميركية نشرت مقالاً تحدثت فيه عما سمَّته “استراتيجية العش المكسور”، تقترح فيه أن تقوم الولايات المتحدة وتايوان بتدمير المنشآت التابعة لشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC)، بذريعة منع الصين من الوصول إليها والسيطرة عليها، وهو ما سيتسبب بشلل صناعة التكنولوجيا الفائقة في الصين.
وكانت الولايات المتحدة، منذ تولّي ترامب الرئاسة، قامت بمحاولة عرقلة صناعة أشباه الموصلات في الصين. وفي عام 2020، دعا الكونغرس الأميركي إلى إصدار القوانين ذات الصلة من أجل تحفيز تطوير صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. واشتد هذا القمع منذ تولي الحكومة الأميركية الحالية مقاليد الأمور.
واليوم، نجد الكونغرس الأميركي مهتماً برصد 50 مليار دولار لتطوير هذه الصناعة، التي عدّ أنها تدعم الأمن القومي للولايات المتحدة، وتعزّز مكانتها وقوتها في التعاطي مع بكين، التي تنبَّهت لذلك قبل عام، فقامت برصد مبلغ 150 مليار دولار لتطوير تلك الصناعة، بحيث أصبحت التقارير تشير إلى وجود 19 شركة صينية ضمن أكبر 20 شركة في العالم لصناعة الرقائق الإلكترونية.
فبكين تمضي في تقدمها وتعزيز قوتها ومناعتها الاستراتيجية، بخطوات ثابتة، وساعات تقيس بها الفجوة التي تفصل بينها وبين من سبقها في بعض المجالات، وتسعى للتوصل إليه وتجاوزه، ولا تريد لأي عارض أن يعرقل نهضتها. لذا، فهي تبدي نوعاً من المرونة في سياستها، مع الإصرار، عند الحاجة، على أن تلك المرونة لا تعني ليونة على الإطلاق.
المصدر: الميادين نت
المادة الصحفية تم نقلها من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع