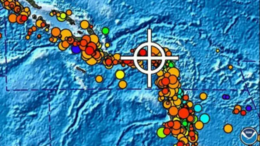ماذا حلَّ بعربان مجلس التعاون الخليجي “المُطبّعين”؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
شاهد الرأي العام العربي والإسلامي عبر وسائل الإعلام المختلفة نماذج “هابطة” من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تشارك، وبفرحٍ عارم وسرور طافح، مع “مواطني دولة” العدو الصهيوني أفراحهم واحتفالاتهم، وزيارتهم إلى المسجد الأقصى الشريف في ساحة البراق الذي يسميه الصهاينة “حائط المبكى”، كما يتنزهون بمعية الصهاينة على شواطئ يافا وعكا وتل أبيب.
وبلغت وقاحتهم بأن يزوروا مرتفعات الجولان العربية السورية التي “منحها” دونالد ترامب لكيان العدو الصهيوني “كهبة”، ليرسلوا من هناك رسائل صوتية هي أقرب إلى نشر الرذيلة والانحطاط الأخلاقي الذي يروّجون لها دونما احترام ومراعاة لأبسط مشاعر الملايين من العرب الأحرار الغاضبين من ذلك المشهد غير المألوف، الذي بلغ حد الإسفاف في أدنى مستوياته.
لو حاولنا أن نبرّر للحكام “العرب” خطوتهم “التطبيعية”، وقلنا إنهم فعلوا ذلك تحت الضغط الهائل الذي يتعرضون له من قبل الإدارة الأميركية المتصهينة، وإنهم غير قادرين على صد هذا الاكتساح الشامل من قبل جماعات الضغط في الولايات المتحدة الأميركية، وإنهم ربما “غير ملومين” بسبب تواجد البارجات والقواعد والمعسكرات الأميركية في كل من البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة السعودية، ولو افترضنا جدلاً بأن هؤلاء الملوك الخليجيين، ومعهم ملك المغرب مع بقية الأمراء والشيوخ، ليس بيدهم أية حيلة، ولا يمتلكون أي قرار سوى التسليم والقبول بشروط جاريد كوشنير، المستشار الصهيوني للرئيس الأميركي المنتهية ولايته، وأنهم قومٌ مغلوبٌ على أمرهم، فإن الرأي العام العربي وحتى الإسلامي يمكن أن يتغاضى على ما اقترفوه من معصية “التطبيع” التي تصل إلى حد الخيانة.
لكن كيف يمكن لنا أن نفسر تلك الهرولة “الشعبية” من قِبَل أفراد وجماعات ورجال مال وأعمال وصحافيين مغمورين ينتمون إلى تلك البلدان، وهم يطالبون بـ”التطبيع” الشعبي حد الاندماج والتسلل إلى داخل الأسر والعائلات العربية للأسف؟ من أي صنفٍ من البشر هؤلاء؟! وما هي مرجعيَّتهم التربوية والدينية والأخلاقية والإنسانية؟! وهنا يبرز تساؤل مشروع: هل فقد بعض سكان هذه البلدان (الغنية مالياً) صلتهم وروابطهم بعروبتهم ودينهم؟!
يقودنا ذلك إلى تفسير عام بأن هؤلاء المنتمين إلى المجتمع الاستهلاكي الباذخ في ممالك ومشيخات الخليج غُيِّب وعيهم الجمعي، وأُفْسِدت ثقافتهم وروابطهم الروحية بانتمائهم إلى أمتهم العربية والإسلامية، وأن التربية الأسرية غير السليمة أثّرت سلباً فيهم، وأصبحوا لا يفرقون بين الصهيوني المُحتل وصاحب الأرض المُضطَهد مُنذ سبعين عاماً. ربما ما ذهبنا إليه هو الأقرب إلى التحليل النفسي لتفسير سلوكهم المشين المُخزي تجاه التزاماتهم الدينية والأخلاقية والقومية.
هناك قدر متاح ومسموح به من الانفتاح على الغير، ولا ضير بأن يكون بأسلوب إنساني قابل للفهم، وهذا التعامل مع الغير يجب أن لا يُنسينا قضايانا المصيرية العروبية – الإسلامية.
أما ما شاهده الرأي العام العربي في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي، فقد كان ظاهرة لافتة هي الأولى من نوعها، بأن يُقدم هؤلاء “العرب المسلمون”، إن كانوا ما زالوا كذلك، على كل هذا الفجور والانبطاح والخنوع والمهانة، بحجة التطبيع مع اليهود الصهاينة، ومشاركتهم كل تلك المهزلة في احتفالاتهم المُدنّسة لأرض فلسطين الشريفة، فذلك أمرٌ خطير، وينبغي أن نسأل: ما هي جذور تلك النفسيات؟ وما هي التربية الوطنية والدينية التي تمَّ تربيتهم عليها في بيوت أسرهم، وفي أروقة المدارس، وحتى الجامعات، لأنه سلوك شاذ غير سوي وغير مقبول؟
لقد شاهدنا جميعاً حجم التضحيات الكبيرة التي قدّمها الإنسان الفلسطيني في مقاومته للتهجير والتهويد والتجويع والحصار. وبالعودة إلى تاريخ العمل الوطني السياسي والفدائي الذي قدّمه أهلنا في فلسطين، فهو لا يشابهه في تلك القضية سِوى تلك التضحيات التي قدمتها الشعوب العربية التي قاومت الاستعمار البريطاني والفرنسي، والتي قدمت في ذلك الزمان، وبسخاءٍ نبيل، قوافل من الشهداء والجرحى والمفقودين. وليس أكثر دلالة على ذلك من ثورة المليون ونصف مليون شهيد من أهلنا في الجزائر العظيمة، وكذلك ما قدمته الشعوب العربية الأخرى في سبيل التحرر والانعتاق، هل كانت كل تلك التضحيات الجسيمة في مفاهيم العرب المتصهينين عبثية وخاطئة ولم تكن لها قيمةٌ تُذكر؟!
لو كان الأمر كذلك، لما درسنا في أضابير التاريخ ونقوشه قصة الثائر (العبد) سبارتاكوس وثورة العبيد التي لم تقبل بالعبودية مطلقاً. وفي ذلك السياق، لما علَّمنا أبناءنا وأحفادنا مفاهيم ومصطلحات، مثل قيم ومبادئ الحرية والكرامة والأخلاق والعيب، والأحرى بنا أن نشطبها من القاموس اللغوي لكل شعوب الأرض.
أودّ التذكير هنا بأنّ الإنسان الفلسطيني الذي أُرغم على الهجرة من قريته وموطنه الأول عندما كان طفلاً، يعود إلى بلدته وقريته وموقع منزله القديم الذي غادره وهو طفل في السادسة من عمره، ليتلمس بقايا معالم حديقة منزله، حاملاً معه كيساً صغيراً، ليأخذ منها بكفيه العاريتين كومة من تراب الأرض، ويضعها في ذلك الكيس، بعد أن يستنشق رائحة عطر الأرض المشبعة بكبريائه وكرامته وتاريخه وذكرياته المؤلمة، ليعود بتلك الكومة من التراب إلى مكان وموطن استقراره في بلد الاغتراب.
هذه الظاهرة تتكرر مع كل فلسطيني أُرْغِم ذات يوم على الرحيل والنزوح من أرضه قسراً، ليهيم في الشتات القاسي من دون أن يدري أين تتجه به بوصلة الحياة. هذه السردية الفلسطينية ترافقه في حله وترحاله، ليروي الحكاية مراتٍ ومرات لأبنائه وأحفاده من الأجيال اللاحقة. يمارس الإنسان الفلسطيني الحر (رجلٌ أو امرأة، كهلٌ أو شاب) هذه الطقوس شبه اليومية الروحانية المرتبطة بقصة ارتباطه بالأرض المقدسة، ويقطع آلاف الكيلومترات من حيث سُكناه ومحل عمله بشكل تلقائي، ولا يتلقى توجيهاتٍ من أحد.
إنّها يا سادة الفكرة الحُرَّة التي تربى عليها ورضعها من حليب أمه الشريفة الطاهرة، التي زرعت في روحه حب أرض فلسطين الطاهرة، والتي اغتصبها، ولا زال، صهاينة إرهابيون تمَّ جمعهم من غيتوهات الكرة الأرضية، بدعم من الغرب الرأسمالي المتصهين، وتم زرعهم في أرض فلسطين، وهي قلب الأمة العربية – الإسلامية، فكيف يفكّر هؤلاء “العرب” المُطبّعون تجاه القضية المركزية للأمة؟
لهذا، نكرر بأن “التطبيع” مع العدو الإسرائيلي لا قيمة ولا مستقبل حقيقياً له، لأن شعب فلسطين وخلفه الأحرار من العالم أجمع، لن يفرّطوا في قضيةٍ عادلة، ما داموا رووا تربتها الطاهرة بدمائهم الزكية، وخضبوها بعرق جبين فلاحيهم وعمالهم وفدائييهم، وزرعوا فيها أشجار التين والزيتون كي تكون أوتاداً راسخة كالجبال الرواسي.
هذا الشعب يعتز بعظمةٍ تاريخية، ويفتخر بكرامته وكبريائه، ولو “طبَّع” العالم أجمع، وليس فقط حفنة طارئة من شيوخ الخليج لا تملك من قيمتها الإنسانية والدينية سوى أرصدة وأكوام من المال والنقود التي لا تسمن ولا تغني من جوع سوى للعبيد والمرتزقة والمأجورين حول العالم.
على الأَعْرَاب في مجلس التعاون الخليجي، حكاماً كانوا أو محكومين، باستثناء الأحرار منهم، وهم كُثر، فهم معادلة فلسطين كأرض وإنسان، وعليهم الاجتهاد في استيعاب المشهد بشكلٍ صحيح، لنتأمل ونقرأ مشهد امرأة مُسنّة وهي تحتضن شجرة الزيتون لمنع الصهاينة من اقتلاعها.
علينا فهم مشهد أطفال الحجارة وهم يقاومون ناقلة الجند وجحافل الغُزاة من جنود بني صهيون. علينا فهم مشهد شابة فلسطينية في ريعان شبابها وهي تسعف جريحاً فلسطينياً، لتصاب هي الأخرى برصاصة قاتلة من جندي إسرائيلي مستهتر.
لنتذكّر المناضلة ليلى خالد ورفاقها وهم يجبرون طائرات العدو على الاستسلام، ولنتفكر كثيراً في الطابور الطويل لشهداء فلسطين الذين تحولوا إلى مصابيح وقناديل ورموز مضيئة تشعل الطريق للأجيال المتلاحقة من شباب الأمتين العربية والإسلامية، لتواصل طريق المقاومة والتحرر، ولنتذكر قوافل الشهداء، ومنهم الشهيد الشيخ عز الدين القسام، والفدائي ياسر عرفات، والشيخ أحمد ياسين، والرفيق أبو علي مصطفى، وأبو جهاد، وخليل الوزير، ووديع حداد، وفتحي الشقاقي، وفاطمة النجار، ومعتز قاسم، وبيان العسلي، وضياء التلاحمة، ويحيى عياش، والشهيد الطفل محمد أبو خضيرة، ومحمد الدرة، والشهيدة رزان أشرف النجار، وعشرات الآلاف من الشهداء.
الحديث عن هؤلاء الشهداء والجرحى والصامدين على حدود كرامة الوطن وعزته ليس حديثاً قديماً عفى عليه الزمان، كما يروّج له “المُطبعون”، وليس قصصاً وحكايات اندثرت مع زمن تجاوز 73 عاماً من عمر النكبة.
لا يا هؤلاء، هذه دروسٌ حية، وستظلّ مشتعلة ما دام العدو الصهيوني هو ذاته العدو، وما دام الاحتلال جاثماً في الأرض وعلى صدر الإنسان، وما دام الأسرى أسرى، وما زال بناء المغتصبات التي يسمونها “مستوطنات” مستمراً، وما دام خطاب الكراهية والاستعلاء الصهيوني مستمراً مُنذ 7 عقود، وما دامت الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة مستمرة، وما دامت اعتقالات الفلسطينيين وقتلهم كما هو. إذاً، ماذا تغير في المشهد؟!
سنجيب بكل ثقة: ما دامت المعادلة لم تتغير، فستظل المقاومة مستمرة حتى تحرير الأرض، وسيظل الأحرار العرب والمسلمون داعمين ومساندين لطلائع المقاومين الفلسطينيين جميعاً حتى النصر.
﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾
* المصدر : رأي اليوم