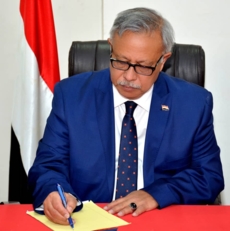فضيحة الماركات تسلط الضوء على "العبودية الأنيقة"
السياسية || محمد محسن الجوهري*
"الماركة" ليست دائمًا أكثر من مجرد نسخة أخرى مما ترتديه بالفعل، لكن بثمن باهظ لا تبرّره جودة ملموسة، بل قيمة رمزية مرتبطة بالاسم فقط. إنها أحد أعراض العصر الحديث الذي اجتاحته الثقافة الاستهلاكية، حيث يتقن المورّدون اللعب على أوتار النفس الباحثة عن التميز والظهور. ومعظم هذه العلامات مملوكة لمؤسسات وأثرياء غربيين، يدركون جيدًا كيف يخاطبون تلك العقد الخفية، ليحوّلوا حاجتنا من الانتماء أو الرفعة إلى فرصة لتحقيق أرباح طائلة.
فعلى سبيل المثال، قد تُباع حقيبة يد بمبلغ 3000 دولار بينما لا تتعدى تكلفة تصنيعها 50 دولار. الفارق كله يُدفع مقابل "الاسم" فقط، أي أننا لا نشتري منتجًا بل وهمًا مُسوّقًا جيدًا.
من الناحية النفسية، يرتبط الهوس بالماركات بحاجة الإنسان إلى الشعور بالقبول والانتماء، أو ربما التميز والانفراد. في عالم باتت فيه القيم الحقيقية باهتة، أصبح المظهر وسيلة مختصرة لتحديد "قيمة" الشخص. فساعة يد أو حقيبة يد قد تصبح في نظر البعض، تعريفًا بهويتهم، لا مجرد إكسسوار. هذه "الرمزية الزائفة" تعززها الإعلانات ووسائل التواصل التي تروج لفكرة أن ما تملكه يعكس من أنت.
أما المنخدعون بهذه الثقافة فهم كثير، أولهم ضحايا الإعلانات، فهناك من يتعرض لغسيل دماغ حقيقي عبر الدعاية وأساليبها البراقة، والتي تقدم المنتج وكأنه حلم سيغير حياة المستهلك وتنقله إلى عالم الأثرياء، سيما في المجتمعات السطحية التي تكثر فيها المقارنات السطحية بين الناس، فيلجأ البعض منهم إلى الماركات كنوع من التجميل النفسي، علّها تمنحهم إحساسًا مزيفًا بالثقة بالنفس.
مؤخراً، وفي إطار الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين، كشفت الأخيرة الكثير من أسرار "الماركات" الأمريكية الغالية، وأوضحت، بأسلوب إعلامي مقصود ومنظم، بأن أغلب تلك المنتجات مصنوعة في الصين، وبتكاليف منخفضة، قد لا تصل إلى 5% من السعر المقدم للزبون، وهذا ما أحدث "فضيحة الماركات" التي حلقت نوعاً من الصدمة في العالم المستهلك.
باختصار، فإن العلامات التجارية الكبرى تتقن فن السمسرة لا أكثر، وتجني من ورائها أرباحاً طائلة، وسلاحها في ذلك "إعلانات" يؤديها المشاهير، وحالة الغباء الاستهلاكي التي تعاني منها المجتمعات الفارغة كدول الخليج، حيث أدى غياب الثقافة الإسلامية الأصيلة إلى ظهور أجيال من الشباب مهووسة بشيء اسمه "الثقافة الغربية".
والكارثة تتجلّى حين تتحول هذه الماركات إلى "آلهة العصر الحديث" – كما وصفها بعض المفكرين – حيث يُعرّف الإنسان نفسه من خلالها، ويُقاتل من أجلها، وينفق لأجلها بلا وعي. وهنا لا نكون أمام استهلاك عادي، بل أمام دين جديد قائم على الطقوس الاستعراضية، والإيمان الأعمى بالماركة، والولاء المطلق لها.
الفيلسوف الفرنسي جان بودريار، في كتابه "مجتمع الاستهلاك"، يرى أن الناس لم يعودوا يستهلكون لأجل الحاجة، بل لأجل المعنى الاجتماعي الذي يحمله المنتج، أي لأجل "الرمز".
أما المفكر الجزائري مالك بن نبي، فقد حذر، قبل نصف قرن، من العبودية الجديدة عندما تكلم عن "القابلية للاستعمار"، وبيّن أن التبعية لا تكون بالاحتلال العسكري فقط، بل حين يُصبح الإنسان تابعًا للغرب في ذوقه، وسلوكه، وحتى ما يُعجب به ويشتريه.
بل إن المفكر الأمريكي هربرت ماركوز تحدّث في كتاب "الإنسان ذو البعد الواحد" عن كيف تسوّق الرأسمالية لحرية مزيفة، تجعل الفرد يظن أنه يختار بحرية، بينما هو مُقيّد بثقافة السوق والإعلان، مما يُنتج مواطناً استهلاكيًا مفرغًا من الجوهر.
وبالتالي، فإن الهوس بالماركات لا يجعل من صاحبه إنسانًا عصريًا أو متقدّمًا، بل في كثير من الأحيان يحوّله إلى كائن وظيفته الوحيدة هي أن يستهلك، ويقيس ذاته بما يملك، لا بما يكون.
* المقال يعبر عن رأي الكاتب