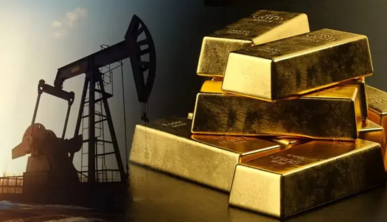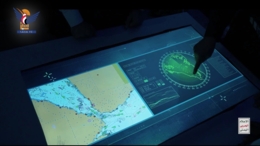الصراع في عالمنا المعاصر: بين من ؟ ولماذا يستعر ؟
السياسية:
الحديث عن محدودية أثر روسيا في الاقتصاد العالمي يكذّبه ارتفاع الأسعار عبر العالم، ولا سيما في الاتحاد الأوروبي.
تستخف الأدبيات الاقتصادية الغربية من روسيا في كثيرٍ من الأحيان، قائلةً إن حجم اقتصادها، إذا قسناه بقيمة ناتجها المحلي الإجمالي GDP، البالغ 1.65 تريليون دولار في عام 2021 مثلاً، لا يصل حتى إلى 2% من الناتج الإجمالي لكل دول العالم، المقدّر بـ94 تريليون دولار، بحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، فيما بلغت قيمة الناتج الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية عام 2021 مثلاً، 24.4% من الناتج الإجمالي العالمي. أما الناتج الإجمالي الصيني، فبلغ، في عام 2021، نحو 18% من الناتج الإجمالي لكوكبنا.
كما جاء الاقتصاد الروسي، بحسب تقديرات المؤسسات الاقتصادية الدولية، من صندوق النقد الدولي إلى البنك الدولي، مروراً بالأمم المتحدة، في المرتبة الـ11 عالمياً من حيث حجمه أو ناتجه المحلي الإجمالي، من بعد دولٍ مثل كوريا الجنوبية وكندا وإيطاليا وفرنسا، التي جاءت في المرتبة العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة، بالتوالي، من حيث حجم اقتصادها عالمياً، رغم أنها أقل مساحةً وسكاناً من روسيا.
غالباً ما يقال بعدها إن الاقتصاد الروسي اقتصادٌ ريعيٌ، يعتمد على تصدير الخامات عموماً، والنفط والغاز خصوصاً. والحقيقة أن التمعّن في ميزان مدفوعات روسيا لعام 2021 (ميزان المدفوعات بالطبع Balance of Payments، هو سجل التعاملات المالية والاقتصادية للاقتصاد الوطني لأي دولة مع بقية دول العالم)، يظهر، بحسب إحصاءات البنك المركزي الروسي، أن صادرات روسيا عام 2021 البالغة 341 مليار دولار أميركي، كان 166.8 مليار دولار منها نفطاً وغازاً وطاقة، بما يوازي نحو 49% من مجموع الصادرات، وأن الـ 174.2 مليار دولار الباقية شكّل القمح والحبوب والمعادن والماس إلخ… جزءاً غير يسيرٍ منها، بالرغم من وجود مكوّن مصنّع لا بأس به فيها، من الأسلحة إلى الآلات والمعدات والسيارات إلى غيرها.
يذهب البعض بعدها إلى التركيز على تأخر قطاع الصناعات الاستهلاكية، مثل السلع المعمرة، والأدوات الكهربائية مثلاً، وتأخر قطاع الخدمات، الخدمات المالية والمصرفية مثلاً، مقارنةً بالغرب والشرق الاقتصاديين، من حيث الجودة.
والحقيقة أن مثل هذا الخطاب عن روسيا شائعٌ إلى حدٍّ كبير، حتى عربياً. فما هي حقيقته؟
إن فحوى الخطاب الغربي فعلياً هو: روسيا ليست قوة دولية عظمى، بل قوة إقليمية منتفخة عناداً وغطرسةً (لاحظوا الرسالة الإعلامية الغربية المتكررة عن “عناد” الرئيس بوتين)، كما أن بنية اقتصادها لا تسمح لها بأن تقارن نفسها بالقوى العظمى. وعليها إذاً أن تلتزم حدود قوتها وترعوي وتفسح في المجال للكبار، أي للغربيين، بحسب المقاييس المعتمدة أعلاه.
لكنْ، دعونا ندقق في مقاييس تقييم حجم الاقتصادات المختلفة، وبالتالي في تقييم وزنها النسبي ومرتبتها العالمية، وعليه، في وزنها الاقتصادي-السياسي، لأن الاقتصاد، مثل الجغرافيا، يستحيل فهمهما إلا في سياق أثرهما أو توظيفهما السياسي، أي يستحيل فهمهما إلا من خلال الجغرافيا السياسية والاقتصاد السياسي، أي من خلال أثرهما على ميزان القوى في النهاية.
* الفرق بين تقييم حجم الاقتصادات القومية بالدولار أو بالعملة المحلية
إن المشكلة الرئيسية في مقارنة حجم اقتصادات الدول المختلفة، من حيث حجم ناتجها المحلي الإجمالي GDP، هي أن الناتج الإجمالي للدول المختلفة يُحسب بعملاتها المحلية، بالروبل واليوان والروبية والريال البرازيلي والروبيا الإندونيسية إلخ…، لأن الناتج المحلي الإجمالي هو قيمة السلع والخدمات التي ينتجها اقتصادٌ ما في عامٍ واحد، وقيمة تلك السلع والخدمات تُقاس بالعملة المحلية بالضرورة، لا بالدولار. ومن ثم يجري تحويل قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية إلى الدولار الأميركي، بحسب سعر الصرف السائد.
لكن المقارنة بالدولار الأميركي تُخفي الكثير. مثلاً، لو كان لديك مئة يوان صيني، فإن قيمتها بالدولار الأميركي اليوم هي 15.71 دولاراً أميركياً، أي أقل من 16 دولاراً. لكنَّ مئة يوان صيني في الصين تشتري أكثر بكثير من نحو 16 دولاراً أميركياً في الولايات المتحدة الأميركية. ولهذا، تفقد المقارنة بالدولار الأميركي أكثر فأكثر من معناها بمقدار ما يزيد الفارق بين القوة الشرائية لـ 16 دولاراً بين الصين والولايات المتحدة، أو بين الصين وأي دولة.
لهذا السبب، وُضِع مقياسٌ آخرُ لحساب حجم الاقتصادات العالمية ومقارنتها، هو مقياس معادل القوة الشرائية Purchasing Power Parity (PPP)، الذي يقيس الاقتصادات بالقوة الشرائية للعملة المحلية، والذي نادراً ما يجري اعتماده في الإعلام، إنما يُعتمد من قِبلِ منظماتٍ دوليةٍ عديدةٍ لإصدار مؤشراتها، ومن ذلك مثلاً، اعتماده من قبل البنك الدولي لحساب عتبة الفقر العالمية، واعتماده من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP لوضع مؤشر التنمية البشرية Human Development Index، واعتماده من قِبل منظمة الصحة العالمية لمقارنة الإنفاق الصحي على الفرد بين الدول، واعتماده من قبل صندوق النقد الدولي ذاته لحساب مقدار الأجور والرواتب لموظفيه في الدول المختلفة، إلخ…، وفي النهاية، اعتماده في حوارات النخب الغربية ذاتها لمقارنة الحجم الحقيقي لاقتصادات الدول.
كيف يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي بحسب معادل القوة الشرائية؟ يجري تقييم سعر سلة من السلع والخدمات بالكميات والنوعيات ذاتها، في الدول المختلفة، وتقدير سعر الصرف الذي يحقق تساوي سعرها بين الدول. مثلاً، إذا كان سعر الصرف الحالي هو 6.37 يوان صيني مقابل الدولار، فإن سعر الصرف الذي يجعل قيمة السلة ذاتها من السلع والخدمات متساوية في الصين والولايات المتحدة قد يكون 3 أو حتى 2 يوان مقابل الدولار، وهو سعر صرف غير معمول به طبعاً، ولكنه سعر الصرف الذي يحقق تساوي القوة الشرائية بين العملتين.
عندما تقارن الأحجام الاقتصادية للدول المختلفة، بحسب مقياس معادل القوة الشرائية، فإن صورة ميزان القوى الاقتصادي تختلف تماماً عمّا هي عليه عندما نقارن تلك الأحجام بناءً على أسعار الصرف السائدة. هنا يقفز الاقتصاد الروسي إلى المرتبة السادسة دولياً، بناتج محلي إجمالي قيمته 4.32 تريليونات دولار، بدلاً من 1.65 تريليون دولار والمرتبة الرقم 11 دولياً عام 2021، لتجد بعدها مراهقين يدعون إلى إخراج روسيا من “مجموعة العشرين”!
هذا أولاً. أما الأهم، فهو أن كل اللوحة الدولية تتغيّر، لا بالنسبة إلى روسيا فحسب، بل بين الغرب والقوى الصاعدة دولياً، الجنوبية والشرقية. وسبقت الإشارة إلى الفارق بين حجم الاقتصاد الصيني إذا حُسب بسعر الصرف السائد مقارنةً بمعادل القوة الشرائية (انظر “السباق الاقتصادي الأميركي-الصيني ووطأة الدولار الأميركي”، الميادين نت، 28/2/2022). لكنّ الأمر لا يتعلق بالصين وروسيا وحدهما، بل بعالم يتغيّر، وميزان قوى يميل.
بحسب قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2021، المقوّم بسعر الصرف السائد مع الدولار، فإن أكبر عشرة اقتصادات في العالم هي بالتتالي: الولايات المتحدة الأميركية، الصين، اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، الهند، فرنسا، إيطاليا، كندا، ثم كوريا الجنوبية (لتأتي روسيا في المرتبة الـ 11). وكلها تدور في الفلك الغربي، ما عدا الصين.
أما بحسب قيمة الناتج المحلي الإجمالي الفعلي عام 2021، المقوّم بمعادل القوة الشرائية للعملة المحلية، فإن أكبر عشرة اقتصادات في العالم هي بالتتالي: الصين، الولايات المتحدة، الهند، اليابان، ألمانيا، روسيا، إندونيسيا، البرازيل، فرنسا، ثم المملكة المتحدة.
هذا يعني أن الصين تحل محل الولايات المتحدة في المرتبة الأولى؛ والهند، السادسة بحسب التقويم الأول، تقفز إلى المرتبة الثالثة محل اليابان؛ وروسيا تقفز من المرتبة الـ 11 إلى المرتبة السادسة؛ وإندونيسيا تقفز من المرتبة 16 إلى المرتبة السابعة دولياً، محل فرنسا، التي تتقهقر إلى المرتبة التاسعة؛ والبرازيل تقفز من المرتبة الـ 12 لتحل في المرتبة الثامنة؛ والمملكة المتحدة تتدهور منزلتها من المرتبة الخامسة إلى المرتبة العاشرة، بعد فرنسا (ولعل هذا يؤلمها أكثر من وقوعها بعد ألمانيا في الترتيب الاسمي).
بناءً على ما سبق، فإن المنتفخ عناداً وغطرسةً يصبح الدول الغربية، كما أن اللوحة الجديدة لميزان القوى الاقتصادي العالمي لا تتعلق بروسيا والصين وحدهما، بل بالهند وإندونيسيا والبرازيل. ولو أكملنا تحليل الجداول إلى أول عشرين أو خمسين اقتصاداً بحسب المقياسين، فإن ذلك الاستنتاج سيتعزّز أكثر فأكثر مع تقدّم دولٍ عربية وإسلامية وشرقية وجنوبية عديدة منازل عديدة إلى الأمام، وتراجع دول غربية، أو دائرة في فلك الغرب، مراتب عديدة إلى الخلف (للمزيد حول التحولات الجارية في الاقتصاد الدولي، انظر “اتجاهات النمو في الاقتصاد العالمي اليوم”، مجلة “طلقة تنوير”، العدد 54).
*مقارنات إقليمية وعربية
يحتل الكيان الصهيوني مثلاً المرتبة الـ 30 عالمياً من حيث حجم اقتصاده عام 2021 بالمقياس الاسمي (467 مليار دولار)، أما بمقياس معادل القوة الشرائية، فإنه يسقط إلى المرتبة 50، دوماً بالاستناد إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي التي يسهل إيجادها على الإنترنت. ولعل مثل هذا التقهقر الاقتصادي يعزّز فكرة تراجع منزلة الكيان الصهيوني ووزنه إقليمياً. وهذه لعناية من يُصرّون على المراهنة عليه.
على سبيل المقارنة، تبلغ قيمة الناتج الإجمالي المصري عام 2021، بسعر الصرف السائد، نحو 400 مليار دولار، في المرتبة الـ 36 عالمياً، أما بمقياس معادل القوة الشرائية، فإن حجم اقتصاد مصر يصبح 1.346 تريليون دولار، لتنتقل إلى المرتبة الـ 22 عالمياً.
يبلغ حجم الاقتصاد السعودي، بالمقياس الاسمي، أكثر من 842 مليار دولار عام 2021، وتأتي منزلته في المرتبة الـ 19 دولياً، أما بالمقياس الفعلي، فحجم الاقتصاد السعودي هو 1.7 تريليون، ومرتبته تصبح 17 دولياً.
الاقتصاد الإماراتي، ثالث أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية ومصر بالمقياس الفعلي، وثاني أكبر اقتصاد عربي بالمقياس الاسمي، يحافظ على منزلته، وهي 34 دولياً، في الحالتين، بعد إضافة 230 مليار دولار إلى قيمة اقتصاده الاسمي.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن الناتج الإجمالي الإيراني عام 2021 كان أكثر من تريليون دولار و81 مليار دولار، أما الفعلي فبلغ تريليون ونحو 150 مليار دولار، رغم كل العقوبات المفروضة على إيران، وكان يمكن من دون هذه العقوبات أن يكون ناتجها المحليّ الإجمالي أكبر بكثير. على الرغم من ذلك، فإنها جاءت في المرتبة الـ17 دولياً بحسب التقييم الاسمي، والـ24 بحسب التقييم الفعلي.
أما تركيا، فبلغ ناتجها الاسمي عام 2021 نحو 800 مليار دولار، والفعلي 2.75 تريليون دولار، في المنزلة الرقم 11 عالمياً عام 2021، وهو مؤشر على الصعود الإقليمي لتركيا لا بد من الانتباه إلى خطره جيداً، بالنظر إلى مشاريع التوسّع العثمانية. فهو في ميزان القوى الاقتصادي أكبر من الاقتصاد السعودي أو المصري، أكبر اقتصادين عربيين، ولكنه ليس بالتأكيد أكبر منهما مجتمعين، فضلاً عن تكتّل اقتصادي عربي، فالقومية العربية مركب خلاص، لا شعارٌ جميل فحسب.
*الفارق بين القيمة الاسمية والفعلية لحجم الاقتصادات مشكلة سياسية أساساً
رُب قائلٍ إن الفارق بين تقييم حجم الاقتصادات بسعر الصرف السائد أو بمعدل القوة الشرائية هو شأنٌ يتعلق بقوة العملة المحلية إزاء الدولار فحسب. فإذا كانت العملة المحلية مسعّرةً بصورةٍ ضعيفةٍ إزاء الدولار، أي نحتاج إلى وحدات كثيرة منها للحصول على دولار واحد، أو undervalued بتعبير المالية الدولية، فإن الاقتصاد المحلي سيكون فعلياً أكبر ممّا هو اسمياً، وإذا كانت مسعّرة بصورة مبالغٍ بها إزاء الدولار، أي نحتاج إلى وحدات أقل منها، مما يمكن أن تفرضه السوق الحرة، لشراء دولار أميركي واحد، فإن الاقتصاد المحلي سيكون اسمياً أكبر ممّا هو فعلياً.
وربما يكون هذا صحيحاً في بعض الحالات المحددة، مثل حالة الصين، أو الدول المصدّرة عموماً، التي قد تُضعف عملتها عمداً، لزيادة تنافسيّتها في الأسواق الخارجية، بيد أنه ليس صحيحاً في معظم الحالات. ويمكن أن يُطرح السؤال معكوساً: هل قيمة الدولار الاسمية في العالم أكبر من قيمته الفعلية؟
تتبنّى كثرةٌ من المحللين مثل هذا الرأي. والسبب طبعاً هو الطلب العالمي على الدولار كعملة احتياط لدى البنوك المركزية في العالم، وكعملة للإيداعات والقروض بالعملة الصعبة في البنوك خارج الولايات المتحدة، وكمقياس لتسعير السلع دولياً من القمح إلى النفط والغاز (انظر “السباق الاقتصادي الأميركي-الصيني ووطأة الدولار الأميركي”، الميادين نت، 28/2/2022).
ومثل هذه الهيمنة هي التي تهدّدها التحولات باتجاه المتاجرة بغير الدولار، مع العلم بأن الخطوات التي تزمع روسيا القيام بها، من تحوّل إلى المتاجرة بالعملات المحلية مع الهند والصين وإيران وتركيا، ومن المطالبة بسعر الغاز الروسي من أوروبا بالروبل، ستعزّز الروبل، وتُضعف اليورو أكثر من الدولار الأميركي الذي سيتضرر فقط في حدود ما كان يجري التبادل بالدولار، بين روسيا وشركائها التجاريين، قبل بدء التبادل بالعملات المحلية. وهنا تمثّل إمكانية تحول الصين إلى شراء النفط السعودي باليوان خطراً بصورة أكبر على الدولار.
يعكس الفارق بين سعر الصرف السائد ومعادل القوة الشرائية، إذاً، عوامل بنيوية في الاقتصاد والمالية الدولية، منها هيمنة الدولار الأميركي، ولذلك فإننا لا نتحدث عن مسألة محض إحصائية هنا للمتخصّصين. ولنا أن نتخيّل كيف ستقل قيمة الدولار، إذا قلّ الطلب العالمي عليه، ولو نسبياً، ما يزيد من قيمة العملات الأخرى إزاءه، ويزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي، بحسب سعر الصرف) للدول التي تستعمل تلك العملات مقابل حجم الناتج الإجمالي الأميركي. ويصح مثل هذا الكلام على اليورو، وإن بدرجة أقل، ومن ثم على الجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري وغيرها من العملات الرئيسية (ما عدا اليوان).
في المقابل، لو نظرنا إلى التقارير الغربية التي تتحدث عن تقلص الاقتصاد الروسي في العام الحالي بنسبة 10% (انظر مثلاً موقع بلومبرغ في 25/3/2022)، بسبب أثر العقوبات الغربية، فإن من الواضح أن مثل تلك التقديرات تستند، في جانبٍ منها على الأقل، إلى توقع انهيار الروبل الروسي، وهو ما سيؤدي إلى تقلص الناتج الروسي الإجمالي اسمياً أكثر بكثير من تقلصه فعلياً، ولا نقول إن روسيا لن تتضرر. لكنّ صانع القرار الروسي تعامل مع جذر المشكلة جذرياً: العمل على إسقاط هيمنة الدولار الأميركي، أو تحييد أثره على الاقتصاد الروسي على الأقل.
*عوامل بنيوية أخرى ذات بعد سياسي
تؤثر عواملُ بنيويةٌ أخرى على الفارق بين القيمة الاسمية والقيمة الفعلية للنواتج المحلية الإجمالية لدول العالم، أو على الفارق بين سعر الصرف السائد وسعر الصرف بحسب القوة الشرائية للنقود عبر البلدان، وعلى رأس تلك العوامل مدى وجود سلع وخدمات محلية غير قابلة للاتجار بها non-tradables عبر الحدود، أو حتى عبر محافظات البلد الواحد في بعض الحالات. ومن ذلك، على سبيل المثال، بعض أنواع الخدمات الشخصية (حلاقة الشعر مثلاً)، أو الخدمات الحكومية (الإدارية وغيرها)، أو أسعار العقارات وإيجارها (التي تختلف بين منطقة وأخرى، لا بين دولة وأخرى فحسب، حتى لعقارات بالمواصفات والمساحة ذاتها).
إن السبب الرئيسي لهذه الفروق هو أن مثل هذه الأشياء لا يمكن تعليبها و”شحنها” وتصديرها واستيرادها، وبالتالي فإن أثر عوامل العرض والطلب المحلية فيها يظل أقوى من العوامل الإقليمية أو الدولية. ولذلك، يمكن تخيّل سعرٍ واحدٍ لبرميل النفط أو طن القمح عبر الحدود، مع أخذ كلفة الشحن والتعرفة الجمركية بعين الاعتبار، ويصعب تخيّل سعرٍ واحدٍ لما يلتصق جغرافياً بمناطق محددة، فلا يمكن استيراده وتصديره.
يمكن نظرياً تخفيف فروق الأسعار للمواد غير القابلة للاتجار بها عبر المساحات إلى الحد الأدنى من خلال: 1) السماح بحرية تنقل العمال والموظفين تماماً بين الدول، 2) خصخصة القطاع العام، ومنه خدماته الإدارية، تماماً، 3) إلغاء الترسيم الإداري والمناطقي وكل قوانينه على مستوى وطني وجعله عالمياً، لتنشأ مدنٌ وضواحٍ وأريافٌ على مستوى الكوكب. وكل ما سبق هو مشروع العولمة في المحصلة النهائية. ولكن هذا بحدّ ذاته هو أحد جوانب الصراع بين القوى الصاعدة والهيمنة الغربية: عولمة تحكمها الشركات الكبرى، أم نظام عالمي متعدّد الأقطاب يتيح لكل أمة أن تأخذ مكانها فيه؟
إن وجود العمالة الآسيوية، والعربية إلى حدٍ أقل، في الإمارات والسعودية مثلاً، يجعل كلفة الخدمات الشخصية فيهما أدنى من المعدل الغربي، وبالتالي يجعل قيمة ناتجهما المحلي الإجمالي الاسمي أدنى من قيمته الفعلية، عندما نسعّر تلك الخدمات بمعادل القوة الشرائية لا بسعر الصرف السائد.
كذلك، تقدم الدول التي يوجد فيها قطاع عام قوي، مثل الصين وروسيا، الكثير من خدماتها الحكومية بسعر التكلفة، أو أقل، فيما سترتفع قيمة تلك الخدمات لو تمت خصخصة القطاع العام وبيع خدماته بسعر السوق، ولذلك فإن الدول التي تعتمد القطاع العام أكثر من غيرها ستكون قيمة ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي أقل من الفعلي، لو جرى تسعير تلك الخدمات الحكومية بالدولار، بالسعر الغربي مثلاً.
المشكلة هنا إذاً، أيضاً، هي درجة اتباع الاقتصاد النموذج الغربي، لا بل درجة رسملته، واندماجه في عجلة الاقتصاد العالمي، أي درجة خضوعه لقوانين حركة الاقتصاد الرأسمالي المعولم. ولن ندخل هنا في مشكلة تقييم الإنتاج غير الموجّه للسوق، الزراعي أو الحرفي، الذي ما برح شائعاً في كثيرٍ من الأرياف وضواحي المدن حول العالم، والذي يجعل الاقتصاد الاسمي يبدو أصغر ممّا هو فعلياً، لأن قيمة الإنتاج المنزلي، أو الإنتاج الموجّه للاكتفاء الذاتي أو المجتمعي المحلي، لا تُحسب في الناتج المحلي الإجمالي أصلاً.
*روسيا ليست دولة متخلفة
لقد أظهرت الأزمة الأوكرانية مدى اعتماد العالم على الصادرات الروسية من الطاقة والغذاء والمعادن. لذلك، فإن الحديث عن محدودية أثر روسيا في الاقتصاد العالمي يكذّبه ارتفاع الأسعار عبر العالم، ولا سيما في الاتحاد الأوروبي، الناتج عن فرض العقوبات على روسيا، وهو ما يبرز الفارق أيضاً بين الاقتصاد الحقيقي، القائم على الإنتاج، والاقتصاد المالي، القائم على تقطيع الكوبونات، وتداول الورق، وعلى رأسه الدولار.
وفي الواقع إن ما جاء أعلاه، عن انتقال روسيا إلى المكانة السادسة عالمياً، بدلاً من المكانة الـ 11، إذا قسنا ناتجها الإجمالي بمعادل القوة الشرائية بدلاً من سعر الصرف السائد بين الروبل والدولار، لا يعبّر عن الحقيقة كاملة، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار أن روسيا لا تؤخذ وحدها، بل مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تأسّس عام 2015، والذي يضمّ، إلى جانب روسيا، روسيا البيضاء وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان، ومن المتوقع أن تنضم إليه أوزبكستان في العام الحالي أو الذي يليه.
فلو حسبنا الناتج الإجمالي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإنه سيحل عالمياً في المرتبة الخامسة، بدلاً من ألمانيا، بناتج محلي إجمالي مقداره 5.1 تريليونات دولار، بحسب معادل القوة الشرائية، بناءً على إحصاءات صندوق النقد الدولي ذاتها.
أخيراً، وليس آخراً، من البديهي أن الدول لا تقارن من حيث حجم اقتصاداتها فحسب، بل من حيث الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا فيها، ومدى التخصّص وحسن الإدارة، وغيرها من المقاييس. ولهذا، فإن الاقتصاد الصهيوني يبقى خطراً داهماً، من خلال التطبيع، على الرغم من تقهقر حجمه النسبي دولياً.
كذلك نشير إلى أن الصناعة العسكرية والفضائية الروسية متقدمة جداً، وتنافس دولياً، وهي تصدّر سنوياً ما يعادل مليارات الدولارات من الأسلحة المتقدمة والمفاعلات النووية والآلات. كما أن الصناعة تمثّل 30% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي، وثمة نهضة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات في روسيا. على سبيل المثال، ارتفعت صادرات البرمجيات 20% عام 2021 عن العام الذي سبقه، وكانت قد بلغت 8.6 مليارات دولار عام 2020.
*بقلم : إبراهيم علوش ـ صحفي
*المصدر: موقع الميادين ـ المادة الصحفية تعبّر عن رأي الكاتب