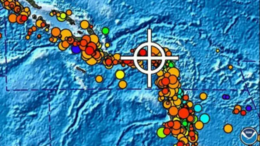الكيان الصهيوني.. حقيقة التقدم الاقتصادي والاستيلاء على الثروات
السياسية:
هذه محاولة تتناول حقيقة الوضع الداخلي لدولة الكيان الصهيوني وعوامل الإسناد الخارجية. طالما قدمت المصادر السياسية والإعلامية دولة الكيان الصهيوني على أساس الدولة المثال والمعجزة في كل أبعاد الحضارة والمدنية (المنوال الاقتصادي، التقدم العلمي، احترام حقوق الإنسان، التطور الحضري…).
لكن ما يخفى على الكثيرين هو أن اقتصاد الكيان الصهيوني يعتمد على مقدرات الأراضي الفلسطينية الطبيعية ويستند في جزء منه أيضاً إلى اليد العاملة الفلسطينية.
منذ 1967 ارتبط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ارتباط عضوي في مجالات التجارة، الضرائب، العمل والصناعة. لكن هذه العلاقة ليست علاقة تكافؤ بل هي علاقة سيطرة تهيمن فيها القوى الاقتصادية الصهيونية على مصالح الاقتصاد الفلسطيني. ما خلق اقتصاداً فلسطينياً ضعيفاً معتمداً أساساً على مصادر الدخل الخارجية مع غياب سياسة لتصحيح الاختلالات، ومنها كيفية التصرف في الموارد الطبيعية وحصة كل طرف.
كما أكدت سياسات الكيان الصهيوني ذات الطابع الاحتلالي قدرتها على الامتداد إلى اقتصادات ومقدرات بلدان المنطقة.
يعتمد الاقتصاد الصهيوني في نسبة هامة منه على اليد العاملة الفلسطينية في قطاعات حيوية مثل الفلاحة والبناء. يتجلى ذلك فيما لحقه من خسائر إثر الانتفاضة سنة 1987، حيث اضطر الصهاينة إلى الاستعانة باليد العاملة الأجنبية. وبين 1987 و1993 شهدت سياسة التأجير الصهيونية أقصى درجات توحشها. فبعد أن دعت المقاومة إلى إعلان العصيان والانقطاع عن الذهاب للعمل، وبعد التحاق العديد من العمال بالمقاومة، والفراغ الذي شهدته قطاعات مثل الفلاحة والبناء في الأعوام الأولى، أعلنت الحكومة الصهيونية بداية حقبة جديدة في تاريخ اقتصادها. واستقدمت أكثر من 200 ألف عامل من بلدان مختلفة. كان ذلك أساساً بضغط من المستوطنين الذين تملكوا الأراضي الفلاحية. ورغم عددهم الضعيف فإن أرباب العمل في القطاع الفلاحي، مالكي الأراضي يمثلهم الكثير من النواب في الكنيست الإسرائيلي. يعتبر ميدانهم من أهم معاقل الاقتصاد الصهيوني الذي هو بحجم تأثيرهم على القرار السياسي. حين فقدوا أكثر من ثلثي العمال الفلسطينيين أجروا اتفاقاً مع السلطة بحيث يشغلون عدداً أكبر من الصهاينة إذا ما وافقت على قرار استقدام عمال أجانب. حتى في أواخر الانتفاضة نجح هؤلاء في حث الحكومة على الموافقة على تشغيل 2750 عاملاً تايلاندياً إضافياً نظراً أن نظرائهم الفلسطينيين “يشكلون خطراً وتهديداً لسلامته أرباب العمل ولسلامة زملائهم العمال الآخرين”.
الاستيلاء على الماء
منذ القرن الفارط، استشرفت أبحاث الكيان الصهيوني وضعية ندرة المياه وما يمكن أن يترتب عنها من تبعات سلبية على تطور الاقتصاد. منذ 1982 كان من المعروف أن الميزانية العمومية للموارد والاحتياجات ستكون ناقصة. ومنذ ذلك الحين، وفي كل عام يتوقع المختصون تواصل العجز في السنوات المقبلة. لاعتبارات مناخية وديمغرافية، لن تتمكن الأمطار المحدودة، من تلبية حاجيات الكيان الصهيوني (مؤشرات اختلال التوازن البيئي وارتفاع الحرارة: ما يقارب ثلثي كمية الأمطار تتبخر دون التمكن من استغلالها. كما شهد الكيان 3 سنوات من الجفاف). ولمواجهة هذه المعضلة أصبح الري الحل الوحيد لمواصلة الأنشطة الفلاحية. وازداد الطلب المحلي على المياه باطراد ليصل إلى 600 مليون متر مكعب كما تحصل الصناعة على حوالي 200 مليون متر مكعب من المياه. وبما أن الموارد الأساسية المتاحة لا تفوق 2000 مليون متر مكعب، فإن التوازن قد يكون عن طريق إعادة تدوير المياه المستعملة المنزلية تحسين تقنيات الري في الزراعة، تحلية مياه البحر، التخطيط الدقيق للاستخدام المنسق للمياه، الترابط بين المناطق الغنية بالمياه والمناطق الجافة عن طريق النقل بواسطة القنوات وأنابيب الضغط، وتخزين المياه في الخزانات الطبيعية لبحيرات التلال وطبقات المياه الجوفية. مع ذلك يتوقع الخبراء أنه في المستقبل سوف ينمو الطلب بنسق سريع وسوف يبلغ حجم الحاجة إلى المياه 2.4 مليار متر مكعب سنة 2030.
نظراً لأهمية وندرة المياه، ومثل كل نظام ذي طبيعة احتلالية استيطانية، كان من الضروري بالنسبة للكيان السيطرة على المصادر الطبيعية للمياه. كان ذلك خدمة لهدفين، منع تطور الفلاحة الفلسطينية وتمكين الفلاحة في أراضي المستوطنات. لطالما كانت المياه الواقعة في الضفة الغربية ذات دور محوري وأهمية مزدوجة بالنسبة لدولة الكيان. إذ إضافة لاستعمالها في ميدان الفلاحة، ومن نظرة سياسية تمثل سلاحاً مهماً في حرب السيطرة والمواجهة.
إن جميع الموارد المائية الفلسطينية مشتركة، فالكيان يزاحم العرب في الأرض ومواردها. ورغم أن استغلال أي مورد طبيعي تحدده اتفاقيات ومعاهدات فإن دولة الكيان كانت دائماً ما تتجاوز هذه المعاهدات في تحدٍّ لكل المجتمع الدولي بمنظماته التشريعية والقانونية. بعد إعلان تقسيم فلسطين، وضع إريك جونستون حلاً لقضية تقسيم المياه الإقليمية المتمثلة في حوض الأردن بحيث يجب أن تذهب 55% إلى الأردن (والتي تضمنت في ذلك الوقت الضفة الغربية)، و26% للكيان الصهيوني، و9% لسوريا و9% للبنان.
تم قبول خطة جونستون من قبل اللجان الفنية للدول الواقعة على ضفاف النهر لكن لم يتم التصديق عليها، إذ كان واضحاً أن إبرام مثل هذا الاتفاق هو بمثابة اعتراف ضمني بالدولة الصهيونية. ومنذ ذلك الحين تم استغلال مياه نهر الأردن للقيام بمشاريع من جانب واحد دون الامتثال لتقسيم حصص المياه التي تم اقتراحها. خلقت اتفاقيتا أوسلو الأولى والثانية أملاً بحل الخلاف المتعلق باستغلال المياه. بحيث يكون هنالك استخدام منصف للموارد المائية آخذاً بعين الاعتبار حقوق كل طرف حسب حاجياته. لكن الاتفاقية كانت محل نقد من المختصين الفلسطينيين. فالاتفاق تجاهل مسألة التوزيع المنصف والمعقول للموارد المائية المتاحة. وفقاً لذلك، تم الإبقاء على التقسيم غير العادل لنظام المياه الجوفية المشتركة، وإبقاء الحصص ذاتها: 80% مخصصة للصهاينة و20% مخصصة للفلسطينيين. ويتم تقاسم الموارد بشكل متفاوت: الكيان الصهيوني يحصل على متوسط 330 متراً مكعباً من المياه سنوياً، مقارنة 190 بالنسبة للأردني وأقل من 150 بالنسبة للفلسطيني. وزاد عدد السكان الفلسطينيين خمسة أضعاف في 50 عاماً، من 000 700 إلى 000 800 لاجئ عربي في عام 1948 إلى أكثر من 3.75 مليون في عام 2000 في الضفة الغربية وغزة. أما الموارد المائية خارج الخط الأخضر، بما في ذلك جزء كبير من المياه الجوفية، فتدار من قبل جانب واحد وهو الكيان. استخدام هذه الموارد لا يلتزم بإطار اتفاقيات أوسلو من حيث كمية المياه التي يمكن استخراجها سنوياً.. وقد أبرمت إسرائيل، من جانبها، في أوائل عام 2004 اتفاقا مع تركيا لتوفير 50 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.
إن سياسية تعامل الكيان مع موارد الأراضي المحتلة على مر السنوات واختلاف حقبات القضية تضعنا أمام حقيقة لا تقبل التشكيك أو التفنيد. إن الكيان الصهيوني هو كيان غاصب لا يقيم وزناً إلا لمصلحة مواطنيه بينما يعاني بقية سكان فلسطين من مشاكل أعمق بكثير متأتية من الافتقار إلى هذه الموارد الأساسية.
سرقة النفط والغاز
إن لجدار الفصل أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد الصهيوني. كان الغرض منه ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية التي تحتوي على ثروات طبيعية (9). ورغم صدور قرار من محكمة العدل الدولية لا يزال الجدار موجوداً. إذ ليس من المتوقع هدمه وهو الذي تم إنشاؤه بعد أن أخذ الكيان بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات التي تخص الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز. تقوم دولة الكيان بالتنقيب على النفط والغاز ثم تبيع الغاز المنهوب إلى دول عربية. هذا ما يؤكده آلان كوهين رئيس مركز “مناطق جيم في مؤسسة بن كوم الإسرائيلية” التي تهدف إلى تحقيق المساواة في قضايا تطوير وتوزيع الموارد الطبيعية. وباعتبار أن النفط ذو جودة عالية (كمية السلفات وكمية الماء ليستا عاليتين) فإن الصهاينة يستعملونه بفعالية لتزويد الطائرات. وكما تطورت القضية الفلسطينية وتغيرت موازين القوى كذلك تغيرت خطة الصهاينة في التنقيب على هذه الموارد الطبيعية: في الستينيات كانت في مناطق 1948، في السبعينيات في عمق الضفة الغربية، في الثمانينيات أطراف وحدود الضفة الغربية في اتجاه مزيد السيطرة على ثروات الفلسطينيين؛ تاريخياً كان المهندس المسحال أول من أجرى مبادرات في سبيل تمتع الفلسطينيين بحقهم في استغلال مواردهم. اقترح المسحال على ياسر عرفات التنقيب عن النفط والغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة استناداً إلى دراسة أجرتها شركة بريتش جاز.. إلا أن المهندس أوقف الأشغال لعدم ملاءمة عرض الشركة البريطانية بريتش جاز التي أرادت أن تؤول أكبر نسبة لها (كما حاولت رشوة المهندس الذي رفض بيع وطنه).
لكن تقول أرملته إنه فوجئ بتلقي رسالة من نفس الشركة تفيد بأنها تتواصل مع الرئيس عرفات عبر المستشار الاقتصادي محام رشيد المعروف بخالد سلام وبأن اتفاقية قد تم توقيعها فعلاً مع السلطة! تفيد هذه الاتفاقية بتمتع الشركة بـنسبة 90% من كمية الغاز المستخرجة من العمليات البحرية إضافة إلى حق تسويق الغاز. رغم ذلك تمكن المسحال من إقناع عرفات بتعديل الاتفاقية وتخفيض حصة البريطانيين إلى 60%. في حين لا تحصل السلطة على شيء. في محاولة أخرى لتحسين بنود الاتفاقية كتب المسحال ثانية إلى عرفات لإقناعه بتمتع السلطة بجزء من الأرباح وللاستفادة من نسب معينة من الإنتاج. نجح المهندس مرة أخرى في إقناع السلطة الفلسطينية بتحسين بنود الاتفاقية.. لكن تم التلاعب بالاتفاقية وتغيير النسب بعد سنوات! لاحقاً تبين أن بعض الشخصيات في ملف اتفاقية الغاز الفلسطيني قد صدرت بحقها أحكام قانونية في قضايا فساد. تشير الاتفاقية إلى حق التنقيب في المياه الإقليمية الفلسطينية لمدة 25 سنة قابلة للتمديد. كما أن الامتياز منح على جميع المياه الفلسطينية في بحر غزة. وليس في ذلك سوى إثبات لتواطؤ داخلي وسعي صهيوني مستمر ومتواصل نحو الاستفادة من الموارد الفلسطينية تواصل التفاوض بما يضمن الحقوق الفلسطينية، حيث منح فقط الامتياز إلى المناطق التي تم فيها اكتشاف الغاز المعروف حالياً.
لكن عادت الحكومة الصهيونية لتمنح رخص تنقيب للشركات المختصة منها الشركة الصهيونية جفعات عولام عام 1992 لمدة 18 شهراً. بعد حفر 3 آبار استكشافية، وفي 2004 اعترف الصهاينة باكتشاف حقل مجد 5 ومنح للشركة عقد إنتاج لمدة 30 سنة. تعاملت السلطات الفلسطينية بعدم مسؤولية وتواطؤ حين نقل إليها الشهود والباحثون معطيات حول النهب من تنقيب واستخراج. كان ماهر غنيم وزير شؤون الاستيطان والجدار الفلسطيني متردداً في اتخاذ القرار الملائم، وقال إنه يجب أن توجه رسالة رسمية للصهاينة لضمان حق الفلسطينيين. بعد التدقيق في المعلومات أوصى الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الأسبق، بألا يتم التحدث في الموضوع وإحالة الملف نحو القضاء. حاولت السلطة إيجاد عطاء عالمي للتنقيب عن البترول في الأراضي الفلسطينية أي الضفة الغربية لمصلحة الفلسطينيين. وكان المشرف على إعداد العطاء محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار ونائب الرئيس في الشؤون الاقتصادية. لكن شكك الدكتور التميمي، رئيس الهيدرولوجيين الفلسطينيين، في جدية السلطات الفلسطينية في حل هذه القضية. ونقد آلية طرح العطاء من قبل السلطة وقال إنه لم يتم إرفاق خرائط تفصيلية للعطاء، لا يمكن لأي شركة أن تتقدم للعطاء دون خرائط تفصيلية ودراسات تاريخية مسبقة. لكن لم يتقدم سوى عرض وحيد. فكان الحل اللجوء إلى صندوق الاستثمار لإنشاء شركة تنقيب.
كما يتهم وليد عساف، وزير هيئة مقاومة الاستيطان والجدار، الصهاينة بالتنصل من الالتزام ببنود اتفاقية أوسلو، حيث يقول إن الاتفاقية لا تنص على بقاء مناطق جيم بل تقول إنه سيتم تسليم كل المناطق إلى الفلسطينيين على أن تبقى المعسكرات المستوطنات والقدس بيد الصهاينة إلى انتهاء المفاوضات.
إن هذه الاتهامات التي يوجهها المختصون والمسؤولون في مجال مهم كمجال الموارد الطبيعية والطاقة، لا يخلق فقط إحساساً بالحيرة بخصوص السيادة الطاقية والاكتفاء الذاتي من الطاقة للشعب الفلسطيني فقط، بل يحمل تلميحات إلى وجود شبهات فساد. هذه الشبهات تطال شخصيات لا تزال المحرك الرئيسي لقضايا هامة تخص الفلسطينيين، بل القضية الفلسطينية ككل.
إن تعامل الكيان الصهيوني مع ملفي المياه والنفط يؤكد أن بنود اتفاقيتي أوسلو لم تطبقا على أرض الواقع كما كان من المفترض أن يحصل، بل تبرهن أن السلام المزعوم لم يكن سوى فصل من فصول الكذب الصهيوني والتي منها التطور الاقتصادي المزعوم.
بقلم: أميرة حجلاوي
ناشطة تونسية سياسية
*المادة الصحفية نقلت حرفيا من موقع عربي بوست ولاتعبر عن راي الموقع