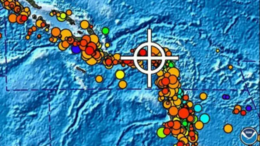المثلث السعودي- القطري- الإماراتي.. أين السيسي وإردوغان؟
حديث عن تحرك قطري مدعوم من إردوغان لمنع أي تقارب عربي مع دمشق، على الأقل قبل الاتّفاق النووي الذي سيحقق لطهران مكاسب إضافيّة.
حسني محلي*
بعد سلسلة من التناقضات التي شهدتها علاقات قطر مع كلٍّ من السعودية والإمارات، بعد انقلاب عبدالفتاح السيسي على الإخوان المسلمين في مصر، وهو ما انعكس على علاقات هذه الدول وسياساتها في اليمن والمنطقة عموماً، عاد الغرام يطبع علاقات هذه الدول، من دون تحديد السبب والهدف!
وعلى الرّغم من المنافسة التقليدية المكشوفة بين الإمارات والسعودية وخلافاتهما في اليمن، عادت الأمور فجأة إلى وضعها شبه الطبيعي بين الرياض والدوحة، بعد قمة العلا في 5 كانون الثاني/نوفمبر الماضي، من دون أن يكون واضحاً لماذا لم تتشجّع أبو ظبي على هذا التطبيع، ورجّحت عليه بكل حماس العدو الأكبر “إسرائيل”.
استغلَّت قطر العزلة الإماراتية عربياً، فسبقت رجب طيب إردوغان إلى المصالحة مع السيسي، ودخلت في حوارات مثيرة مع موسكو، انتهت بالاتفاق في الدوحة، في 11 آذار/مارس الماضي، على آلية جديدة تدعم مسار أستانا، ولكن من دون إيران. وقد أعلنت طهران بدورها تأييد هذه الآلية، مع تحفظها غير المعلن عن “غرام” موسكو مع كل من قطر وتركيا، على الرغم من استمرار دعمهما للمعارضة السورية، السياسية منها والمسلحة، بما في ذلك “النصرة” في إدلب.
موسكو التي عبّرت في اجتماع منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (الأربعاء) عن تأييدها لتحركات قطر الإقليمية، يبدو أنّها تجاهلت تصريحات وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، الذي قال بعد زيارته الأخيرة إلى القاهرة ولقائه الرئيس السيسي إن “موقف بلاده في سوريا لم يتغير، وإنهم ما زالوا ضد الرئيس الأسد”، وهو ما سنراه أكثر وضوحاً في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، الذين سيجتمعون في الدوحة في 8 الشهر الجاري. وتهدف قطر من خلال هذا الاجتماع إلى عرقلة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مع استمرار الضغوط الروسية بخلاف هذا الاتجاه.
يفسر ذلك التحرك القطري المفاجئ للمصالحة مع “عدو الأمس” القاهرة، بل أكثر من ذلك، إقناع الرئيس السيسي بالمصالحة مع الرئيس إردوغان، ليساهم ذلك في إنهاء الخلافات السعودية مع أنقرة، التي يعرف الجميع أنها لن تفكر في أي مصالحة مع الرئيس الأسد، وهو ما لا يخفيه الرئيس إردوغان أبداً.
ويدفع ذلك بعض الأوساط إلى الحديث عن تحرك قطري مدعوم من الرئيس إردوغان، لمنع أي تقارب عربي (سعودي – مصري – إماراتي) مع دمشق، وعلى الأقل قبل الاتّفاق النووي الإيراني الذي سيحقق لطهران مكاسب إضافيّة، بعد ما تحقق لها من تفوق نفسي في انتصار المقاومة الفلسطينيّة في الحرب الأخيرة، فيما يسعى الرئيس السيسيّ لاستغلال الوضع الجديد في غزة لدعم مكانته الإقليمية والدّولية وترسيخها، وبضوء أخضر أميركيّ وأوروبيّ، من دون أن ننسى أن قطر وتركيا، ومعها السعودية، وباعتراف حمد بن جاسم، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، كانت قد قادت الحرب على سوريا منذ بداياتها، كما تبنت السعودية والإمارات، ومعها باكستان، حركات الإسلام السياسي المسلّح، مثل “طالبان” و”القاعدة”، ومن قبلها تنظيمات المجاهدين الأفغان خلال الاحتلال السوفياتي للفترة الممتدة بين العامين 1979-1989.
ويذكر الجميع أيضاً الخلافات التي انفجرت بين قطر وتركيا وكلّ من السعودية والإمارات، اللتين دعمتا انقلاب السيسي في 3 تموز/يوليو 2013، فأعلنوا جميعاً الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً. وقد لجأت قياداته لاحقاً إلى إسطنبول والدوحة.
كما لم يذكر أحد كيف استعدّت الدوحة لمرحلة ما بعد انقلاب السيسي، إذ تخلى الأمير الأب حمد بن خليفة آل ثاني فجأة (قبل انقلاب السيسي بأسبوع واحد فقط) عن منصبه لنجله الشاب تميم، الذي تبنى الإخوان المسلمين بشدة، واستنجد لاحقاً بالجيش التركي بعد تهديدات السعودية والإمارات له في حزيران/يونيو 2017، فأصبح لاعباً إقليمياً بفضل دعم إردوغان له.
وقد أدى دور الوساطة (!) بين طالبان وأميركا، والآن بين إردوغان وكل من السيسي والأمير محمد بن سلمان، العدوين المشتركين السابقين له ولحليفه إردوغان، وهو يقول إنه مستعد لمصالحة الجميع، باستثناء الأسد، علماً بأن إردوغان وآل ثاني كانا الأكثر تقرباً من الرئيس الأسد، وهما الآن الأكثر عداء له، من دون أن يكون واضحاً سبب استمرار موسكو، حليفة دمشق، بتعاونها معهما.
كما لا يدري أحد المبررات والأسباب التي تدفع إلى مصالحة دولتين مهمتين بكل المعايير والمقاييس، كمصر والسعودية، مع دولة بحجم قطر، التي لم تتهرب، بفضل أنقرة، من تحدي هاتين الدولتين، وإلى جانبهما الإمارات، التي تكتفي الآن بمراقبة تحركات قطر عن كثب، من دون اتخاذ أي موقف سلبي أو إيجابي حيالها، ورجّحت على ذلك الدخول على خط المواجهة بشكل غير مباشر، عبر دعم زعيم المافيا سادات باكار، الذي بدأ يكشف خفايا الدولة التركية وأسرارها في العديد من الأحداث الدموية داخلياً وخارجياً، ومنها عمليات الاغتيال الغامضة وتهريب المخدرات، وبالتالي تقديم الأسلحة والمعدات الحربية لجبهة “النصرة” والمجموعات الإرهابية في سوريا.
ويبقى السؤال أو التساؤل عن الدور الأميركي الحالي والمحتمل في مجمل هذه المعادلات، مع حقيقة تواجد القواعد الأميركية والأطلسية في جميع هذه الدول، الصديقة تارة، والعدوة تارة أخرى، مع استمرار حسابات واشنطن في سوريا والعراق، ومع التأكيد دائماً على ضمان أمن “إسرائيل” إلى الأبد، وهو ما لا تعترض عليه الدول “العدوة – الصديقة”، ويبدو أنها متفقة بشكل أو بآخر، ولكل حججها في ذلك حول قضية أساسية، وهي عدم السماح لإيران بترسيخ تواجدها في سوريا ولبنان واليمن، وبالطبع منطقة الخليج عموماً، وإلا فالقضية لا تحتاج إلى كل هذا المد والجزر في المواقف، بعد أن أثبتت السنوات العشر الماضية دورها ومسؤولياتها في أحداث المنطقة عموماً، وبشكل خاص في سوريا، التي تنتهي كل مشاكل المنطقة بحل أزمتها، ولكن بصفاء النيات.
هذا الأمر لا يحتاج إلى أكثر من لقاء واحد، على أي مستوى كان، يتفق فيه الجميع على ضرورة العودة إلى ما قبل العام 2011، حتى من دون أي اعتذار من الشعب السوري، فقد دفع هذا الشعب الكثير إرضاء لغرائز ونزعات البعض من زعماء المنطقة، الذين ساهموا معاً في سيناريو ما يُسمى بـ”مشروع الشرق الأوسط الكبير”، ومن بعده “الربيع العربي الإمبريالي”، الذي قدم ما لا يخفى من خدمات تاريخيّة لـ”إسرائيل”، من دون أن يستخلص هؤلاء الزعماء أي درس من هزيمة “إسرائيل” هذه أمام المقاومة الفلسطينية ومن معها وخلفها من دول وشعوب التصدي والممانعة التي صمدت طيلة السنوات العشر الماضية ضد كل الأعداء.
ويبدو أنهم لم يستخلصوا العبر والدروس، فراحوا يتحايلون على أصحاب هذا الانتصار، وإلا كيف لنا أن نفسر التناقضات التي نعيشها الآن، بعد أن نسي هؤلاء الزعماء كل ما قالوه ضد بعضهم البعض، ولكل واحد منهم الكثير من الأسباب الشخصية والعامة ليكره الآخر أو الآخرين، وهو ما يفسر التحركات القطرية الأخيرة، والغريب فيها أنها حدثت برضا كل الأطراف الإقليمية المعادية والصديقة، بل أكثر من ذلك، برضا الأطراف الدولية، وهي أيضاً معادية وصديقة، وفي مقدمتها روسيا وفرنسا وبريطانيا وأميركا، التي تدير كل تحركاتها العسكرية في المنطقة عموماً من قاعدتي “العديد” و”السيليه” القريبتين من قناة الجزيرة التي “تتحدى الإمبريالية والصهيونية”!
وليس واضحاً كيف سيكون الرد الإيراني على كل هذه التحركات، التي إن لم تساهم في إنهاء الأزمة السورية فوراً، وبمصداقية تامة، فإنَّ المحافظين الذين يتوقَّع لهم الكثيرون انتصاراً كبيراً في الانتخابات القادمة، سيكون لهم موقف أكثر حزماً وحسماً إلى جانب الرئيس الأسد ومن معه في خندق المقاومة، وهو ما أثبتته طهران كنهج عقائديّ استراتيجيّ لن يتغيّر، ولكن قد يزداد عمقاً!
ويبقى السؤال الأهم في كل هذه المعادلات والسيناريوهات: هل سيطوي الرئيس السيسي صفحة الماضي مع “عدوه اللدود” الرئيس إردوغان؟ وكيف؟ وهل سيعملان في سوريا أو ضدها؟ ولمَ؟ وكيف سيكون ذلك؟
وتبقى المفاجأة الأكبر دائماً هي احتمالات المصالحة التركية مع “إسرائيل” بعد سقوط حكومة نتنياهو، الذي كان إردوغان يرى فيه عائقاً أمام محاولاته للمصالحة مع تل أبيب. وقد تبعث بدورها، بحكومتها الجديدة إذا نالت الثقة وعمَّرت طويلاً، إشارات إيجابية إلى أنقرة، ليساعدها ذلك في الخروج من عزلتها الإقليمية والدولية، ولو كان ذلك لمرحلة تكتيكية لا تتناقض مع أهداف “إسرائيل” ديناً وعقيدة واستراتيجية!
* المصدر : الميادين نت
* المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الموقع