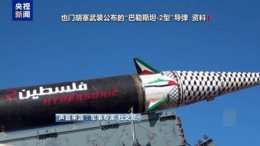كورونا ومناطق الصراع… بين نذير خير ونذير شؤم!
لقد أحدثت جائحة الفيروس التاجي المستجد عواقب بعيدة المدى والعمق في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت الذي تكافح فيه مختلف الدول للبقاء صامدة في وجه هكذا زائر، ما الذي يجري في مناطق الصراع؟ وما هو شكل الأزمة الصحية العالمية في تلك المناطق وما تبعاتها المحتملة؟
بقلم: أرنود جوف
السياسية: (موقع “رافي” الفرنسي – ترجمة: محمد السياري –سبأ)
في خضم الأزمة الصحية التي يشهدها العالم، أطلق رئيس اللجنة الدولية التابعة للهيئة العامة للصليب الأحمر، روبرت مارديني، في 26 مارس الماضي نداء استغاثة عاجل لمساعدة سكان البلدان التي تعيش حالة حرب لتتمكن من الوقوف في وجه الفيروس التاجي المستجد والمعروف باسم كوفيد-19 أو كورونا.
وفي لقاء مع صحيفة ” لوموند” الفرنسية، علق مارديني على تلك الحقيقة قائلاً: “يجب ألا نضع البلدان التي تعاني من الحروب والصراعات الداخلية على هامش اهتماماتنا؛ كما ينبغي أن ندرك جيداً أن هناك ضرورة ملحة للتحرك بأسرع وقت ممكن لمكافحة الآثار المدمرة لتلك الجائحة على شعوب تلك المناطق على وجه الخصوص؛ وليس ذلك فحسب، بل كذلك علينا التنبه من التداعيات العالمية الخطيرة التي قد تترتب على ذلك لتصبح الكارثة أكبر من أن يتم احتوائها”.
يتشارك المركز الدولي لإدارة الأزمات “كريزيس جروب” حالة القلق تلك السائدة في الصليب الأحمر، ويظهر ذلك جلياً من خلال أحدث تقرير له تحت عنوان “كوفيد-19 والنزاعات السياسية: سبعة محاور جديرة بالاهتمام!”؛ وفي هذا الاتجاه يكشف الأخير عن “مخاوفه الكبيرة وعلى وجه التحديد إزاء التقارب الكامن بين التداعيات الحاصلة في إطار الصحة العالمية وتلك المتمخضة عن الصراعات أو المواقف السياسية والتي من الممكن إلى حد كبير أن تؤدي إلى استحداث أزمات جديدة أو حتى التأثير على الأزمات القائمة على نحو يجعلها تتفاقم وتخرج عن نطاق السيطرة”.
وفي 27 مارس الماضي، في إطار مؤتمر صحفي في مدينة “نيويورك” الأميركية، صرح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، موضحاً: “يظهر لنا جلياً من خلال الغضب المدمر الذي يبديه الفيروس المستجد أن الدخول في أي نوع من أنواع الصراع في الوقت الراهن ليس سوى ضرب من الجنون, ولهذا السبب أدعو اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع مناطق الصراع في العالم”.
شح الإمدادات الصحية في مناطق النزاع:
حيثما كانت ساحات المعارك الملأ بالخراب والدمار وأينما وجدت الأزمات والاضطرابات التي طال أمدها وبعُد أفقها، لم تعد الأنظمة الصحية قادرة على القيام بالدور المناط بها بالكفاءة المطلوبة، بل وغالباً أنها أصبحت ضعيفة إلى حد كبير، الأمر الذي يجعلها تقف عاجزة وغير مؤهلة للتعامل مع تلك الجائحة الفيروسية المتنامية, ومما لا شك فيه أن المساعدات الأغاثية الطبية والمستلزمات الصحية لم تعد في الواقع متوفرة في تلك المناطق، وفي حال وُجدت فإنها تكون محدودة إلى حد كبير، ما يفضي إلى تدهور متسارع في الإدارة الصحية بصورة تعود بالسلب على كامل المنظومة.
وفي اليمن، على سبيل المثال، وفقاً للتقارير الصادرة عن الجنة الدولية للصليب الأحمر، فإنه بعد خمس سنوات من الحرب الدامية – التي جعلت ما يزيد عن 24 مليون شخص في حاجة ماسة وعاجلة للمساعدات إنسانية – أصبح أكثر من 50٪ من المرافق الصحية غير صالح للعمل في ظل عجز موظفيها عن الوصول إلى مقر أعمالهم فضلاً عن توقف الأجور منذ أمد ليس بقريب.
ويسود الوضع ذاته في سوريه، حيث لم تعد نصف المستشفيات والمراكز الطبية لرعاية النساء والأطفال ضمن دائرة العمل منذ وقت سابق لانتشار الوباء، بالإضافة إلى استمرار عمليات القصف العنيفة ولا سيما في مدينة إدلب شمالي البلد.
وفي الإطار ذاته، سواء كنا نتحدث عن أفغانستان أو الصومال أو منطقة الساحل – التي تتألف من عدّة بلدان أفريقية تمتد من غرب القارة إلى شرقها، انطلاقًا من داكار ووصولًا إلى جيبوتي – فإن كل منطقة أزمات تواجه مشاكل الاستجابات الصحية التي تتفاقم في كثير من الأحيان جراء عوامل متعددة قد تخلقها عوامل أخرى على غرار سوء إدارة الأزمات وتوغل الفساد وفرض مزيد من العقوبات الدولية كما هو الحال مع إيران.
وفي تقريرها الأخير، استشهدت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات على ذلك بذكر عدة حالات تؤكد تلك الحقيقة:
• فقد تأثرت إيران إلى حد كبير وبشدة على أثر العقوبات الدولية التي فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
• كما واجهت فنزويلا المصير ذاته بسبب الصراع المحتدم بين حكومة تشافيز وقوى المعارضة، الأمر الذي أدى إلى وضع النظام الصحي بأكمله في حالة حرجة للغاية.
• كذلك فقد عانت مدينة غزة الفلسطينية لسنوات طويلة من التدهور الحاد في منظومتها الصحية بسبب الحصار المفروض عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية في ظل كفاحها المستمر من أجل الحصول على المواد والمستلزمات الطبية وحقها في العيش بكرامة.
• ذاك أيضاً هو الحال ذاته في ليبيا، حيث تعهدت حكومة طرابلس، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، بتخصيص ما يقرب من 350 مليون دولار لمكافحة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي يصعب فيه تتبع الفائدة المرجوة من أنفاق هكذا ميزانية طالما وأن النظام الصحي في البلد قد تعرض للانهيار عقب رحيل الأطباء الأجانب خلال فترة الحرب القائمة.
بالإضافة إلى ذلك، عندما تواجه البلدان تحديات أمنية خطيرة تبدأ مؤسسات الدولة في التدهور، ومن الممكن أن تتآكل الثقة المنوطة بالحكومات والسياسيين في ضوء إتساع دائرة العواقب والمساوئ كما كان الحال أبان انتشار وباء “إيبولا” في العام 2014 في غينيا وليبيريا وسيراليون.
وفي تقريرها الصادر في تلك الفترة، لاحظت مؤسسة “كريزيس جروب” الدولية أن “فيروس إيبولا تمكن منذ البداية من الانتشار على نحو يصعب السيطرة عليه، ليس فقط لمحدودية نظام الرقابة الوبائية أو ضعف الإمكانيات أو حتى عدم التفاعل السريع من قبل المنظومة الصحية، بل أيضاً لعدم تجاوب السكان مع التصريحات والتوجيهات الحكومية”؛ وأضافت في وقت لاحق موضحة أن “لتفشي الوباء أسباب أخرى تتعلق ولو بشكل جزئي بالمعلومات الخاطئة والإرشادات السيئة التي كانت تقدمها الجهات المعنية آنذاك، مع عدم إغفال التوترات السياسية والاضطرابات المتكررة في منطقة اتسمت بالحروب على مدى عقد من الزمان”.
صعوبة وصول المساعدات الدولية:
في مواجهة هكذا مواقف كارثية وفي ظل عدم قدرة الدول التي تمر بأزمات على بلوغ المستوى المطلوب لتلبية الاحتياجات، يتم تقديم المساعدات الدولية كمحاولة للتعويض عن العجز في حالات الطوارئ, بيد أنه لطالما كانت تلك التدخلات تواجه العديد من الصعوبات والتعقيدات التي تحول دون نفاذها في كثير من الأحيان في ظل الأزمات الوبائية الخطيرة كما حدث مع وباء شلل الأطفال الذي تفاقم في سوريه في العامين 2013 و 2014 وكذلك وباء الكوليرا المتفشي في اليمن منذ العام 2016.
وفي الآونة الأخيرة، واجهت منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية الدولية، في العام 2019 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عدداً لا يحصى من الصعوبات والمعوقات في احتواء وباء إيبولا الذي اتسعت رقعته في الأجزاء الشرقية من البلد.
وفي هذا السياق تشير المجموعة الدولية لإدارة الأزمات إلى أنه “بالرغم من الدعم المقدم من قبل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إلا أن الميليشيات المحلية المتعطشة للدماء كانت تمنع الوصول إلى بعض المناطق المتضررة من الوباء، وفي بعض الحالات كانت تستهدف فرق الأطباء والمنشآت الطبية ومع أن السلطات الكونغولية ومنظمة الصحة العالمية تمكنوا، على ما يبدو، من القضاء على الوباء في الأشهر الأخيرة، إلا أنه في واقع الأمر قد استمر لفترة أطول مما ينبغي متسبباً في وفاة عدد من الضحايا – مجموع الوفيات المؤكدة 2264 بالإضافة إلى الكشف عن حالة وفاة جديدة في 10 إبريل الجاري – أكثر بكثير مما لو كان أثر على منطقة تتمتع بالاستقرار”.
وبعيداً عن الصعوبات المرتبطة بحالة انعدام الأمن التي تهدد بعرقلة المساعدات الدولية المقدمة إلى مثل هذه المناطق، يبقى الوضع مثيراً للقلق إلى حد كبير ولاسيما لدى الكوادر الطبية والعاملين في المجال الإنساني محلياً ودولياً الذين قد يجدون صعوبة كبيرة في تقديم المساعدات الضرورية للسكان لمواجهة الأوبئة.
ففي اليمن، على سبيل المثال، التي توشك أن تصبح، على غرار جيب إدلب المحاصر في سوريه، من بين مناطق النزاع الأكثر تأثراً وتدهوراً في الوقت الحالي، تم تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية في كلٍ من صنعاء وعدن في إجراء استباقي للحيلولة دون انتشار فيروس كوفيد-19، لاسيما وأن المنشآت الصحية كالمستشفيات باتت تعاني من عدم أهليتها فضلاً عن وجود صعوبات خطيرة في الجانب المائي علاوة على كون فرق الإنقاذ الدولية لم تبقِ من كوادرها سوى الأعضاء الأساسيين للحالات الطارئة.
مأساة النازحين:
هناك العديد من التبعات الكارثية المتمخضة عن الأزمات؛ ومما لا شك فيه أن قضية النازحين تعد من أهم تلك التبعات، حيث يعتبر هؤلاء من بين أكثر الفئات تعرضاً للمخاطر الصحية.
ووفقاً للتقارير الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بلغ عدد النازحين في العام 2019 أكثر من 70 مليون شخص في جميع أنحاء العالم؛ ومن المؤكد أن هذا الرقم قد تم تجاوزه بالفعل في ظل قضايا الصراع المختلفة التي يشهدها العالم اليوم، وبالأخص في ضوء الأحداث الأخيرة في سوريه.
ومع ذلك، فقد أظهر التاريخ أن مشاكل العدوى تبقى محصورة في كثير من الأحيان بين النازحين داخلياً وبشكل خاص في مخيمات اللاجئين، وإن كانت تلك المخيمات تحظى بالحد الأدنى من الخدمات الصحية.
في بنغلاديش، أكدت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات أن ما يزيد على مليون شخص في مخيمات الروهينغيا يعيشون في ملاجئ مكتظة وضيقة المساحة في حين لا يوجد سوى الحد الأدنى من خدمات الصرف الصحي والرعاية.
زد على ذلك، أن ارتفاع معدلات سوء التغذية وعدم قدرة سكان المخيمات على الوصول إلى الرسائل الإلكترونية لإرشادات الوقاية، على أثر قرار الحظر الحكومي على استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت في المخيمات، قد يتسبب في خلق وضع كارثي في حال بدأت تظهر حالات إصابة بالفيروس التاجي المستجد؛ ومرد ذلك أن هذا الوباء من الممكن أن ينتشر كحرائق الغابات بين السكان، الأمر الذي سيجعل من تلك المخيمات منطقة موبوءة وخطيرة على المناطق المجاورة.
وضع مقلق آخر يتمثل في مخيم “الهول” الواقع شمال شرقي سوريه، حيث يقبع ما يربو على 70 ألف شخص من الفارين من الممارسات العنيفة التي قام بها تنظيم الدولة الإسلامية او ما يعرف ب”داعش”؛ ويشكل السوريون والعراقيون، بين رجال ونساء وأطفال، الشريحة الكبرى من لاجئي ذلك المخيم، في حين يحمل أكثر من 10000 لاجئ جنسيات مختلفة؛ ومن المؤسف القول أن جميع قاطني المخيم يعانون من حالة شديدة السوء وعلى مختلف الأصعدة.
وفي هذا علقت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في خريف العام 2019 بقولها: “هي حقاً مأساة إنسانية من الدرجة الاولى؛ ذاك المشهد الذي يبدو عليه مخيم الهول السوري المكتظ بالأمراض والعوز، حيث يفتقر اللاجئين إلى الغذاء والمياه النظيفة وغالباً ما تغيب عنهم أبسط أنواع الخدمات الطبية”.
وبعبارة أخرى، في حال تفشي الفيروس التاجي في المخيمات من المرجح أن يعمد النازحون واللاجئون إلى اتخاذ قرارهم بالتحرك من أجل إيجاد مناطق آمنة، الأمر الذي قد يخلق موجات تتسبب في نشر القلق والاضطراب داخل الدول.
وفي القارة الأميركية، على سبيل المثال، رحبت كلاً من البرازيل وكولومبيا في بداية الأمر بالمواطنين الهاربين من الأزمة القائمة في فنزويلا، ثم ما لبثت أن سارعت إلى إغلاق الحدود أمامهم.
وفي الضفة المقابلة، لم تتوانَ الإدارة الأميركية عن اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها أن تقف دون وصول اللاجئين القادمين من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما مع تطور وتفاقم الوباء، دافعة بهم إلى العودة نحو بلدانهم؛ الأمر الذي حمل كلاً من غواتيمالا والسلفادور، في منتصف مارس الماضي، على إغلاق الحدود الجوية أمام جميع أولئك الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة.
وليس ذلك ببعيد عن الموقف الذي اتخذته المكسيك ودول أميركا الوسطى التي تعاني مسبقاً من آثار الجائحة، حيث رأت كل دولة أن الإقدام على طرد اللاجئين والدفع بهم للعودة إلى مدنهم يهدد بنشر الفيروس التاجي على نطاق أوسع.
ومن الوارد بشدة أن يتسبب الإحجام عن استقبال النازحين في تفاقم العنف كما ينذر بخلق مزيد من الأزمات الجديدة مما قد يتسبب في توسيع دائرة الكارثة على نحوٍ لا تحمد عقباه.
تأثير الأوبئة على الأزمات:
من الواضح أنه يستحيل في الوقت الراهن وضع التقييم المناسب للآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، وبالأخص في مناطق الأزمات التي باتت تعاني دون استثناء من هشاشة كبيرة للغاية في مختلفة جوانبه؛ وعلينا هنا أن ندرك جيداً، كما هو جلي، بأن تلك العواقب سوف تبلغ مستويات قياسية وعلى جميع الأصعدة.
وفي ذلك علقت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات بقولها: “لا زلنا لا نعرف حتى الآن متى وأين سيكون الفيروس أشد وطأة، وكيف ستندمج الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية لإثارة الأزمات أو التسبب في تفاقمها, كما أنه لا يمكننا ان نجزم إذا ما كانت عواقب الوباء ستكون سلبية بشكل كامل أو محدود على قضايا السلام والآمن, فمن المعلوم أن الكوارث الطبيعية كانت تعمل في بعض الأحيان على تهدئة الصراعات؛ ويظهر ذلك جلياً من خلال السلوك المتبع من قبل بعض الأطراف المتنازعة حيث كانت تضطر إلى التعاون أو على أقل تقدير الحفاظ على مستوى مقبول من التهدئة لكي تتمكن من تركيز اهتماماتها وجهودها لحماية مجتمعاتها وإعادة بنائها”.
خلاصة القول، لا شك أن وجود مثل هذا الوباء قد يفضي إلى أحد أمر: فإما أن يكون سبباً قوياً في تفاقم معظم الأزمات الدولية، وإما أن يكون مناسبة أقوى لوضع حد نهائي لكثيرٍ منها وتغيير مسار التاريخ الذي يبدو كما لو كان أمراً محتوم.
ولعل مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت بإرسال مساعدات صحية إلى إيران، التي تضررت بشدة من ذلك الوباء، أو مطالبة الرياض مؤخراً بوقف إطلاق النار في اليمن يمثل خير دليل على أمكانية أحداث ذلك التغيير المتفائل.
* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.