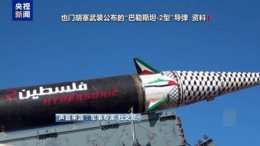هل ستتجه الصراعات في سوريا وأفغانستان واليمن وليبيا نحو طريق السلام
بقلم: مجدوب حامد*
(موقع “أجور فوكس- agoravox” الفرنسي- ترجمة:أسماء بجاش-سبأ)
قُتل ما لا يقل عن 34 جندياً تركياً, في حين جُرح نحو 30 آخرون في محافظة إدلب السورية في غارات نسبها النظام التركي إلى النظام السوري.
ومن جانبها, ردت أنقرة على الفور بقصف مواقع تابعة لنظام الرئيس بشار الأسد, حيث قتل خلال القصف الانتقامي من قبل الجيش التركي قرابة 20 من مقاتلي النظام السوري في شمال غرب سوريا، وذلك وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان, كما لقي جندي تركي حتفه في هجوم جديد شنته القوات السورية.
تسبب قصف المواقع التركية عن مقتل ما لا يقل عن 33 جنديا في سوريا, في أزمة شملت روسيا وسوريا وتركيا بشكل مباشر، مع وجود ملف النزوح في الخلفية.
عقد حلف الاطلسي اجتماعاً طارئاً, اكتفى خلاله بالتعبير عن تضامنه مع تركيا التي تعتبر أحد اعضاء المنظومة, في الوقت الذي يهز فيه تصاعد التوتر المجتمع الدولي.
ومن جانبه, أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من “خطر المواجهة العسكرية الدولية الكبرى” في سوريا.
ففي 28 فبراير الماضي، عرض موقع سبوتنيك الروسي حالة من الحرب بين القوات الحكومية السورية والجيش التركي, كما أشارت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية, إلى أن القوات التركية قامت خلال الأسبوعين الماضيين بالسيطرة على حوالي 130 وحدة من المعدات الحربية من القوات الحكومية السورية.
كما سلطت الوكالة الضوء على الضربات التركية التي استمرت قرابة 17 يوما, تمكنت من تدمير:
– 55 دبابة.
– 18 عربة مدرعة.
– 21 آلية عسكرية اخرى.
– 29 قذيفة هاون.
– ثلاث مروحيات.
– وضع 1700 طائرة عسكرية خارج نطاق العمل.
لذا تبدأ الحرب بمشاركة مباشرة من الجيش التركي في معركة إدلب, ومع ذلك، ففي حين تدعم تركيا وروسيا المعسكرين المتعارضين في سوريا، فقد عززتا تعاونهما بشأن هذه المسألة من خلال رعاية اتفاق لوقف إطلاق النار في قمة سوتشي التي عقدت في العام 2018.
ومن المفارقات أنهم يبقون على اتصال للحيلولة دون انزلاق الحالة مرة أخرى والخروج عن نطاق السيطرة، وقبل كل شيء العنف الذي تسبب في وقوع كارثة إنسانية مع نزوح 900 ألف مدني من الرجال والنساء والأطفال الذين فرو من القتال إلى المناطق الحدودية التركية، وتم الإعلان عن اتفاق ملزم للطرفين في موسكو لوقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا.
دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نفس يوم 5 مارس 2020, عند منتصف الليل من أجل وضع حد لتصعيد العنف في منطقة إدلب, ولكن تركيا حذرت من منع تفاقم وتدهور الأزمة الإنسانية, كما تحتفظ بحق الرد بكل ما أوتيت من قوة وفي كل مكان وعلى أي هجوم من قبل نظام دمشق.
ومن الواضح أن تصعيد الحرب سيكون له تأثير كارثي من الناحية الإنسانية، ولكن أيضا من حيث الدمار والأرواح البشرية ونزوح الملايين من اللاجئين إلى تركيا.
وفي المقابل, لن تكسب روسيا شيئاً من خلال التسبب في كارثة إنسانية وسوف تؤدي المواجهة بين الجيشين إلى نتائج عكسية تماماً لكل من موسكو وأنقرة, وبالتالي ستؤدي هذه الحرب حتماً بالولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف شمال الأطلسي إلى الانحياز إلى جانب تركيا, لذا فإن لم يتم التوصل إلى أي مكاسب ملموسة, سوى الوقوع في مأزقاً مدمر للغاية لكلا للبلدين.
ولإظهار موقفها الجيد من الصراع السوري والأزمة الإنسانية الحاصلة في إدلب، طلبت موسكو عقد اجتماعاً مغلق لمجلس الأمن لاطلاع الأعضاء على اتفاق وقف إطلاق النار، وهو أمر إيجابي جداً ويلمح إلى وجود حل يمكن أن يكون مستداماً.
ومن المحتمل هذه المرة أن تغير هذه الاتفاقية مسار الصراع الدائر في سوريا, حيث أن كل الدلائل توحي بأن البلدين في خضم المواجهة ولم يعد بإمكانهم التراجع في حين أنهم وصلوا إلى طريق مسدود, فهم يصغون إلى بلوغ وجهتهم المنشودة, فإما التوافق أو التقدم في ما لا يمكن إصلاحه.
وبحسب نص الاتفاق الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، ستقوم روسيا وتركيا بتسيير مشتركة اعتبارا من 15 مارس على جزء كبير من الطريق السريع “M4″، وهو محور حاسم بالنسبة للنظام السوري الذي يعبر منطقة إدلب السورية, وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الروس والأتراك بدوريات مشتركة في المنطقة.
يشكل الطريق السريع M4″”، وفقا للاتفاقات المبرمة بين موسكو وأنقرة، “ممرا أمناً” على عمق ستة كيلومترات على جانبي هذا الطريق السريع، وهي منطقة عازلة يبلغ عرضها الإجمالي 12 كيلومترا, وهذا يذكرنا بخط الحدود العسكرية بين كوريا الشمالية ونظريتها الجنوبية، في أعقاب الهدنة الموقعة في يوليو من العام 1953, وإذا كان هذا هو الحال في هذه الحرب الدولية في سوريا في العام 2020، بالطبع مع التطورات الأخرى ولكن ذلك سيعطي السلام للمنطقة.
أن هذه الاتفاقيات ستستنتج عن صراعات أخرى في المنطقة، لاسيما المشتعلة في أفغانستان واليمن وليبيا… التي يتم تجاوزها عملياً من قبل نفس القضايا: الخلافات الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تدخل القوى الكبرى في حيثيات تلك الصراعات.
وللحصول على فكرة عن التطورات التي يشهدها العالم العربي، دعونا نسلط الضوء على مجريات التاريخ الذي أدى إلى هذا الوضع المعقد الذي خيم على العالم العربي والإسلامي.
لذا من الضروري أن نبدأ من المملكة العربية السعودية ونظامها الملكي القائم على الوهابية التي تستمد من خلالها قوة التعبئة لقوتها وتحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة على متن الطراد ” يو أس أس كوينسي” في فبراير من العام 1945, والذي عُرف بميثاق كوينسي.
من المعروف أن العالم الإسلامي سواء كان العالم العربي أو غير العربي مشبعة جداً بالإسلام, وهذه حقيقة تاريخيّة غير ملموسة, حيث تظهر كحماية ضد التغريب من العالم اليوم في كلّ مكان, وبعبارة أخرى، فإن الشعوب الإسلامية تريد التحديث، ولكن على أقل تقدير, تحتفظ بهويتها ودينها الذي ينتمون إليه.
وعلى وجه التحديد هذه الهوية للعالم الإسلامي في الإسلام سمحت للمملكة السعودية خلال فترة السبعينيات، بعد الطفرة النفطية وبفضل دولارات النفط بموافقة الغرب على نشر الإسلام من خلال بناء المساجد في كل مكان من أنحاء العالم.
غير أن الحروب العربية – الإسرائيلية وسياسة الولايات المتحدة المتمثلة في اتخاذ تدابير مزدوجة تجاه إسرائيل والبلدان العربية شوهت هذه الاستراتيجية وأثارت أثرا معاكسا.
أصبح الدين الإسلامي بمثابة قوة مضادة للتجاوزات التخريبية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية والحروب المتعددة التي خلقتها للحفاظ على السيطرة على حقول النفط الغنية في المنطقة.
في أواخر السبعينيات، بعد الحرب العربية الإسرائيلية الأخيرة، انشقت الرابعة، مصر، التي كانت ركيزة الجبهة العربية ضد إسرائيل، بتوقيع اتفاقيات سلام مع تل ابيب, وبالتالي عمل هذا الانشقاق على إضعاف الدول العربية بشكل كبير, في حين أن جبهة الحزم والمتمثلة في الجزائر وليبيا وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية, لن تغير من ميزان القوى ضد إسرائيل التي تتمتع بدعم من الولايات المتحدة.
اندلعت الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979، برعاية الولايات المتحدة التي كانت تخشى من أن يحول الشاه إيران إلى قوة نووية، أطلقت الثورة على الشاه الذي فر من البلد ونصب الثوار مكانه نظاماً إسلامياً.
وما لم يكن في حسبان الإدارة الأمريكية هو أن الثورة الإيرانية سوف تصبح بصورة تدريجية العامل الأكثر ضرراً لقيادتها الأحادية.
حلقة “الحزام الإسلامي”، ستجلب ظهور إيران الإسلامية الاتحاد السوفياتي إلى مواجهة الخوف من امتداد الإسلاموية في أفغانستان، وخطر أن تمتد إلى الجمهوريات المسلمة السوفياتية لدخول في الحرب في أفغانستان.
وفي الوقت نفسه، اندلعت حرب أخرى في فترة ما بين إيران والعراق, حيث تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب القيام بحركتين بحجر واحد: إضعاف اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ووضع حد للنظام الإسلامي في إيران الذي تولى منذ ظهوره قضية الشعب الفلسطيني.
ويضاف إلى هذه الحروب عامل اقتصادي حاسم، والمديونية العالمي، وردود الفعل النفطية.
تم حرمان الاتحاد السوفياتي من عائداته النفطية التي تضاعفت ثلاث مرات من الناحية الاقتصادية بسبب الانخفاض الحاد في إيراداته النفطية، حيث انخفض سعر النفط إلى ١٠ دولارات للبرميل في العام ١٩٨٦، وتقلص صادراته الصناعية، ولاسيما في مجال التسليح إلى بقية العالم الذي كان مدينا، والاستخدام الهائل للمديونية الخارجية، وهو وضع كارثي هز في نهاية المطاف أُسس الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية.
سقط جدار برلين في العام 1989, مع كل العواقب على البلدان الطرفية, كما لم يعد يوجد ما يسمى بالاتحاد السوفياتي في ديسمبر 1991, حيث ورثت روسيا ثلاثة أرباع أراضي الاتحاد السوفياتي, بالإضافة إلى حق النقض في مجلس الأمن بعد أن حلت محله.
ومن خلال إعادة التشكيل الجيوسياسي للعالم، يمكننا أن نرى أن استراتيجية “الحزام الأخضر” التي صاغها مستشار الأمن القومي، حينذاك، زيبغنو بريجينسكي قد نجحت بشكل كامل, ولكن، ما يقال في ضوء الأحداث الحاصلة في يومنا هذا، أن الولايات المتحدة لن تكون منأى عن “الحزام الأخضر” الذي خلقته.
فإذا كانت جمهورية إيران الإسلامية قد عارضت، الإمبريالية الأمريكية منذ ولادتها, في حين عززت الحرب مع العراق من قدرتها العسكرية, كما فعل العراق، وبالتالي فأن البلدان أصبحا قوتين إقليميتين بحكم الأمر الواقع، ونظراً إلى التهديد الذي كانا يشكلهما فيما يتعلق بالوضع الإسرائيلي الأمريكي الراهن في منطقة الشرق الأوسط، كان من الضروري بالنسبة للإدارة الأمريكية أن تعمل على القضاء على الأنظمة التي تمثلها بأي ثمن كان.
وهكذا، ففي العام 1990، تعرض العراق، الذي عمل على اجتياح الكويت، لهجوم من قبل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, وبعد تحرير الأراضي الكويتية, تم فرض حظر على العراق طوال فترة التسعينات.
فتحت فترة رئاسة كلينتون قوساً سلمياً، يتمثل في انتهاج سياسة لا للحرب ولا للسلام, بيد أن دخول بوش إلى البيت الابيض غير الوضع بشكلٍ جذري, فقد أعطت هجمات 11 سبتمبر 2001, الإدارة الأمريكية ذريعة أخرى لاتباع سياسة عدوانية بشكل أساسي، من أجل فرض إرادتها على العالم, كانت فكرة الاستراتيجيين الأمريكيين هي إقامة عالم أحادي القطب تكون فيه واشنطن القوة العظمى الوحيدة والقوة المهيمنة.
وهكذا, كان العالم في العام 2001 على موعداً مع شن الولايات المتحدة حرباً ضد أفغانستان, في حين جعلت من العام 2003 موعداً أخر للحرب على العراق, وكانت الخطة هي إعادة تشكيل المساحة التي تمتد من المغرب إلى باكستان إلى “الشرق الأوسط الأكبر”.
ولكن، بين النظرية والممارسة في الاستراتيجية، ليس هناك فجوة كاملة لتحقيق ذلك فحسب، بل هناك أيضاً أشياء لا يمكن أخذها في الاعتبار والتي يمكن أن تحول الخطة ضد مصمميها.
وعلاوة على ذلك، هناك ” ضَرَائِرُ التاريخ” بمعنى أن كل ما يحدث يجب أن يكون قابلا ً للتطبيق, وهذا ما حدث في الحروب الشاملة التي شنتها الإدارة الأمريكية خلال فترة رئاسة بوش, ليس بالمعنى الذي يقصده الاستراتيجيون في أميركا, بل بمعنى ما سيحدث، وما ينبغي أن يسود على مجرى التاريخ.
وفي الواقع، في حين استغرق الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله في العام 2003 أقل من شهر ونصف، إلا أن الوضع عاد بعد ذلك لصالح المقاومة العراقية, مما تسبب في تعثر القوات الأمريكية على الأراضي العراقية لأكثر من خمس سنوات, نظراً لشراسة المقاتلين العراقيين لدرجة أن وسائل الإعلام الأمريكية قارنتها الحرب في العراق بحرب فيتنام.
وكان من المقرر شن حرب أخرى ضد النظام الإيراني التي عملت على تقديم الدعم للمقاتلين العراقيين, بيد أن الإعصار المداري في المحيط الأطلسي الذي ضرب الولايات المتحدة والذي عرف باسم إعصار كاترينا, بعد أن غمرت المياه مدينة نيو أورلينز، وفي حين كانت لويزيانا في حالة خراب, وهكذا بهتت حرارة الحرب الأمريكية ضد إيران.
تخلت الولايات المتحدة أخيراً عن خطتها الانتحارية للحرب, فهي غارقة في مستنقع الحرب في العراق، وبالتالي كيف سيكون الوضع في حال دخولها حرباً أخرى إيران خاصة إذا كانت الأسلحة التكتيكية (النووية) ستستخدم ضد المواقع النووية الإيرانية المدفونة في أعماق الأرض, فمثل هذا العمل لن يؤدي إلا إلى خلق كارثة نووية للبشرية أجمع.
في العام 2008, أظهرت الأزمة المالية التي اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية, والتي امتدت إلى بقية العالم، أن الإدارة الأمريكية قد وصلت إلى حدودها القصوى واضطرت إلى سحب قواتها من العراق.
وما فعلوه تلخص من خلال توقيع اتفاق مع الحكومة العراقية نص على سحب الولايات المتحدة قواتها المتمركزة في العراق، على أبعد تقدير حتى 31 ديسمبر 2011.
لكن التاريخ سوف يفاجئ مرة أخرى، ولكن هذه المرة من خلال حدث حاسم آخر بنفس القدر والذي ليست الولايات المتحدة غريبة عنه، إنه اندلاع موجة “الربيع العربي” التي جابت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا, في ديسمبر 2010/ يناير 2011, مما أدى إلى انهيار النظام الاستبدادي في تونس، وفرار الرئيس زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية, وتقديم الرئيس حسني مبارك استقالته وإدارة الجيش للسلطة في مصر وتدهور الوضع في سوريا ما أدى إلى حرب أهلية, وفي كل من اليمن وليبيا، اشتعلت أيضاً حروب أهلية، وحتى الآن ظلت جميع الصراعات المسلحة دون حل, أما البلدان العربية الأخرى فقد تأثرت كثيراً بفضل احتياطيات النقد الأجنبي التي مكنت الجزائر والسعودية من شراء السلام الاجتماعي.
بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه, ألم يكن “الربيع العربي” يشبه إلى حد كبير ما حدث للثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
إذا كانت حالة الطوارئ قد أُعلنت في تونس أو حتى أن الحكومة قد فرضت حالة حصار، ووضع الجيش حداً للمظاهرات كما حدث لمظاهرات الصين في العام 1989، خلال احتجاجات تيان والتي انتهت بموجة من القمع، أو في الجزائر، خلال أعمال الشغب التي اندلعت في العام 1988، مع فرض حالة الحصار من قبل السلطات وحظر التجول، لم كان للربيع العربي ببساطة أي وجود, وبالتالي لدفنت الاحتجاجات في تونس في مهدها ولم ينتشر أي شيء إلى بلدان أخرى.
ذات العملية في إيران، حيث لو كان الشاه والجيش الإيراني أعلانا حالة الطوارئ وأسسا حالة حصار، لما نجحت الثورة الإسلامية، ولكان كل شيء، بعد بعض الإصلاحات، قد عاد إلى النظام.
ولكن بما أن الجيوش الإيرانية والتونسية والمصرية كانت مرتبطة بوزارة الدفاع الأمريكية، وبالتالي كان هناك بعض التبعية، فقد كانت الكلمة الفصل هي “السماح لها بالذهاب”، وبالتحديد كان المقصود من قبل المؤسسة الأمريكية عدم التدخل.
قامت إيران بإفشال مخطط الولايات المتحدة في العراق التي استعادت سلطتها مرة أخرى ولكن تمكنت واشنطن هذه المرة من احتلال غير مباشر لبعض الدول العربية عن طريق شعوبها.
وبنفس هذه الفكرة، إدامة الإدارة الأميركية هيمنتها على العالم من خلال وجودها الشامل في العالم الإسلامي حيث توجد أكبر رواسب النفط في العالم.
ولكن مرة أخرى، كما كان الحال خلال الثورة الإسلامية في إيران، في العام 1979، أو من خلال الحرب مرتين ضد العراق، لن يسير كل شيء وفقاً لمنهج الخطط الأمريكية.
دائما نفس الأخطاء والعمى نفسه وذات نفس البثور التي كانت تبدو ميتة وغير عقلانية، ففي الواقع كانت عقلانية وكان لها هدف تاريخي أو أفضل من ذلك مثل الثورة الإسلامية في إيران والذي استوعب تاريخ الربيع العربي.
بل يمكن القول إن الولايات المتحدة الأمريكية قد “تلاعبت” بخططها الخاصة, بالطبع هذا يقال وفقا لنهج تأويلي, خاصة وأن لاعباً آخر كان سيخرج بدوره على الساحة السياسية في الشرق الأوسط.
لن يكون هناك الكثير من الصراعات المتأججة، حيث هزت الأزمات والحروب السياسية المشهد السياسي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طوال العشر السنوات الماضية.
وهذا اللاعب يكمن في الدولة التركية, قبل فترة طويلة من حلول العام 2000، كانت الإسلاموية – وهو مصطلح سياسي وإعلامي وأكاديمي استخدم لتوصيف حركات التغير السياسي التي تؤمن بالإسلام باعتباره “نظاما سياسيا للحكم” ويستخدم هذا المصطلح من قبل المجموعات السياسية المناوئة للإسلاميين- التركية في مرحلة الإعداد، لكنها لم تكن تملك القوة الكافية نظراً لموقع تركيا الخاص في أوروبا.
ولكن مع نهاية الحرب الباردة، والإسلاموية الشاملة التي ترعاه الولايات المتحدة، سيكون لتركيا أيضاً نصيب من الإسلاموية.
ففي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم إنشاء نظام سياسي جديد, عمل على تقويض النظام العلماني منذ أيام كمال أتاتورك من قبل الإسلاميين الذين لطالما سعوا إلى السلطة.
بعد وصول الإسلامي نجم الدين أربكان إلى السلطة، حيث أصبح رئيساً للوزراء، وفي الفترة ما بين 1996-1997، كان الرئيس الحالي لتركيا، رجب طيب أردوغان، هو من تولى السلطة وأصبح رئيساً للوزراء في العام 2003, ثم رئيساً لتركيا في العام 2014.
كان الدور التركي في الحرب السورية أساسياً, حيث أخذت العبء الأكبر على الصعيد الإنساني وعلى التمرد المناهض للنظام في دمشق.
ويمكننا أن نقول من خلال الوضع الحاصل في سوريا، وليس فقط في أفغانستان واليمن وليبيا، أن العام 2020، أوصل كل الأزمات إلى ذروتها.
فهم الآن في أعلى مستوياتهم، ولا يمكنهم الذهاب إلى أبعد من ذلك، لاسيما وأنهم وصلوا إلى بداية اندلاع الصراعات ومن الواضح أنه تم التوصل إلى الحدود وكذلك الأهداف.
وينبغي أن يكون من المعلوم أن التاريخ لا يتوقف عند هدف أو غرض آخر، فالتاريخ، كما يتضح من تطور البشرية منذ بداية الزمان، هو سلسلة من الأهداف التاريخية تتعاقب عليه الملاعب التاريخية واليوم، قام “الربيع العربي” الذي ترعاه الولايات المتحدة بـ “عمله التاريخي”.
فالمقصود ليس أن الولايات المتحدة قد تمكنت من تحقيق أهدافها، بل التاريخ هو من “تلاعب” بها لتحقيق “أهدافها التاريخية” و”أهدافها القابلة للحياة” وهي جزء من مسيرة زمن البشرية.
وهذا هو ما يهم التاريخ، فالإنسان هو الممثل الذي يتصرف بنفسه ولنفسه ولكن أيضا من أجل التاريخ, فهذه هي مفارقة التاريخ البشري.
ولكن كيف يمكننا أن نفهم هذا التقدير للتاريخ الذي يستخدم القوة الأولى في العالم لتحقيق “مكاسبه التاريخية”؟ وللقيام بذلك، يجب أن نعرف من الذي حقق النصر من حيث المكاسب في هذه الحروب.
وبالطبع يتعلق الأمر قبل كل شيء بالقوى العظمى التي تلقي بظلالها على مسيرة العالم, ويجب التأكيد عليه من حيث الثروة والمكاسب الإقليمية.
ثم طرح السؤال في هذه الحروب الشاملة التي تقوم بتسييرها الولايات المتحدة، من الحروب في أفغانستان وفي العراق, وصولاً إلى موجة الربيع العربي، فمن الذي انتصر فيها بالفعل؟
أليس الصين هي من عمد إلى مراكمة احتياطيات النقد الأجنبي منذ قرابة 20 عاماً؟ ابتداء من 171.763 بليون دولار في العام 2000, إلى أن وصلت إلى 3900 بليون دولار في العام 2014.
وبعد أن أصبحت أول دائن للولايات المتحدة وثاني أكبر اقتصاد في العالم في العام 2010، تطمح بكين إلى خلع الولايات المتحدة من العرش باعتبارها القوة الاقتصادية الرائدة في العالم, وهو أمر وارد في ضوء قوتها الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه, ألم تقتني روسيا أيضاً احتياطيات من النقد الأجنبي مع ارتفاع اسعار النفط على مدى السنوات الـ 15 الماضية؟
وبأي نعمة؟ من قبل الولايات المتحدة وأوروبا التي لطالما عملت على خلق سيولة دولية هائلة تصل إلى عشرات تريليونات من الدولار واليورو والين والديون الضخمة لكلاً من الصين وروسيا وأيضا إلى البلدان المصدرة للذهب الأسود.
بالإضافة إلى ذلك، فقد فازت روسيا مرتين:
الأولى: بضم شبه جزيرة القرم في العام 2014، في أعقاب الصراع مع أوكرانيا.
والثانية: في سبتمبر من العام 2015، عندما هدمت جميع الخطط الغربية من خلال قرار التدخل العسكري إلى جانب نظام السوري.
وهكذا ولدت روسيا من جديد من الرماد بعد أن مكثت أكثر من 20 عاما في ظل الكسوف الجيوستراتيجي العالمي.
واليوم، تدرك الولايات المتحدة أن كل الحروب التي شنتها قد أفادت الصين وروسيا من الناحية الاقتصادية وجيوستراتيجية.
وحتى الحروب بالوكالة التي تستخدم تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بتنظيم داعش والتي كانت خيالاً ولكن على المدى الطويل من عمليات القتل والذبح وقطع الرؤوس وتعتيم الإعلامي لتضليل الرأي العام العالمي، كانت بمثابة فشلاً ذريع للولايات المتحدة وأوروبا.
يجب عدم اغفال الذكر عن تساؤلات لوران فابيوس ضد نظام دمشق حيث تستمر الأحداث في مسارها نحو ما هو ضروري للبشرية.
ومن بين جملة أمور أخرى، تبقى الرغبة في السلام للشعوب بعيدا عن تخريب القوى التي هي للأسف جزء من مسيرة التاريخ.
ففي العام 2019، لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل التراجع للعودة إلى انعزالية الأمس، حيث لطالما سعى إلى التشكيك في العلاقات التجارية مع جميع شركائها: الأوروبيين واليابانيين والصينيين.
وبطبيعة الحال، تدرك الإدارة الأمريكية أن “الدولار النفطي” يفيد شركاءها وبقية العالم أكثر من اقتصادها.
ومن الجلي أنه لا يمكن تجاهل الحروب التي قامت الولايات المتحدة بشنها في منطقة في الشرق الأوسط هي التي نما فيها الاقتصاد العالمي بشكلٍ قوي.
وهذه هي مفارقة الحروب التي تشنها القوة الأولى في العالم, ولكن لأي سبب؟ لأن صياغة النفط العربي مدعومة بالدولار الأمريكي.
وتمويل الحرب والاقتصاد الأمريكي الذي لا يتمتع بالمنافسة في التجارة العالمية ولا يزال لديه عجز مزدوج – على الصعيد العام والتجاري – يجبر البنك المركزي الأمريكي باستمرار على إصدار كميات هائلة من السيولة التي تغذي التجارة العالمية.
والشيء نفسه, كان بعد الأزمة المالية التي خيمت على العالم في العام 2008، وبرامج التيسير الكمي التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لإنقاذ الاقتصاد, وفي المقابل، فقد منحت مكانة مرموقة لبقية العالم، وخاصة الصين وروسيا والبلدان المصدرة للنفط.
نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة بين عامي 2009 و2014، ثلاثة برامج تيسيرية كمية متتالية، QE1 وQE2 وQE3، والتي جلبت سعراً صاعداً لمدة ست سنوات في حدود 100 إلى 130 دولاراً للبرميل.
وقد بدأ الوضع يتضح خاصة مع تفشي الفيروس التاجي الذي أثار قلق العالم بأسره, حيث يخشى الناس أن يتحول هذا الوباء إلى قاتل يسلب حياة الملايين من البشر.
ما نراه اليوم هو أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا يكاد يكون كاملاً, ولم يبق سوى 400 جندي أمريكي وفقا للأرقام الامريكية الرسمية. ولكن لماذا هؤلاء الجنود الأمريكيين الـ 400؟
طلبت «قوات سوريا الديمقراطية» بالفعل، وهي قوات مكونة في الأساس من الأكراد، حماية النظام في دمشق من أجل حماية نفسها من تركيا؟ وبالتالي فإن الأمريكان يحتفظون بهذا العدد التافه من الجنود لحفظ ماء الوجه؟
وفي أفغانستان أيضاً، تم التوقيع على اتفاق في فبراير المنصرم مع حركة طالبان من أجل انسحاب آخر من المقرر أن تقوم به القوات الأمريكية, وحتى لو استمر العنف، فإنه لن يشكك في اتفاق السلام الموقع في 29 فبراير 2020.
تدرك الإدارة الأمريكية أن البقاء في أفغانستان وسوريا لم يعد له معنى ولن تذهب إلا من فشل إلى أخر وإنفاق غير الضروري.
وهكذا فازت روسيا بانتعاشها في مسرح الشرق الأوسط وفي مسرح الأزمة الأوكرانية.
وبالمثل، أصبحت كلاً من إيران وتركيا لاعبين رئيسيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لذا يمكننا أن نقول لكابول إذا كان الانسحاب الأمريكيين الأراضي الافغانية مجرد مسألة وقت ستكون قصيرة, وذلك استناداً على نص الجدول الزمني للانسحاب الكامل لجميع القوات الاجنبية من افغانستان والمحدد في غضون 14 شهرا من توقيع الاتفاق, فان روسيا وايران لن تكونا مهتمتين بدعم حركة طالبان, نظراً لأن السلام سيحدث حتما في البلد.
وهناك كل الأسباب التي يمكن أن تشير إلى أن خط الحدود في سوريا بالتحديد في منطقة إدلب سيكون مستداماً، ولن يتمكن النظام السوري من مواجهة دعمه الرئيسي لروسيا التي لا تريد تدمير ما بدأه عندما دخلت عمليات تدخلها في سبتمبر من العام 2015.
إن الانسحاب الأمريكي المزمع من أفغانستان, والوقف الدائم للأعمال العدائية في منطقة إدلب السورية، والمفاوضات التدريجية التي من شأنها أن تحل الأزمة السورية بشكل نهائي وتؤدي إلى إعادة توحيد الأراضي السورية.
سيستغرق الأمر بعض الوقت، فالوقت يصلح الجراح وسيبقى هناك صراعين مهيمنين فقط، وهما الصراع الدائر في اليمن وليبيا.
وهناك كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا من شأنه أن يشكل حجة لصراعات أخرى, ولا يمكن أن يكون هناك مهرب للمملكة العربية السعودية, حيث لا توجد رؤية للانتصار أو الخروج من الأزمة التي لا تزال تروي فصولها منذ خمس سنوات من الحرب مع الحوثيين الشيعة, كما فعلت الولايات المتحدة في سوريا وأفغانستان، وربما يفكر الأمريكيون أيضاً في سحب وحدتهم الأخيرة من العراق.
وسوف تضغط السعودية لتقليد حاميها, حيث لا توجد مكاسب في اليمن للسعودية وحلفائها، كما أن هذه الحرب لا مستقبل لها، ومخرجها الوحيد هو أنها تنهي العدوان وتخرج من الصراع اليمني، تاركة لليمنيين حل مشاكلهم بصورة داخلية, وبالتالي سوف تستفيد إيران وكذلك السعودية.
وبالنسبة لليبيا، بنفس الطريقة, إذا تم حل الصراع في اليمن بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، فإن تركيا ستتابع عملية صراعات أخرى, حيث ستجد انقرة أرضية مشتركة مع الرياض وحلفائها في القاهرة وابو ظبي … والسماح لليبيين بتسوية نزاعاتهم داخلياً.
وهذه هي إلى حد كبير التوقعات حول الصراعات الدائرة في كلاً من سوريا وأفغانستان واليمن وليبيا التي يشير وضعها إلى أنها لم تعد لديها دوافع وأهداف أو دعم من القوى التي ايقنت بان دعمها لم يؤتي ثمارها.
ومن يشير إلى أن هذه الصراعات ستؤدي حتما إلى طريق السلام؟ فمن الواضح أن هذه التنبؤات تبدو متفائلة جدا، ولكننا لا نرى أي حلول أخرى.
هناك توضيح حقيقي، وسنرى ذلك قريباً جداً، في غضون بضعة أشهر، مع توحيد الطريق السريع M4، الذي سيؤمن للسوريين في إدلب، من جهة، وقوات نظام دمشق التي يجب ألا تعاني بعد الآن من هجمات المتمردين والجهاديين من جهة أخرى.
والمصلحة هي السلام والتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض مع الحالة الجديدة وسيكون الأمر متروكاً لروسيا وتركيا لضمان مسار السلام هذا لسبب بسيط هو أنه إذا تم خرق هذه الاتفاقيات، فإن هذه القوى سيكون لديها الكثير لتخسره.
إن عقد من الحرب على سوريا وزهاء العقدين من الحرب على افغانستان أصبح أكثر من اللازم.
*مجدوب حامد: مؤلف وباحث مستقل في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية والمستقبلية.
* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.