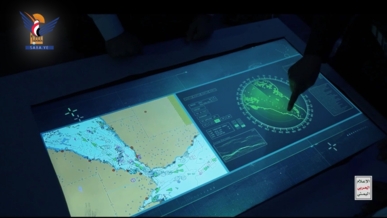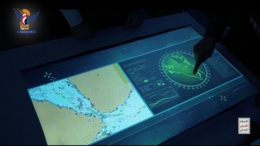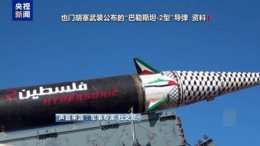في مقدمات التطبيع “الإبراهيمي”: المسار الخليجي
يتيح الاختراق التطبيعي للكيان الصهيوني أن يلعب على تناقضات الوضع العربي، وأن يوسع هامش مناورته سياسياً من خلال التالي.
إبراهيم علوش*
مثّلت اتفاقية أوسلو عام 1993 “ثغرة دفرسوار” كبرى أحدثها نهج كامب ديفيد، أي نهج “السلام المنفرد”، في جدار المقاطعة العربية والدولية للكيان الصهيوني، ليطوق عبرها القضية الفلسطينية من الخلف، في معاقل تأييدها التاريخية في الوطن العربي والعالم الإسلامي وحول العالم.
وانتشر، بذريعة أوسلو، أي ذريعة “نقبل بما يقبل به الفلسطينيون” و”لا يمكن أن نكون أكثر ملكيةً من الملك”، سرطان التطبيع مع العدو الصهيوني عربياً على شكل علاقات تجارية ومكاتب تمثيل في عددٍ من الأقطار العربية، فضلاً عن معاهدة وادي عربة عام 1994 وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة وسفارة للعدو في موريتانيا عام 1999.
من البديهي أن إعادة قولبة الصراع اصطلاحياً، وبالتالي مفاهيمياً، باعتباره “نزاعاً فلسطينياً-إسرائيلياً”، لا صراعاً عربياً-صهيونياً، وباعتباره صراع حدود، كما زعموا، لا وجود، جعلت تمرير ذريعة أوسلو تطبيعياً أكثر استساغةً، كما جعلت الخطر الصهيوني على المنطقة ككل، في الدول العربية والإسلامية وأبعد، أقل مثولاً وبشاعةً. أما خطر التطبيع ذاته، فجعله مثل ذلك المنظور المبتسر، الإقليمي أو القُطري، للصراع، “مسألة خلافية” أو “تحتمل النقاش”!
المدخل القَطَري إلى الخليج
كانت قطر في التسعينيات رأس “ثغرة دفرسوار” التطبيع الرسمي العربي في الخليج العربي، بعيداً عن دولتي الطوق، مصر والأردن، اللتين أقامتا علاقات دبلوماسية كاملة مع العدو الصهيوني.
وعلى الرغم من أن “فتحة العداد” بدأت خليجياً بزيارة لرئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين إلى عُمان عام 1994، وهي زيارة تخللتها مباحثات حول “التعاون في مجال المياه”، وتبعتها زيارة لوزير الخارجية العماني آنذاك، يوسف بن علوي، إلى القدس المحتلة عام 1995، بعد اغتيال رابين، فإن المسار الرئيسي للعلاقات التطبيعية خليجياً دُشن في الدوحة بتأسيس ممثلية تجارية للكيان الصهيوني عام 1995، ولم يجرِ تأسيس ممثلية تجارية مماثلة في عُمان إلا في بداية عام 1996.
وثمة خلط في بعض مواقع الإنترنت حول من – قطر أم عُمان – افتتح ممثلية تجارية صهيونية أولاً، لأن ممثلية الدوحة افتتحها رسمياً شمعون بيريز، رئيس وزراء الكيان الصهيوني آنذاك، عام 1996، لكنها كانت قد تأسست عام 1995، كما يشير عدد كبير من المواقع الصهيونية والغربية بوضوح.
ولعل العلامة الأبرز على الدور “الرائد” الذي أدته قطر في التسعينيات تطبيعياً تتمثل باستضافتها المؤتمر الاقتصادي “الشرق أوسطي” الرابع في تشرين الثاني/نوفمبر 1997، بعد مؤتمرات الدار البيضاء (1994)، وعمان (1995)، والقاهرة (1996)، وهو المؤتمر الذي قاطعته سوريا ومصر والسعودية وقتها وأغلب الدول العربية. أما تلك التي حضرت، مثل السلطة الفلسطينية والأردن وموريتانيا وعُمان وتونس، فقد شاركت بتمثيل منخفض المستوى. وكانت أكبر الوفود المشاركة، وأعلاها مستوى، هي القطرية والأميركية والصهيونية.
وكان ذلك المؤتمر، بالمناسبة، خاتمة المؤتمرات الاقتصادية “الشرق أوسطية”، ونقطة تحول مهمة أظهرت انسداد الأفق التطبيعي في المشهد الرسمي العربي، مع انكشاف مشروع “الشرق أوسطية” على الملأ كمشروعٍ لـ: أ – محو هوية المنطقة، ب – تفكيكها.
ومن الطبيعي أن سوريا كان لها قصب السبق في وضع حدٍ لمثل ذلك المشروع، وفي تأمين حاضنةٍ وغطاءٍ سياسي للمقاومة في لبنان وفلسطين، ما أسهم في كبح جماح الاختراق التطبيعي إلى حدٍ كبير، وفي تعديل ميزان القوى استراتيجياً ضد الكيان الصهيوني، وصولاً إلى تحرير جنوب لبنان عام 2000، الذي مررنا بذكراه المباركة الـ22 قبل أيام، وانطلاق انتفاضة عام 2000 أيضاً في فلسطين (أقترح أن من غير المناسب تسميتها “الانتفاضة الثانية”، لأن انتفاضة عام 1987 لم تكن الأولى في فلسطين، إذ عاش الشعب العربي الفلسطيني سلسلة طويلة من الانتفاضات، ولكم أن تعودوا مثلاً إلى انتفاضة البراق عام 1929، والأفضل أن نسمي تلك الانتفاضات بالعام الذي وقعت فيه، أو بمسمى محدد مثل “انتفاضة الحجارة” أو “انتفاضة الأقصى”…).
والحقيقة هي أن تلك الانتفاضات، والمقاومة عموماً، أدت دوراً مباشراً في إغلاق المكاتب التجارية الصهيونية (على الأقل اسمياً) في قطر وعُمان وتونس والمغرب. وما لم يغلق وقتها، أغلق مع العدوان على غزة عام 2009، كما حدث في نواكشوط. فكما أن التطبيع سرطان، فإن مقاومة التطبيع هي كريات الدم البيضاء. أما الصدام المسلح مع الاحتلال، فهو العلاج الكيماوي. ومع ذلك، فإن سرطان التطبيع خبيث وقد يبقى كامناً، ولا بد من أن نبقى له بالمرصاد.
التطبيع القطري: باقٍ ويتمدد
بالعودة إلى دور قطر في التسعينيات، ثمة تقارير إعلامية عديدة من تلك المرحلة عن صفقات بيع الكيان الصهيوني غازاً قطرياً، ليس من الواضح مكان وصولها وحجمها، وصولاً إلى عروض قطرية لبيع الغاز للكيان الصهيوني في مستهل “الربيع العربي”، بحسب “يديعوت أحرونوت” في أيار/مايو 2011.
وعلى الرغم من الإعلان عن إغلاق الممثلية التجارية الصهيونية في قطر عام 2000، عشية المؤتمر الإسلامي في الدوحة، فإن من الواضح أن العلاقات التطبيعية استمرت وتصاعدت، وصولاً إلى إعلان قطر، مجدداً، قطع العلاقات (المقطوعة؟) عام 2009، عشية العدوان على غزة. ومع ذلك، فإن العلاقات التطبيعية استمرت حتى يومنا هذا، كما سنرى.
في بداية عام 2007، أجرى شمعون بيريز زيارة شهيرة إلى الدوحة. وفي بداية عام 2008، في دافوس – سويسرا، أجرى وزير الحرب الصهيوني آنذاك إيهود باراك لقاءً مع رئيس الوزراء القطري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، ما تزال تفاصيله غير معروفة حتى اليوم، وهو لقاء تبعته زيارةٌ لمسؤولٍ قطري كبير، بحسب “يديعوت أحرونوت” في 2/3/2008 إلى الكيان الصهيوني. وفي نيسان/أبريل من عام 2008، زارت تسيبي ليفني، وزير خارجية الكيان الصهيوني آنذاك، الدوحة، حيث شاركت رسمياً في مؤتمر دولي، وأجرت عدة لقاءاتٍ على أعلى المستويات.
وفي خضم ما يسمى “الربيع العربي” في حزيران/يونيو 2015، استضافت الدوحة محادثات بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين من “حماس” لمناقشة هدنة مدتها 5 سنوات بين الطرفين، بحسب تقرير لصحيفة “تلغراف” البريطانية في 15/6/2015. وما تزال غزة، وتقديم الدعم لها، المدخل المعلن لعلاقات الدوحة التطبيعية مع الكيان الصهيوني من خارج سياق الاتفاقيات “الإبراهيمية” التي لم تنضم إليها رسمياً، إنما يخطئ من يظن أن علاقات قطر التطبيعية تنحصر بغزة.
والعجيب أن محمد العمادي، سفير قطر غير الرسمي إلى الكيان الصهيوني فعلياً، يزور المسجد الأقصى بفيزا إسرائيلية، تماماً كما يفعل وزير الخارجية التركي مولود أوغلو فلا يُعد ذلك تطبيعاً. أما إن فعلها من هو خارج المحور القطري-التركي-الإخواني، فهو مطبعٌ كبير بالضرورة. وكل من يدخل فلسطين بموافقة صهيونية مطبعٌ بطبيعة الحال، وكل تطبيع مدان.
المعلن في العلاقات التجارية بين قطر والكيان الصهيوني، المستمرة والمتواصلة، خلال العقد الأخير مثلاً، لا يتجاوز مليون دولار سنوياً، وهو يشبه قرشاً أو فلساً واحداً بالنسبة إلى قطر التي بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 190 مليار دولار عام 2021، والكيان الصهيوني الذي بلغ ناتجه المحلي الإجمالي 400 مليار دولار في العام ذاته.
ولكنْ ثمة بنود غريبة تظهر أنها البنود الرئيسية في تلك الإحصاءات المعلنة، مثل: “بلاستيكيات” بقيمة 94 ألف دولار عام 2020، و”أثاث” بقيمة 18 ألف دولار عام 2018، و”آلات، ومفاعلات نووية، وبويلرات” بقيمة 52 ألف دولار عام 2013، و”ورق” بقيمة 4 آلاف دولار عام 2011… وهذه صادرات “إسرائيلية” إلى قطر بالمناسبة، لكي لا يظنن أحدٌ أنها مساعدات قطرية إلى غزة مثلاً عن طريق الكيان الصهيوني.
في المقابل، تظهر الإحصاءات ذاتها صادرات قطرية إلى الكيان الصهيوني من نوع: “بلاستيكيات” بقيمة 353 ألف دولار عام 2013، و”ألعاب” بقيمة ألفي دولار عام 2012، و”معدات كهربائية وإلكترونية” بقيمة ألفي دولار عام 2012… (المصدر: موقع Trading Economics، الذي يستند إلى إحصاءات الأمم المتحدة الرسمية، تحت عنوان “الصادرات والواردات بين “إسرائيل” وقطر”، بالإنكليزية).
ثمة تدفقٌ للصادرات والواردات بين قطر والكيان الصهيوني، إذاً، لكننا لا نعرف حجمه وطبيعته فعلياً، وهو ما يدعو للشك في أن خلف الأكمة ما وراءها، ولكنْ لنفترض أقصى حسن نية، وأن قطر تشتري منتجات إسرائيلية وتحولها كـ”مساعدات عينية” إلى غزة عبر معبر “إيريز”، فهو أمر بحاجة إلى وقفة بحد ذاته من ناحية منطقية الإحصاءات. ومن ناحية سياسية، فإن ما لا يمكن تغطية أبعاده بأرقام مزورة هو التطبيع غير الاقتصادي. على سبيل المثال، يذكر موقع “إسرائيلي” أن الدوحة سهلت مرور نحو 60 يهودياً يمنياً إلى الكيان الصهيوني في نهاية عام 2013.
على صعيدٍ آخر، كان التطبيع الرياضي شرطاً مسبقاً منذ عام 2009 لاستضافة قطر لكأس العالم في كرة القدم في خريف العام الجاري (فيما تستبعد روسيا منه). والآن، يجري الحديث عن آلاف مؤلفة من الإسرائيليين ممن يرغبون في مشاهدة المباريات، لا عن إمكانية مشاركة فريق إسرائيلي فحسب. وفي عام 2014، شارك إسرائيليون في مباريات كأس العالم للسباحة في قطر.
وفي عام 2016، شارك إسرائيليون في مباريات الكرة الطائرة في قطر. وفي عام 2018، شارك إسرائيلي في مباريات كرة المضرب في قطر. وفي عام 2018، شارك إسرائيليون في مباريات ألعاب القوى في قطر. وفي آذار/مارس 2019، تم عزف النشيد الاحتلالي الإسرائيلي في الدوحة بمناسبة فوز لاعب صهيوني في إحدى مباريات ألعاب القوى.
وكان فريق إسرائيلي قد شارك في تلك المباريات. وفي كانون الثاني/يناير 2021، شارك إسرائيليون في مباريات الجودو العالمية في الدوحة. وفي حزيران/يونيو 2021، نال لاعب إسرائيلي ميدالية ذهبية في مباريات ألعاب القوى في الدوحة، لكنّ كل هذا مجرد ملاحظة تطبيعية على الهامش، وستكون لنا عودة، إنما أردنا الإشارة إلى أن التطبيع القطري لا علاقة له بذريعة فك الحصار عن غزة.
الحصان الإماراتي يتقدَّم في سباق التطبيع
يتيح الاختراق التطبيعي للكيان الصهيوني أن يلعب على تناقضات الوضع العربي، وأن يوسع هامش مناورته سياسياً من خلال: أ – جعل التطبيع السابق موطئ قدم للتطبيع اللاحق، ب – توظيف الصراعات العربية العربية لزيادة حجم الاختراق التطبيعي وتحقيق مكاسب أكبر من جميع الأطراف.
فكما استغلّ العدو الصهيوني أوسلو ليهمّش موقّعيه، وكما استغلّ وادي عربة ليتجاوز الوصاية الهاشمية على القدس المنصوص عليها في المعاهدة، من خلال الاتفاقيات “الإبراهيمية”، وما يُسمى “صفقة القرن”، كذلك يستغلّ معاهدته مع مصر ليخترق السعودية تطبيعياً تحت عنوان “تعديل الترتيبات الدولية بشأن جزيرتي تيران وصنافير”، وهو ما استدعى مباحثات سعودية – إسرائيلية مباشرة مؤخراً برعاية أميركية، بحسب “هآرتس” في 29/5/2022، الأمر الذي يعني أن نقل السيادة على تيران وصنافير من مصر إلى السعودية أصبح اليوم عنواناً تطبيعياً بحد ذاته، لا مسألة عربية داخلية.
كذلك، استغلّ الكيان الصهيوني قطر تطبيعياً، ولا يزال، ولكن عندما اشتعل الصراع بين قطر من جهة، ومجموعة من أخواتها العربيات الخليجيات من جهةٍ أخرى، وجد الفرصة سانحةً ليحقق اختراقاً تطبيعياً أكبر عبر الإمارات في الدرجة الأولى، ثم عبر البحرين، فمال مع تحالف السعودية-الإمارات، ثم راح يفاوض قطر عبر القنوات الخلفية.
يُذكر في هذا السياق أنَّ موقع “Huffpost” نشر تقريراً في 12/9/2016 تحت عنوان “إسرائيل تعزز علاقاتها مع ممالك الخليج”، يتحدَّث عن اتصالات سرية مكثّفة بين كلّ من الكيان الصهيوني من جهة، والسعودية والإمارات وقطر من جهةٍ أخرى، كلٌّ على حدة.
جاء التطبيع الإماراتي متأخراً عن التطبيع القطري، وظلَّ يجري على استحياء لسنوات، ولكنه أضحى اليوم التطبيع الأكثر تسارعاً والأوسع نطاقاً والأكثر تفاعلاً مع الكيان الصهيوني في الوطن العربي. وبعيداً عن الخطاب المنافق، تبقى تركيا هي الأكثر تطبيعاً في المحيط الإسلامي، لكنّ التطبيع الإماراتي فتح بواباتٍ واسعة على الاقتصاد العربي تحديداً، لا مجرد “ثغرة دفرسوار” أخرى أو اختراقات.
يُذكر أنّ الاقتصاد الإماراتي هو ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد الاقتصاد السعودي، يليهما الاقتصاد المصري. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي عام 2021 نحو 400 مليار دولار، تماماً كالاقتصاد الإسرائيلي.
بدأت العلاقات العلنية الإماراتية – الإسرائيلية عام 2015 بافتتاح بعثة دبلوماسية إسرائيلية رسمية في أبو ظبي. وكان العنوان الرسمي لتلك البعثة هو تمثيل “إسرائيل” في “الوكالة الدولية للطاقة المتجددة” التي اتخذت من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.
وكانت الموافقة على استقبال البعثة الإسرائيلية علانيةً في الإمارات هو الشرط الموضوع على طاولة الإمارات لافتتاح مقر “الوكالة الدولية للطاقة المتجددة” في الإمارات بدلاً من ألمانيا. وهكذا كان طبعاً، ولكنّ البعثة الإسرائيلية في أبو ظبي لم تشتغل بشؤون الطاقة فحسب، بل شكلت اختراقاً تطبيعياً أو موطئ قدمٍ تحول إلى سفارة إسرائيلية كاملة في أبو ظبي في 24/1/2021، افتتحها رسمياً وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي، يائير لابيد، في 29/6/2021.
تسريبات إعلامية عن العلاقات السرية بين “إسرائيل” والإمارات
لم تهبط البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية كنيزكٍ من الفضاء عام 2015، إذ سبقتها سلسلة لقاءات واتصالات بالضرورة، وهذا ليس مجرد استنتاجٍ يمليه المنطق العادي، بل أكدته التسريبات التي لا يكفّ الصهاينة عن تمريرها عن علاقاتهم السرية، كما هو دأبهم عادةً؛ فصحيفة “هآرتس”، في 25/7/2017، سربت قصة لقاءٍ جرى بين رئيس الوزراء السابق نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي في نيويورك عام 2012، لكن هذا اللقاء لم يأتِ بلا مقدمات.
سربت مجلة “نيويوركر” الأميركية، في 16/6/2018، أن اللقاءات الأولى بين الإمارات و”إسرائيل” جرت في العاصمة الأميركية، واشنطن دي سي، بعد توقيع اتفاقية أوسلو مباشرة عام 1993، برعاية إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون خلال ولايته الأولى. وأضاف تقرير المجلة ذاتها أنَّ مركز أبحاث في أبو ظبي، اسمه “مركز الإمارات للأبحاث والدراسات الاستراتيجية”، أصبح منذ عام 1994 قناة الاتصال غير الرسمية مع “إسرائيل”.
منذ ذلك الوقت، بدأت الزيارات شبه المنتظمة لشخصيات يهودية أميركية متصلة بالحركة الصهيونية إلى الإمارات للقاء مسؤوليها. ومن ديناميكيات تلك اللقاءات، نشأت العلاقات الأمنية بين الطرفين اللذين بدآ تشاطر المعلومات بينهما. وبعد تنصيب أوباما رئيساً للولايات المتحدة الأميركية عام 2009، بدأ التعاون السياسي المباشر بين الإمارات و”إسرائيل” تحت عنوان: حشد القوى من أجل “درء الخطر الإيراني”.
كانت قنوات التنسيق السياسي المباشر تلتقي على الأرض الأميركية. اجتمع السفيران الإماراتي والإسرائيلي في الولايات المتحدة بصورة سرية مع مسؤول ملف “الشرق الأوسط” آنذاك، دنيس روس، إياه، في فندق في ضاحية “جورج تاون” من العاصمة الأميركية واشنطن، وطلبا منه أن يوصل دعوتهما المشتركة إلى الرئيس أوباما باسم الإمارات و”إسرائيل” معاً بأن يتخذ موقفاً أكثر تشدداً مع إيران. لم يصغِ أوباما إليهما، كما هو معروف، ومضى في مساعيه للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وهو ما قرَّبهما من بعضهما بصورةٍ أكبر.
لا يستطيع الكيان الصهيوني أن يحترم علاقة سرية أو علنية لأنَّ ذلك من طبيعته، فهو لا يستطيع إلا أن يلعب حتى في ملاعب أقرب حلفائه الغربيين من دون علمهم، فما بالكم بـ”صديقٍ” عربي؟! لذلك، عندما اغتال الموساد الشهيد محمود المبحوح في الإمارات عام 2010، على الرغم مما يفترض أنه علاقات أمنية قوية بين الجانبين، توترت العلاقات بينهما بشدة. وكتعويضٍ عن ذلك التجاوز، طالب الجانب الإماراتي بأن يبيعه الجانب الإسرائيلي طائرات مسيرة مسلّحة كانت إدارة أوباما قد رفضت بيعها له، فردّت “إسرائيل” بأنها لا تستطيع أن تُغضِب الإدارة الأميركية.
جرى تجاوز الخلاف بمرونة حرصاً على المصلحة المشتركة في مواجهة “الخطر الإيراني المحدق” ونزعة أوباما للتفاهم مع إيران، وفيما بعد، اعتراضاً على رفض أوباما التورط عسكرياً بصورةٍ مباشرةٍ في سوريا. المهم، شنّ اللوبي الصهيوني حملةً سياسيةً وإعلاميةً ضاريةً على أوباما في الولايات المتحدة، على الرغم من كل ما قدمه للكيان الصهيوني من دعم سياسي وعسكري واستخباري، واستخدامه الفيتو في مجلس الأمن لمنع إدانة “إسرائيل” على نشاطها الاستيطاني.
وعندما خاطب نتنياهو الكونغرس ومجلس الشيوخ في جلسة مشتركة لهما عام 2015، داعياً إياهما للتصويت ضد الاتفاق النووي مع إيران، لم ينجح نتنياهو، ومرَّ الاتفاق على أية حال، لكنه اختطف عقول بعض الأنظمة الخليجية وقلوبها!
اتخذت العلاقات الصهيونية هنا مع كلٍ من السعودية والإمارات منحنى متصاعداً من جهة، وبعيداً عن عيون إدارة أوباما من جهةٍ أخرى، وهو ما استفزَّها بشدة. وبحسب المعلومات المفرج عنها إعلامياً في العام 2018، اكتشفت الأجهزة الأمنية الأميركية سلسلة اتصالات هاتفية بين “مسؤول إماراتي كبير” ونتنياهو. كما اكتشفت أنَّ لقاءً تم عقده في قبرص بين عددٍ من القيادات الإماراتية والإسرائيلية حضره نتنياهو، وتركز على مواجهة الاتفاق النووي مع إيران.
التقط نتنياهو الفرصة، وبدأ يدفع باتجاه تحويل العلاقات السرية مع الإمارات والسعودية إلى علاقاتٍ علنية مجدداً ضمن اتفاقيات منفردة على نهج كامب ديفيد، وبعيداً عن الموضوع الفلسطيني أو غيره (الجولان، شبعا، غاز المتوسط…)، وهو ما أنتج الاتفاقيات “الإبراهيمية” في المحصلة برعاية إدارة ترامب.
وكان أوباما قد حمل مطلب نتنياهو بإقامة علاقات رسمية مع السعودية خلال زيارته إليها في آذار/مارس عام 2014، ولكنه قوبل بالرفض، ولكنْ أردنا الإشارة أولاً إلى أنَّ فتح البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية إلى “الوكالة الدولية للطاقة المتجددة” في أبو ظبي عام 2015 ولد في تلك اللحظة السياسية. من هنا، إن القول أعلاه إنها بعثةٌ لم تشتغل بـ”الطاقة المتجددة” فحسب لم يكن قولاً إنشائياً. ولعلَّ هدفها كان تعويد الجمهور على وجود مكتب تمثيل إسرائيلي في أبو ظبي، بالتزامن مع تلبية المطلب الإسرائيلي بتحويل العلاقات السرية إلى علاقة علنية.
وكان تقرير لموقع United Press International في 27/1/2012 نشر أن مبيعات الشركات الأمنية الإسرائيلية للإمارات عام 2011 بلغت 300 مليون دولار، وأنَّ العلاقات بين سلطة البنية التحتية في الإمارات والشركات الأمنية الإسرائيلية بدأت منذ عام 2007.
وكان عوزي لانداو، وزير البنية التحتية الإسرائيلية الأسبق، قد زار أبو ظبي وشارك في مؤتمر الطاقة المتجددة في 16/1/2010. وفي 19/1/2016، كشفت القناة الإسرائيلية الثانية أن يوفال شتاينتس، وزير البنية التحتية والطاقة آنذاك، عاد لتوه من أبو ظبي، بعد أن شارك في مؤتمر للطاقة المتجددة هناك. وفي 16/9/2018، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن استضافة أبو ظبي لقاءات سرية بين تركيا والكيان الصهيوني.
وفي 12/5/2018، قبل العلاقات الرسمية وافتتاح السفارات، نشرت “تايمز أوف إسرائيل” تقريراً عن لقاءٍ “عرضي” جمع نتنياهو بالسفير الإماراتي يوسف العتيبة في مطعمٍ ترتاده النخبة السياسية في واشنطن، جرى فيه بحث الموضوع الإيراني قبل تاريخ النشر بشهرين تقريباً.
وفي 11/10/2018، شوهد السفيران الإماراتي والإسرائيلي في واشنطن، وهما يتشاركان طاولة واحدة، ويتجاذبان أطراف الحديث، في عشاءٍ سنويٍ أقامته إحدى منظمات اللوبي الصهيوني في العاصمة الأميركية واشنطن. ومن البديهي أنَّ هذا أيضاً جاء في سياق إخراج السر إلى العلن. وفي 25/4/2019، أعلن الكيان الصهيوني أنه تلقى دعوة رسمية للمشاركة في معرض “أكسبو 2020” في دبي.
وفي 13/8/2020، نشر الإعلان الأميركي – الإسرائيلي – الإماراتي المشترك عن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني، وكان ذلك هو الاختراق السياسي التطبيعي الأهم في الجدار الرسمي العربي منذ توقيع اتفاقية وادي عربة في العام 1994.
ونشرت “تايمز أوف إسرائيل” في اليوم التالي لذلك الإعلان أنَّ يوسي كوهين، المدير السابق للموساد، زار الإمارات مراراً على مدى عام للتفاوض على الاتفاق الذي عُرف باسم “الاتفاقات الإبراهيمية”. وبانضمام البحرين إلى تلك الاتفاقات، تم التوقيع عليها رسمياً في حديقة البيت الأبيض في واشنطن في 15/9/2020. وسرعان ما انضم السودان إلى “الاتفاقات الإبراهيمية” في 23/10/2020، ووقع عليها رسمياً في الخرطوم في 21/1/2021.
ومع ذلك، إنَّ قطار العلاقات مع الكيان الصهيوني ما برح يسير بسرعة أبطأ كثيراً من سرعته في الدول الخليجية أو في المغرب الذي أعلن انضمامه إلى “الاتفاقات الإبراهيمية” في 10/12/2020، وهو ما تبعه اتفاق مباشر مع الكيان الصهيوني لتطبيع العلاقات في المجالات المختلفة في 22/12/2020. وبهذا، انفتحت أبواب التطبيع على مصراعيها من خلال اختراقين كبيرين: أولهما في أقصى المشرق العربي في الإمارات، وثانيهما في أقصى المغرب العربي في المغرب.
عندما تصبح “الاتفاقات الإبراهيمية” موطئ قدم لزيادة الاختراق التطبيعي خارجها
في 13/12/2021، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الإمارات العربية المتحدة، وعقد لقاءاتٍ رسمية على أعلى المستويات فيها. ولعل تلك الزيارة أبعدت الضوء عن اتفاق تجاري مهم توصَّلت إليه قطر و”إسرائيل” في الفترة ذاتها: الاتفاق حول تجارة الألماس.
خلاصة القصّة أنَّ قطر أرادت، قبل بضع سنوات، أن تصبح طرفاً في تجارة الألماس العالمية، وأن تؤسّس منطقة حرة وبورصة خاصّة بها لتجارة الألماس، لكنّ “جمعية بورصات الألماس العالمية” التي تملك فيها “إسرائيل” نفوذاً كبيراً، بوصفها طرفاً رئيسياً في تجارة الألماس الدولية، منعت قطر من الدخول على الخط. وانضمت الإمارات إلى “إسرائيل” في ممارسة حق النقض على دخول قطر إلى ملعب الألماس العالمي، مع العلم أنَّ الطرفين ينسقان استراتيجياً على هذا الصعيد.
تبع ذلك اتصالات سرية مباشرة قطرية – إسرائيلية وافقت فيها قطر على شروط الكيان الصهيوني كافةً: أي تاجر ألماس إسرائيلي يستطيع أن يحصل على فيزا قطرية خلال 5 أيام في الحد الأقصى، وأن يتاجر ويشتغل كما يشاء في بورصة الألماس القطرية والمنطقة الحرة للمجوهرات، من دون أي قيود، وأن يؤسس “مكاتب تمثيلية” في قطر لهذا الغرض إذا رغب. وقد تم توقيع الاتفاق رسمياً بين مسؤولين كبار في وزارتي الخارجية في قطر و”إسرائيل”، بحسب موقع “غلوبس” (Globes) في 25/11/2021.
وهكذا، رفع الكيان الصهيوني تحفظه عن دخول قطر على الخط، وكذلك فعلت الإمارات! ونرجو ألا يقول أحدٌ إن قطر وقعت ذلك الاتفاق من أجل غزة، وها هي الخطوات تجري على قدمٍ وساق لتأسيس موطئ قدم لقطر في سوق المجوهرات والمعادن الثمينة العالمية أسوةً بدبي. المهم هو كيف نتنافس مع بعضنا بعضاً في ملاعب أعدائنا.
* المصدر :الميادين نت