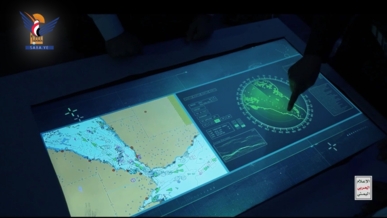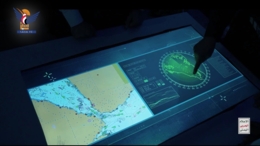السلاح أهم من حقوق الإنسان ..!
كيف ناقضت دول كبرى نفسها بدعم حكومات عربية على حساب مبادئها!؟
السياسية:
كان هذا ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يتسلم منصبه رسمياً، لكن الأيام والأحداث كشفت أن “التصريحات” في وادٍ بينما الأفعال في وادٍ آخر وبينهما مسافات أبعد مما بين الأرض والسماء.
وقبل أكثر من 73 عاماً أصبح العاشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام يوماً للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والفكرة أيضاً كانت غربية بقيادة أمريكية، وباتت حقوق الإنسان والاعتبارات الأخلاقية هي المعيار الأساسي الذي تقوم عليه “حضارتنا الغربية”، بحسب الساسة والزعماء وقادة الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام، لكن “الكلام” أسهل كثيراً من الأفعال.
وكان تصريح بايدن الشهير: “لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل” نموذجاً صارخاً على أن المصالح أهم كثيراً من المبادئ، فديكتاتور ترامب المفضل “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي” لم يغير شيئاً من سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان، ورغم ذلك استمرت “الشيكات على بياض” من إدارة بايدن كما كانت أيام إدارة ترامب.
وقبل أن يتولى منصبه وعد بايدن أن يجعل السعودية “دولة منبوذة” بسبب جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والتي أشارت أصابع الاتهام الأمريكية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفسه في تلك الجريمة البشعة، لكن بعد أن أصبح رئيساً توقفت “التصريحات” وبدأت “الأفعال” وشتان بين هذه وتلك.
وبالنسبة لاضطهاد الصين لأقلية الإيغور المسلمة، والتي وعد بايدن بأن يجعلها قضية أساسية بعد أن وصلت الأمور إلى حد التطهير العرقي (توصيفات غربية)، لم يفعل بايدن شيئاً أيضاً.
* ألمانيا وصفقات السلاح لمصر والسعودية
“لن يكون هناك استثناءات للسياسة التقييدية لصادرات الأسلحة الألمانية إلا في حالات فردية مُبررة، وعقب مراجعة دقيقة. وأوضاع حقوق الإنسان سيكون لها دور مهم في هذا الشأن”، أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، كانت بهذا الوضوح خلال زيارتها الأولى إلى القاهرة، وكان نظيرها المصري سامح شكري بجوارها في مؤتمر صحفي مشترك.
والسبب في هذه التصريحات القوية والمباشرة هو أن مصر خلال السنوات الثلاث الماضية أصبحت على رأس قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية، وهو ما أثار انتقادات حادة من جانب المنظمات الحقوقية وسياسيين ألمان معارضين، فأرادت بيربوك أن تطمئن الجميع أنه من الآن وصاعداً سيكون “احترام حقوق الإنسان” شرطاً رئيسياً لإتمام مبيعات الأسلحة.
ورغم أن ألمانيا لم تكن من الدول المعروف عنها تصديرها للسلاح بصورة مؤثرة، أو على الأقل لا تقارن بالولايات المتحدة أو فرنسا أو الصين أو روسيا مثلاً، فإن مبيعات الأسلحة الألمانية مؤخراً ارتفعت إلى مستويات قياسية، وجاءت دول في الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر والسعودية على رأس قائمة المشترين، وهو ما أثار انتقادات حادة في برلين وجهت نحو حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل ووضعت الحكومة الجديدة تحت دائرة الضوء.
ففي تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، اتضح أن صادرات الأسلحة الألمانية تجاوزت قيمتها 9 مليارات يورو، وهو رقم غير مسبوق على الإطلاق. واشترت مصر وحدها أسلحة ألمانية بقيمة تجاوزت أكثر من 4.3 مليار يورو، أي تقريباً نصف ما صدرته ألمانيا، وتلتها السعودية في قائمة المشترين.
وأثارت هذه التقارير مطالب بوقف تصدير السلاح إلى مصر والسعودية فوراً، وقال أوميد نوربيبور، رئيس حزب الخضر بالشراكة، إنه “لا ينبغي أن تكون هناك صادرات أسلحة إلى مصر والسعودية نظراً للسياسات الإشكالية لكلا البلدين”.
وقال نوربيبور في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية نقلها موقع دويتش فيله: “لا ينبغي أن تكون هناك صادرات أسلحة ألمانية إلى مصر والسعودية؛ نظراً للسياسات الإشكالية لكلا البلدين”.
“في مصر هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي، وقد تم بناء عدد من السجون الجديدة لهم. في الصراع الليبي انتهكت مصر مراراً اتفاقيات المجتمع الدولي- بما في ذلك توريد أسلحة ولوجستيات عسكرية”، بحسب ما قاله نوريبور لوكالة الأنباء الألمانية.
أما بالنسبة للسعودية، فهناك حظر أسلحة صادر منذ عام 2018 عن البرلمان الألماني والبرلمان الأوروبي، وقرار الأخير ملزم لجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، على خلفية قضية اغتيال خاشقجي والحرب في اليمن، مما يثير الاستغراب بشأن كيفية صدور تراخيص من حكومة ميركل بتلك المبيعات من الأسلحة للسعودية وأيضاً لمصر.
فمصر، مثل العديد من الدول العربية الأخرى، جزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، حتى وإن كانت مشاركة بعض الدول لا يتم تسليط الضوء عليها إعلامياً لأسباب متعددة.
وقد يرى البعض أن الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا سيكون لها موقف أكثر صرامة في مجال الدفاع عن “القيم الغربية” وتقديم الاعتبارات الأخلاقية على المصالح الاقتصادية، قياساً على تصريحات وزيرة الخارجية بيربوك الصادرة من القاهرة، لكن التصريحات الوردية بشأن حقوق الإنسان كانت أيضاً تتصدر المشهد طوال السنوات الماضية.
فخلال أول زيارة لعبد الفتاح السيسي بعد أن أصبح الرئيس المصري، وكان ذلك في مارس/آذار 2015، ألغى رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت اجتماعاً مع السيسي كان مخططاً له من قبل، لكنه أكد لامرت أنه لم يعارض الدعوة التي وجهتها الحكومة الألمانية إلى السيسي لزيارة ألمانيا لسبب وجيه: “من المرغوب والضروري أن يكون هناك اتصال وثيق للحكومة الألمانية مع حكومة دولة مهمة في منطقة مهمة”.
وخلال زيارة أخرى للسيسي إلى ألمانيا عام 2018، ناشدت منظمة العفو الدولية ميركل أن تمارس “ضغوطاً حقيقية” على الرئيس المصري بشأن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين والاختفاء القسري لنشطاء وقوانين مكافحة الإرهاب المطاطة في صياغاتها والتي تستخدم لتكميم الأفواه وسجن المعارضين السياسيين أو حتى المواطنين الذين يعبرون عن سخطهم من قسوة الظروف الاقتصادية.
وصدرت بيانات رسمية تؤكد أن المستشارة الألمانية “ناقشت ملف حقوق الإنسان” مع الرئيس المصري وأعادت التأكيد على أن تطور العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة وبرلين مرتبط بشكل مباشر بملف حقوق الإنسان.
وها هي ميركل غادرت منصبها واتضح بعد أربع سنوات أن التصريحات الوردية بشأن حقوق الإنسان لم تتوقف يوماً، كما أن مبيعات الأسلحة والصفقات الاقتصادية لم تتوقف أيضاً، بل ازدادت لتصل إلى أرقام غير مسبوقة. وبالتالي فإن تصريحات وزيرة الخارجية الحالية من القاهرة قد لا تعني شيئاً أيضاً. وكما قال رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية محمود رفعت لموقع دويتش فيله: “للأسف المصالح الاقتصادية تطغى على الاعتبارات الأخلاقية”.
* بايدن: “حقوق الإنسان أهم ما يعنينا”
كان الرئيس الديمقراطي، ولا يزال في حقيقة الأمر، يرفع لواء الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم منذ حملته الانتخابية في مواجهة سلفه الجمهوري دونالد ترامب، الذي كان لا يخفي إعجابه بالزعماء الديكتاتوريين حول العالم، من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الروسي فلاديمير بوتين، إلى الرئيس المصري الذي ناداه ترامب ذات مرة قائلاً: “أين ديكتاتوري المفضل؟”.
وفي مقابل فجاجة تصريحات ترامب وعدم اكتراثه بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، كان بايدن، ولا يزال، لا يتحدث تقريباً إلا واستهل تصريحاته بالحديث عن “القيم الغربية” والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكيف أن أمريكا– في عهده– قد عادت إلى دورها في قيادة المعسكر الديمقراطي المدافع عن حقوق الإنسان حول العالم.
بايدن، وقبل حتى أن يتولى منصبه رسمياً، قال إن “حقوق الإنسان سوف تكون جوهر علاقات أمريكا الخارجية مع دول العالم”، لكن بعد أكثر من عام في البيت الأبيض اتضح أن الرئيس الأمريكي يقول “كلاماً كبيراً فيما يخص حقوق الإنسان لكن أفعاله نفسها لا ترقى لذلك الكلام الكبير”، بحسب تحليل لمجلة Business Insider الأمريكية بعد 100 يوم من رئاسة جو بايدن.
“الأمر إشكالي بصورة ضخمة، من وجهة نظري، إن لم يكن خطيراً أيضاً. فأن تعترف علناً بأن شخصاً ما مذنب ثم تقول لذلك الشخص إنك لن تعاقبه وتطلب منه أن يواصل عمله كأنك لم تقل شيئاً، فتلك دعوة صريحة لأن يعيد ارتكاب جريمته مرة أخرى”، كان هذا تعليق أغنيس كالامار الرئيسة الجديدة لمنظمة العفو الدولية، والتي تولت منصبها العام الماضي بعد أن كانت تتولى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأجرت تحقيقاً دولياً في جريمة مقتل خاشقجي.
تعليق كالامار يخص كشف إدارة بايدن عن تقرير استخباراتي أمريكي خلص إلى توجيه اتهام لولي العهد السعودي بالمسؤولية عن اغتيال خاشقجي، رغم أن ولي العهد ينفي تورطه أو علمه بالجريمة. ورغم قرار إدارة بايدن رفع السرية عن ذلك التقرير، فإن الإدارة الأمريكية أحجمت عن توقيع أي عقوبات على الأمير محمد بن سلمان.
ومع مرور الوقت وتغير الظروف والمصالح، اختفى تماماً حديث حقوق الإنسان وأصبحت لغة المصالح هي التي تتصدر المشهد. فالرئيس الأمريكي أجرى اتصالاً بالملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي، كان محوره الأساسي هو أسعار النفط، التي بات ارتفاعها يمثل كابوساً حقيقياً لبايدن خصوصاً في عام يشهد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وارتفاع أسعار النفط يعني ارتفاع الأسعار واستمرار وتصاعد التضخم الاقتصادي، وهو ما يعني ببساطة مزيداً من الأعباء على غالبية المواطنين الأمريكيين وبالتالي كابوساً سياسياً بامتياز للرئيس الديمقراطي. النتيجة هنا هي تغليب المصالح الاقتصادية على الاعتبارات الأخلاقية فوراً ودون نقاش.
فبايدن لم يتصل بالعاهل السعودي سوى مرتين؛ الاتصال الأول (العام الماضي) جاء في أجواء متوترة للغاية في العلاقة بين واشنطن والرياض، على خلفية الحرب في اليمن وجريمة اغتيال خاشقجي. وكان بايدن قد اتخذ بالفعل عدة قرارات تخص القضيتين واعتبرت عقاباً للسعودية، كوقف الدعم الأمريكي لعمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وإلغاء تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، ورفع السرية عن تقرير استخباراتي أمريكي ألقى بمسؤولية اغتيال خاشقجي على ولي العهد.
أما الاتصال الأخير فجاء في أجواء مختلفة تماماً، فبايدن هو من بادر بالاتصال وكشفت بيانات البيت الأبيض والديوان الملكي السعودي أن الرئيس الأمريكي أكد التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
كما أكدت البيانات الرسمية أن الرئيس الأمريكي أطلع الملك سلمان أيضاً على تطورات المحادثات الدولية الرامية إلى “إعادة فرض قيود على برنامج إيران النووي”، بينما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان أبلغ بايدن “حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن”.
فما الذي تغير في قضية اغتيال خاشقجي تحديداً أو الحرب في اليمن أو ملف حقوق الإنسان في السعودية بشكل عام حتى يحدث ذلك التحول الجذري في موقف الرئيس الأمريكي؟ فالرئيس، الذي وعد أثناء حملته الانتخابية بأن يحول السعودية إلى “دولة منبوذة”، وجد نفسه في ورطة قد لا يخرجه منها سوى السعودية. وبالتالي فإن حقيقة الأمر هنا هي أن السبب الوحيد لذلك الاتصال هو أسعار النفط، التي يريد بايدن من السعودية أن ترفع من إنتاجها كي تساعد على تخفيض الأسعار التي تقترب من 100 دولار للبرميل.
* مبيعات الأسلحة الأمريكية وحقوق الإنسان
أما قصة مبيعات الأسلحة وارتباطها المفترض بملف حقوق الإنسان فهي تستحق التوقف أمامها طويلاً. فمن الناحية القانونية، توجد قوانين وقواعد في الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تجعل من شبه المستحيل- نظرياً- أن تحصل الدول التي لديها سجل سيئ في حقوق الإنسان على صفقات أسلحة.
لكن يبدو أن كلمة السر هنا هي “نظرياً”، لأن الواقع العملي يؤكد أن صفقات الأسلحة لا تتوقف مهما كان ملف حقوق الإنسان قبيحاً ومأساوياً.
فإدارة جو بايدن، التي أعلنت موقفها مراراً وتكراراً من سجل حقوق الإنسان السيئ لدى النظام المصري، وافقت على صفقة صواريخ بقيمة نحو 200 مليون دولار لمصر في فبراير/شباط من العام الماضي، أي بعد أقل من شهر من تولي بايدن منصبه رسمياً.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أخطرت الكونغرس بموافقتها على بيع 12 طائرة نقل “سي-130 جيه سوبر هيركيوليز” تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار وأنظمة رادار للدفاع الجوي SPS-48 بقيمة 355 مليوناً لمصر، رغم تواصل الاعتراضات من جانب مشرعين في الكونغرس وسياسيين ونشطاء حقوقيين.
وخلال سبتمبر/أيلول 2021، اتخذت إدارة بايدن قراراً بتعليق جزء من المساعدات العسكرية للقاهرة، قيمته 130 مليون دولار من أصل 300 مليون، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في مصر، فهل تعني صفقة الأسلحة الشهر الماضي أن القاهرة حققت تقدماً ملحوظاً في سجل حقوق الإنسان؟
الإجابة يمكن قراءتها من أسطر رسالة وجَّهها نواب ديمقراطيون بالكونغرس إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، حثوه فيها على عدم التصديق على أن مصر قد استوفت الشروط اللازمة للإفراج عن المساعدات المعلقة، وبدلاً من ذلك، دعوا الإدارة الأمريكية إلى إعادة برمجة الأموال، أي التصرف فيها وعدم إرسالها لمصر إطلاقاً. باختصار انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال مستمرة.
والتصريحات حول حقوق الإنسان أيضاً لا تزال مستمرة، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنهم (الإدارة الأمريكية) “ما زالوا ملتزمين بالتواصل مع شركائنا المصريين في مجال حقوق الإنسان. أكدنا باستمرار أن علاقتنا الثنائية سوف تتعزز من خلال تحسن ملموس في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
أما الاتهامات الموجهة للحكومة المصرية فتشمل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني أو التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وظروف السجن “القاسية والمهددة للحياة”، والاعتقال التعسفي، وفرض قيود على حرية التعبير والمشاركة السياسية، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مصر.
وربما تكون إقامة إدارة بايدن للحوار الاستراتيجي مع النظام المصري مثالاً صارخاً على هذا التناقض بين “التصريحات” والأفعال بشأن حقوق الإنسان، فذلك الحوار السنوي الذي كان الرئيس الأسبق بيل كلينتون قد أطلقه مع مصر وأوقفه ترامب، يعتبر مكافأة لنظام السيسي من جانب إدارة أمريكية ترفع شعار الحفاظ على حقوق الإنسان، بحسب تحليل أمريكي عنوانه “إدارة بايدن تهين حقوق الإنسان بتقربها من نظام ديكتاتوري في مصر”.
* “الصفقة الملغومة” تحكي الكثير!
الصفقة الملغومة المقصود بها صفقة الأسلحة المتقدمة، التي تضم طائرات إف-35، التي وقعتها إدارة ترامب مع الإمارات قبل مغادرة الرئيس السابق البيت الأبيض بأيام قليلة (كان وقتها قد أصبح نظرياً الرئيس السابق ولم يكن من المفترض أن يوقع صفقة كهذه)، ووعد بايدن بإعادة النظر في تلك الصفقة.
وبالفعل قررت إدارة بايدن في 27 يناير/كانون الثاني 2021 تعليق الصفقة بغرض المراجعة. منظمات حقوق الإنسان والمشرِّعون الديمقراطيون في الكونغرس أشادوا بالقرار ورأوه متسقاً مع رغبة الإدارة الجديدة في إنهاء الحرب في اليمن من جهة ووضع حقوق الإنسان في مركز السياسة الخارجية الأمريكية حول العالم من جهة أخرى.
وسكب الكثير من الحبر إشادة بالقرار، وقيل إن بايدن ليس ترامب.. إلى آخره، لكن حقيقة الأمر أن قرار تعليق الصفقة بغرض المراجعة كان قراراً روتينياً تتخذه أي إدارة جديدة في مثل تلك الحالات. فالصفقة قيمتها 23 مليار دولار وتشمل طائرة الشبح الأولى عالمياً (الإف-35) التي لا تباع في الشرق الأوسط إلا للعدو الاسرائيلي، لكن الإمارات حصلت عليها في إطار اتفاق التطبيع مع العدو.
وحين كان وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يعمل مستشاراً للسياسة الخارجية في حملة بايدن، عبر صراحة عن رفضه للصفقة وقال وقتها في حوار مع صحيفة Times Of Israel للعدو الإسرائيلية إن تل أبيب هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط المسموح لها بامتلاك طائرات إف 35.
لكن إدارة بايدن وافقت على المضي قدماً في إتمام الصفقة وكذلك فعل الكونغرس، لنتفاجأ جميعا أن أبوظبي هي من هددت بالانسحاب من الصفقة، وأبلغت واشنطن فعلاً بذلك القرار منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، والسبب هو طلبات أمريكية خلال المفاوضات تتعلق بوجود شركة هواوي الصينية في الدولة الخليجية!
القصة إذاً لم تكن أبداً حقوق الإنسان أو الحرب في اليمن، والتي تسببت في أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم في العصر الحديث، ولا حتى ضمان تفوق العدو الإسرائيلي في المجال العسكري (ودولة العدو الإسرائيلي هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك سلاحاً نووياً، أي أن تفوقها ليس محل شك)، لكنها دائماً وأبداً قصة المصالح التي تتحكم في سياسات واشنطن في المنطقة وحول العالم.
فإذا كانت إدارة ترامب هي التي وقعت صفقة الأسلحة الضخمة مع الإمارات، كجزء من صفقة التطبيع التي كانت جزءاً من صفقة القرن (الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية تماماً كما كان يحلم ترامب)، فإن إدارة بايدن أرادت، ولا تزال تريد بالطبع، أن تحقق هي الأخرى مصلحة ما تخصها وتصب في صالحها من خلال نفس الصفقة. وليكن العنوان “حقوق الإنسان” ودور الإمارات المزعزع لاستقرار المنطقة، لكن التفاصيل العملية قد تكون ورقة ضغط في الحرب الباردة مع الصين أو الحصول على امتيازات في ملف آخر، لكن الصفقة نفسها ماضية في طريقها.
* أوروبا و”نفاق” حقوق الإنسان!
وإذا تركنا واشنطن وإدارة بايدن مؤقتاً وعبرنا المحيط الأطلنطي إلى القارة العجوز أو أوروبا، التي يفاخر قادتها بأنهم حماة الديمقراطية والمدافعون عن حقوق الإنسان حول العالم، لوجدنا أمثلة صارخة على أن المصالح الاقتصادية أكثر أهمية من حقوق الإنسان فعلاً لا قولاً.
وهذه القصة استحقت أن تصبح رسالة دكتوراه أعدتها الباحثة السويدية صوفيا هيلستروم بجامعة أبسالا في السويد، وعنوان الرسالة “حقوق الإنسان مقابل المصالح الاقتصادية- دراسة نوعية حول النفاق التنظيمي داخل الاتحاد الأوروبي”، رصدت كيف أن تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن حقوق الإنسان لا علاقة لها في الحقيقة بالقرارات الاقتصادية وصفقات الأسلحة التي تعقدها حكومات الدول الأوروبية مع دول تتهمها نفس الحكومات علناً بأنها لا تحترم حقوق الإنسان.
وخلال فبراير/شباط 2022، وجّه 175 سياسياً من 13 دولة أوروبية، وهم أعضاء في البرلمان الأوروبي أو برلمانات دول أوروبية، رسالة مفتوحة موجهة إلى وزراء خارجية دولهم، وكذلك إلى سفراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يطالبون فيها بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل أكبر.
الرسالة المفتوحة تطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته خلال مارس/آذار 2022، بإنشاء آلية خاصة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في مصر والإبلاغ عنها في مصر، وذلك من قبل مندوبي الدول الأعضاء في المجلس والبالغ عددها حالياً 47 دولة.
ورصدت الرسالة عدداً مما وصفتها بحالات انتهاك حقوق الإنسان في مصر، ومنها “الاعتقال التعسفي للنشطاء والصحفيين”، و”انعدام فرص المحاكمة العادلة”، و”التعذيب داخل السجون”، و”العدد المتزايد من الإعدامات والتشريعات المصممة لعرقلة عمل منظمات المجتمع المدني”.
وفي العام الماضي أيضاً سلمت 32 دولة، منها جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بياناً مشتركاً للأمم المتحدة عبرت فيه عن قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو الغرض نفسه من الرسالة المفتوحة هذا العام.
إذ جاء في رسالة السياسيين أنه “لا ينبغي أن يظل البيان المشترك (السابق) لشهر مارس/آذار 2021 بمثابة لفتة لمرة واحدة”، وأضاف السياسيون: “نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار فشل المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء هادف لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر”، بحسب تقرير لموقع دويتش فيله.
هذه التصريحات والرسائل المفتوحة المطالبة بممارسة ضغوط على القاهرة للتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة دون توقف طوال سنوات حكم السيسي، وكذلك صفقات الأسلحة الأوروبية لمصر خلال نفس الفترة. وتعتبر إيطاليا وفرنسا نموذجين آخرين، إضافة إلى ألمانيا بالطبع.
إيطاليا، التي وافقت على صفقة عسكرية مع مصر وصفتها مصادر حكومية بأنها مهمة القرن، تعتبر دراسة حالة في قضية حقوق الإنسان أم المصالح الاقتصادية. فالقصة هنا لا تتعلق بسجل حقوق الإنسان المصري التي يواجه نظام السيسي انتقادات حادة لانتهاكها، بل بقضية تعرض مواطن إيطالي هو جوليو ريجيني للتعذيب البشع والقتل بطريقة بشعة على أيدي قوات أمن مصرية، بحسب الرواية الإيطالية الرسمية، رغم محاولة القاهرة التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على مجرمين جنائيين.
ريجيني طالب إيطالي كان يعمل على إعداد رسالة دكتوراه عن النقابات العمالية المصرية المستقلة لتقديمها إلى جامعة كامبردج البريطانية، وكان في مصر يجري أبحاثاً خاصة بموضوع الرسالة، واختفى في مصر عشية الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 ثم عُثِر على جثته أوائل فبراير/شباط 2016 وبها آثار تعذيب بشعة.
وعلى مدار سنوات، شهدت القضية تطورات درامية بدأت بإنكار أجهزة الأمن المصرية معرفتها بمكان ريجيني في الفترة التي كان مختفياً فيها، ومواصلة نفس مسار الإنكار بعد العثور على جثته، بينما وجَّه الجانب الإيطالي الاتهام لأجهزة الأمن المصرية بتعذيب وقتل المواطن الإيطالي، وفي سبتمبر/أيلول 2016 أعلنت النيابة العامة المصرية أن ريجيني كان بالفعل خاضعاً لمراقبة أجهزة الأمن المصرية.
وأعلنت مصر وإيطاليا بدء تحقيق مشترك لكشف ملابسات تعذيب وقتل ريجيني بعد أن تسببت القضية في قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب روما سفيرها لدى القاهرة، وتركزت منذ البداية الرواية الإيطالية حول ارتكاب أفراد ينتمون لأجهزة الأمن المصرية وتحديداً الأمن الوطني والشرطة، في مقابل تمسك أجهزة التحقيق المصرية بأن المتهمين هم عصابة من 5 أفراد تخصصت في سرقة الأجانب وتم قتل أفراد العصابة في مواجهة أمنية.
لكن مقتل المواطن الإيطالي لم يمنع إبرام صفقة سلاح هي الأضخم في تاريخ البلدين، رغم شعور عائلة ريجيني “بالخيانة”، فالمصالح الاقتصادية وصفقات السلاح أهم من حقوق الإنسان، إيطالياً كان أو مصرياً. فالصفقة تتضمن فرقاطات ولانشات صواريخ، بالإضافة إلى مقاتلات يوروفايتر تايفون. وقالت صحيفة لا ريبوبليكا إن الصفقة الضخمة تتضمن فرقاطتين من طراز “فريم بيرجاميني” اللتين كانتا مخصصتين للبحرية الإيطالية، بالإضافة إلى 4 فرقاطات أخريات سيتم بناؤها خصوصاً لمصر.
وربما يكون تبرير وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي ماريو، في شهر فبراير/شباط 2020، للصفقة يلخص الموقف الأوروبي بشكل عام. كان لويغي في ذلك الوقت قد زعم أن الحكومة الإيطالية لم تتخذ قرارها النهائي بشأن الصفقة المصرية بعد، لكنه ألمح إلى موافقة الحكومة لقطع الطريق على الجانب الفرنسي المنافس، الذي لن يفوِّت الفرصة في حال عدم إتمام الصفقة مع مصر.
أما فرنسا نفسها فقد أصبحت خلال السنوات الماضية من أبرز الدول الأوروبية بيعاً للأسلحة وأنظمة المراقبة والتجسس للحكومة المصرية، رغم التصريحات المستمرة بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر. وربما تكون علاقة السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مثالاً صارخاً على ذلك التناقض بين القول والفعل فيما يخص حقوق الإنسان.
فالرئيس الفرنسي تعرَّض لانتقادات عنيفة من منظمات حقوقية عندما استقبل نظيره السيسي استقبالاً أسطورياً في ديسمبر/كانون الأول 2020، لكنه في مواجهة تلك الانتقادات أعلنها صريحة واضحة وقال إن “مصالح فرنسا الاقتصادية وعلاقاتها السياسية مع مصر لا يمكن أن تتأثر بملف حقوق الإنسان”، وهذه هي الخلاصة فيما يشبه الإجماع. قادة الدول الغربية لا يتوقفون عن إصدار “التصريحات” للدفاع عن حقوق الإنسان، بينما أفعالهم تقوم على إبرام الصفقات وتحقيق المصالح الاقتصادية!
* المصدر: المادة الصحفية نقلت حرفيا من موقع عربي بوست ولا تعبر عن راي الموقع