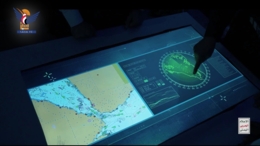السلام العالمي في ظل جائحة كورونا
السياسية:
مركز البحوث والمعلومات
خلال عامين سجل اليوم العالمي للسلام حضوراً مغايراً عن ما كان عليه خلال السنوات الماضية، حيث اعتبرت هذه المناسبة خلال ثلاثة عقود من الزمن “يوماً لتكريس وتعزيز قيم ومثل السلام ما بين الأمم والشعوب”، ومع تفشي فيروس كورونا خلال عامي 2020 و2021 دون اليوم العالمي للسلام تواجده في هذه الأزمة من خلال الـتأكيد على ضرورة وأهمية الحوار وتبادل الأفكار في هذه المحنة العالمية، من أجل المساعدة على التعافي بصورة أفضل من جائحة كوفيد-19.
وفي ما مضى اعتبر اليوم العالمي للسلام مناسبة لوقف إطلاق النار وعدم العنف على مستوى العالم من خلال التعليم والتوعية الجماهيرية والتعاون للتوصل إلى وقف إطلاق النار في مختلف الحروب والنزاعات، ويأتي الحديث عن أهمية السلام في هذا العام تماشياً مع المتغيرات التي شهدها العالم خلال المرحلة الماضية، ولا سيما مع بروز خطراً “غير مسبوق” والمتمثل في جائحة كوفيد-19 التي ضربت في كل اتجاه ولم تستثني أحد في أرجاء المعمورة.
هذه المساعي في تعزيز التعاون على المستوى الدولي لم تأتي من فراغ بل فرضتها الكثير من المستجدات ولا سيما الكارثة الصحية التي تعيشها البشرية اليوم، فمنذ بداية انتشار فيروس كورونا، لوحظ أن التعامل الدولي مع الأزمة اعتمد على الحلول الفردية من ناحية وعلى تبادل الاتهامات من الناحية الأخرى، ومع إعلان منظمة الصحة العالمية تحول انتشار فيروس كورونا إلى جائحة ووباء دولي في مارس 2020، كان من الواضح أن المواقف الدولية المعلنة لم تستطع التخلص من الخلافات القائمة في ما بينها، ولهذا كانت التصريحات تشير إلى أن المشكلة في الأساس تقع بدرجة رئيسية على عاتق الصين، ولم يخفي الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” خلال تصريحاته المختلفة عن توجيه الاتهام المباشر للصين وبأنها تتحمل عواقب انتشار الوباء على مستوى العالمي.
ولم يكن غريباً أن تلك التصريحات لم تكن تضع في الحسبان أن أمنها الصحي في خطر، وبالتالي لم يكن في تقدير أغلب الدول “لا سيما الغربية” في بداية الوباء أن يكون هناك تنسيق مع الصين، وهذا ما تبين من خلال التعامل المتباين ما بين الدول في ما يخص أمنها الصحي وانتشار وباء كورونا، حيث كانت التجربة في دول شرق آسيا تشير إلى أهمية رفع حالة الطوارئ والتأهب الطبي بما يتناسب مع الغموض الذي شكله الفيروس في البدايات، بمعنى أخر أن تلك الدول لم تتعامل مع الوباء القادم من الصين على اعتباره شأن صيني، ولكنها تعاملت معه على اعتباره تهديد لأمنها القومي بدرجة رئيسية.
وفي هذا السياق أشارت عدد من التقارير الصحية، أن مؤشر الأمن الصحي في تلك الدول (كوريا الجنوبية واليابان وتايون وسنغافوره) يكون في العادة عند أعلى مستوى، حالة طوارئ غير معلنة، لكونها اكثر عرضة لتفشي الاوبئة والأمراض(انفلونزا الطيور والسارس) بمعنى استمرار حالة التأهب تجاه مختلف الأمراض أياً كان مستوى خطورتها.
فيما كانت النظرة القاصرة تجاه انتشار الأوبئة ولا سيما وباء كورونا هو السائد في أغلب الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبقية الدول الغربية، والسبب حسب عدد من المختصين “أن مفهوم الأمن الصحي في تلك الدول يقتصر على الاهتمام بعوامل محددة فقط، وليس كمفهوم شامل للأمن الصحي والمتعلق بكفاءة أجهزة الدولة وتوفر القدرات المناسبة للتعامل مع انتشار الفيروس”.
اختلاف الدول في تعاملها تجاه أمنها الصحي الداخلي لم يكن الاستثناء في حالة التخبط الذي شهده العالم خلال الجائحة، حيث سجلت الجهود الجماعية في الحد من انتشار الوباء سقوط مدوياً وصراعا ملحوظا عندما تزايدت حالات القرصنة على معدات الحماية الطبية في المطارات والموانئ المختلفة، إضافة إلى المبالغة في طلب مزيد من المعدات الطبية وبما يفوق حاجيتها وهو ما انعكس على ارتفاع الاسعار ، وبالتالي تضرر العديد من الدول بشدة مع نقص الامدادات الطبية والذي ترافق مع تسجيل الوباء انفجار كبير في عدد الإصابات دون سابق إندار.
ولم يقف التخبط الدولي عند هذا الحد، ولكنه توسع من خلال تدشين السباق ما بين الدول الكبرى للوصول إلى إنتاج لقاح للقضاء على وباء كورونا، متناسين أن التخلص من الوباء أو الحد منه لن يكون سوى بجهود وتنسيق عالمي مشترك خاصة في ظل عولمة جعلت من الأمراض والأوبئة عابرة الحدود مهما كانت الاحترازات المتخذة من قبل الدولة.
هذا التخبط الذي عاشه العالم في الأشهر الأولى من الجائحة لم يستثني الأمم المتحدة ومنظمتها الرئيسية المعنية بالصحية والمتمثلة في “منظمة الصحة العالمية” في تعاملها مع أزمة الوباء، حيث أشارت التحركات أن المنظمة لم تكن على استعداد كافي للتصدي للجائحة، ولم يكن لها القدرة على تقديم المساعدات الطارئة للدول الأكثر تضررا من الوباء، ويرجع العديد من الخبراء في الأمم المتحدة أن ذلك القصور في عمل منظمة الصحة العالمية ليس ذاتياً، ولكنه مرتبط بدرجة رئيسية بعدم وجود تفويض دولي يسمح لها بالضغط على الدول للكشف عن مستوى انتشار الوباء فيها، أو الزام تلك الدول بتقديم مختلف البيانات المرتبطة بكيفية انتشار ومكافحة الفيروس.
ويضيف الخبراء، أن ذلك القصور في عمل المنظمة على أرض الواقع ارتبط “إلى حد كبير” بعدم امتلاك المنظمة الدولية للموارد الكافية والقدرات التقنية، أو خضوعها في كثير من الاحيان إلى الابتزاز السياسي من قبل بعض الدول، لا سيما الولايات المتحدة التي أعلنت في بداية الأزمة الصحية عن قطعها الدعم المالي المخصص للمنظمة الدولية، بعد اتهامها بالتحيز للصين، قبل أن تتراجع مع تولي “جو بايدن” وأدارته الحكم في البيت الأبيض.
هذا الواقع الصعب لم يمنع منظمة الصحة العالمية من العمل على تجاوز العوائق المالية والفنية في سبيل القيام بالدور المناط بها، وهذا ما كان عندما سارعت المنظمة إلى البحث عن مبادرة يمكن من خلالها توفير لقاح كوفيد-19 للدول الفقيرة، والبداية كانت في أبريل 2020 من خلال إطلاق مبادرة “كوفاكس” العالمية للوصول للقاحات كوفيد-19 من قبل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها كاستجابة طارئة لجائحة كورونا، ويشير القائمين على مبادرة “كوفاكس” إنها مبادرة طموحة تسعى إلى تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة الوباء وتوزيع حوالي ملياري جرعة وتمنيع (تطعيم) نحو 27% من مواطني البلدان ذات الدخل المنخفض خلال عام 2021.
وفي سياق الحديث عن أهمية مبادرة “كوفاكس”، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بقوله: “إن كوفاكس ليس مجهودا خيريا: في اقتصاد عالمي شديد الترابط، فإن اللقاحات الفعالة والمتاحة على نطاق واسع في جميع البلدان، هي أسرع طريقة لإنهاء الجائحة، وإطلاق الاقتصاد العالمي وضمان التعافي المستدام”، وحذر المسؤول الدولي من اكتناز اللقاح وعدم تقاسمه بقوله: “سيكون لدينا ثلاث مشكلات كبيرة: فشل أخلاقي كارثي، جائحة مستمرة، وسيكون تعافي الاقتصاد العالمي بطيئا”.
ولم يخفي “غيبرييسوس” خشيته من عدم الاستفادة من دروس التاريخ وقال: “أعتقد أن علينا أن نرجع بالنظر إلى التاريخ أثناء مرض نقص المناعة البشرية/الإيدز، كانت هناك عقاقير متاحة بعد سنوات من انتشار الوباء، ولكن عندما أتيح الدواء في الدول الغنية، لم يكن متاحا في الدول النامية التي وصلت الأدوية إليها بعد عقد تقريبا”.
وخلال المرحلة الماضية استطاعت منظمة الصحة العالمية من جمع نحو 2 مليار جرعة من اللقاحات الحالية والمرشحة للاستخدام مستقبلاً في جميع أنحاء العالم، ولكن تلك الجهود لم تتمكن من الايفاء بكامل التعهدات خاصة مع إعلان تحالف “كوفاكس” أنه من المرجح الحصول على حوالي 1.4 مليار جرعة لقاح بنهاية العام فقط من ملياري جرعة وفق التقديرات المعلنة سابقاً، والسبب في ذلك التراجع أن عدد من شركات التصنيع وبعض الدول منحت الأولوية لإبرام صفقات ثنائية.
التراجع عن ما تم الاتفاق بشأنه دفع منظمة الصحة العالمية إلى الطلب بعدم تلقي الأشخاص الذين تم تلقيحهم مسبقاً بجرعات معززة “الجرعة الثالثة” من اللقاح أو تجميدها حتى نهاية العام 2021، كي يتسنى إرسال اللقاحات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض المشاركة فى “كوفاكس”، وجاء في بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية وشركائها في المبادرة “أن انعدام المساواة في الوصول إلى اللقاح يبقى غير مقبول مع حصول 20% من سكان الدول ذات الدخل المحدود على الجرعة الأولى من اللقاح مقابل80% من سكان في الدول ذات الدخل المرتفع”.
ختاماً، خلال العقود الماضية اعتبرت الأمراض المعدية تحدياً مضافاً إلى جملة التحديات والمشاكل المتعددة العابرة للحدود، ويمكن القول إن الفكرة القائلة بأن للدولة قدرة على حماية نفسها من أي أوبئة خارج الحدود الوطنية ليست سوى فكرة خاطئة، وما حدث من تفشي للأوبئة “لا سيما وباء كورونا” على مستوى العالم يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك على خلل عميق في من يتبنى تلك الافكار لكون الأوبئة تعتبر تحديا للمفهوم التقليدي الذي يركز على محورية الدولة في تحليله للأزمات القائمة.
سبأ